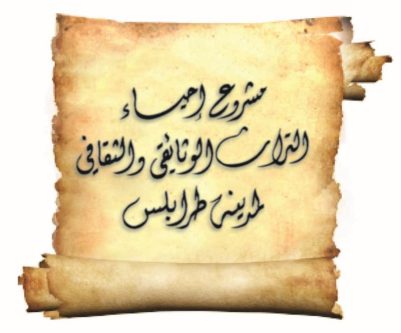مفكرون وعلماء عرب يوصون بإشراك الشباب في مشروع نشر مختارات التراث الإسلامي
في ندوة حول «الفكر النهضوي الإسلامي» بمكتبة الإسكندرية الدكتور عبدالغني عماد يطرح ضرورة احياء التراث وتجديده
مفكرون وعلماء عرب يوصون بإشراك الشباب في مشروع نشر مختارات التراث الإسلامي
في ندوة حول «الفكر النهضوي الإسلامي» بمكتبة الإسكندرية الدكتور عبدالغني عماد يطرح ضرورة احياء التراث وتجديده

جانب من الحضور للندوة («الشرق الأوسط»)

د. محمد عمارة أثناء إلقاء كلمته

د. عبد الغني عماد ود. هشام جعفر
الإسكندرية: داليا عاصم جريدة الشرق الاوسط بمشاركة عشرات الباحثين والمفكرين العرب استضافت مكتبة الإسكندرية الأسبوع الماضي ندوة «في الفكر النهضوي الإسلامي»، وفي الجلسة الختامية التي أدارها مجدي سعيد، تحدث الدكتور عصمت نصار، الباحث في الفلسفة الإسلامية والفكر العربي، ووكيل كلية الآداب بجامعة بني سويف، والدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، والرئيس السابق لمركز دراسات الشرق الأوسط، وشارك فيها نخبة من المفكرين والعلماء والمتخصصين من 15 دولة عربية وإسلامية.
وطرح المشاركون في الجلسة عدة ترشيحات لقائمة من الكتب لإعادة إصدارها ضمن مشروع مكتبة الإسكندرية؛ لإعادة نشر مختارات من التراث الإسلامي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين - التاسع عشر والعشرين الميلاديين. وحول إعادة نشر كتابات بعينها، قال الدكتور عصمت نصار «النصف الأول من القرن العشرين شهد العديد من الاتجاهات، العلماني، والليبرالي، والمحافظ المستنير، والتجديد، وكلها اتجاهات كانت لها مصداقية وقوة، إلا أن نكسة عام 1967 والتغيرات التي أعقبتها، أثرت على الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وأثرت على المراكز الفكرية والفلسفية في الشام والعراق، كل ذلك جعل العديد من الباحثين يعتقدون أن هناك ما يطلق عليه فصل الخطاب». وفي رأيه، فإن الوضع السابق أسهم في ظهور نظريتين لدى المثقفين، هما المؤامرة وجلد الذات، وهو ما أعاق التفكير بشكل جماعي، وانتقد نصار الباحثين الشباب الذين يعيدون تكرار ما كتب في التراث، واقترح أن يتم نشر الأعمال التراثية بشكل أقرب إلى المنحى الفلسفي منه إلى التاريخي، وأوصى بالاستعانة بجغرافيا الفكر والمنهج التحليلي والمقارن والبنيوي، حينما يتطلب الأمر ذلك. وتابع نصار «يجب رسم خريطة دقيقة للحقيقة التاريخية التي ندرسها؛ لتبين لنا مدى أصالة هذه الأفكار الموجودة في المصنَّف، وأبعادها التاريخية، والغوص في النقاط المهمة، والعوامل الأساسية التي شكلت عقل الباحث، والتمحص في مشروعه أو خطابه؛ لأن معظم الخطابات التنويرية كانت خطابات ومشروعات في آن واحد». ونوه نصار إلى أنه لم يكن هناك فصل بين النظر والعمل، في مصر، وتونس وبغداد وسورية، مضيفا «علينا تناول منهجية الباحث أو مشروعه، ثم نلخص ما وجد بين دفتي الكتاب، ونضع قائمة ببليوغرافية لأصحاب المصنف، وعلينا تأخير النقد؛ لأنه ينبغي أن نترك للقارئ متعة القراءة، ثم يأتي التعليق بعد ذلك». من ناحيته، طرح الدكتور عمار علي حسن عدة ملاحظات، تطرق فيها إلى وظائف البحث العلمي التي تتحدد في جمع المتفرق، واختصار المسهب، وتطوير المختصر، وتصنيف المبعثر، ونقد السائد، ثم إبداع الجديد، مشيرا إلى أن العديد من الأطروحات العلمية تدور في المقاصد الأولى فقط، والقليل منها يذهب إلى الإبداع الجديد. وأوصى بضرورة ألا تقتصر الكتابات على مجرد العرض، لكن لا بد أن تنتقل إلى نقد ما هو موجود، فيجب ألا يقتصر المشروع على تقديم الكتاب، بل إيجاد جسور للتفاعل بين ما هو مطروح في حياتنا، وأعتقد أنه بذلك يكون عملا مفيدا. وانتقد حسن عدم التفريق بين ما هو علم وما هو فكر، فالعلم له خصائص ويتسم بالنسبية والعقلانية، وبعيد كل البعد عن المطلق، ولمح إلى ضرورة اختيار لجنة تتحمل مسؤولية اختيار الكتب، وتحدد أهليتها للمشروع الكبير، على ألا تعمل اللجنة على تنميط الباحثين، وتناقش الكتب قبل كتابة مقدماتها، مشيرا إلى ضرورة فصل السياسة عن الدين، معتبرا أن دخول الآيديولوجيا على الدين من الأمور الخطيرة.
وأوضح حسن أن الكثيرين حولوا الدين إلى تطبيق، والبعض حوله إلى فلكلور وأساطير، وآخرون يتحدثون عن تحويله إلى تجارة أو آيديولوجيا. على الجانب الآخر قال هشام جعفر، رئيس تحرير شبكة «إسلام أون لاين» بالقاهرة: إن المشروع إذا كان يخاطب الشباب يجب أن يراعي وضع ملخصات لكتب التراث للاطلاع عليها، كما طالب بأن تخرج منتجات في شكل يصلح لتدريب الشباب على فكرة «التشبيك» بين العاملين في هذا الحقل. واقترح جعفر ضم كتب: «خصائص التصور الإسلامي» لسيد قطب، و«العدالة الاجتماعية»، و«الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ شلتوت. فيما أكد الدكتور عبد الغني عماد، أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، والمشرف على مركز إحياء التراث الوثائقي والثقافي في طرابلس ، أن الهدف من إحياء التراث يكمن فيما يسمى بعث الفكر النهضوي وإثارة النقاش حوله، مقترحا ضرورة إطلاق حلقات نقاشيةومؤتمرات تحاول التعرض للإشكالية الرئيسية، وهي تعثُّر المشروع النهضوي العربي الإسلامي، ولماذا يتراجع للخلف؟! وأوصى بضرورة تصنيف الكتب وفقا لعدد من المحاور: فلسفة، وتاريخ، وأدب، وأن تعقد جلسات لكل محور على حدة. وانتقد المشاركون عدم وجود المرجعية الإسلامية في ثقافة الشباب، لذا فمن المحتمل أن تكون هذه الكتب أكبر جدا من مستوى هؤلاء الشباب، وأوصوا بضرورة تحديد الشريحة المستهدفة من المشروع وإشراكها في منتجاته. وذهب المشاركون إلى أن كل الكتب تنتمي إلى الفكر النهضوي الذي بلور إجراءات ذات طابع جدلي، وتبني فكره التقدم، واقترحوا إشراك رجال الدين المتنورين في مشروعات إحياء التراث الإسلامي. وخلص المشاركون إلى ضرورة نشر البحوث والدوريات المتعلقة بهذه القضايا إلى جانب الكتب التراثية، وإلى جانب كتب محمد عبده والكواكبي، وإتاحة الفرصة لكتب لم تنشر وغير متاحة للباحثين، واتفقوا على أن المعايير الأساسية التي يؤخذ بها هي معايير الحرية والنزاهة والاختلاف، وضرورة تنوع المشروع الفكري، وتبني المراكز البحثية الكبيرة ودعمها للمشروع ومساعدة الباحثين. وطالب الباحثون بضرورة الاستفادة من أساليب العرض الحديثة، والاستفادة من وسائل الاتصال في تنمية وتطوير هذا المشروع الفكري، من خلال عقد مؤتمرات على الإنترنت، سواء مؤتمرات مرئية أو مكتوبة. إلى ذلك قال الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمشرف العام على المشروع، إن المكتبة قطعت شوطا في تنفيذ المشروع؛ حيث توشك على إصدار أول مجموعة من كتب هذا التراث المستهدفة إعادة نشرها والتعريف بها.
وبحسب سراج الدين، فإن فكرة المشروع نبعت من الرؤية التي تتبناها مكتبة الإسكندرية، بشأن ضرورة المحافظة على التراث الفكري والعلمي في مختلف مجالات المعرفة، والمساهمة في نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة، تأكيدا لأهمية التواصل بين أجيال الأمة عبر تاريخها الحضاري، مشيرا إلى أن تلك من أهم الوظائف التي تضطلع بها المكتبة منذ نشأتها الأولى، وعبر مراحل تطورها المختلفة.
ولمح إلى أن السبب الرئيسي لاختيار القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين، هو وجود انطباع سائد غير صحيح، يشير إلى أن الإسهامات الكبيرة التي قام بها المفكرون والعلماء المسلمون قد توقفت عند فترات تاريخية قديمة ولم تتجاوزها، في حين أن استعراض وثائق هذه المرحلة يدل على غير ذلك، ويؤكد على أن عطاء المفكرين المسلمين - وإن مر بمد وجزر - فإنه تواصل عبر الأحقاب الزمنية المختلفة، بما في ذلك الحقبة الحديثة، والتي تشمل القرنين الأخيرين، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، تضم مختارات من أهم الأعمال الفكرية لرواد الإصلاح والتجديد الإسلامي، خلال الفترة التي يشملها المشروع، إضافة إلى إتاحة هذه المختارات للشباب بصفة خاصة، وللأجيال الجديدة بصفة عامة، وتمكينهم من الاطلاع عليها ورقيا وإلكترونيا عبر الإنترنت.
ونوّه سراج الدين إلى أن مكتبة الإسكندرية تهدف من هذا المشروع أيضا، إلى الإسهام في تنقية صورة الإسلام من التشوهات التي تلصق به، وبيان زيف كثير من الاتهامات التي تنسب زورا إلى المسلمين، من خلال ترجمة هذه المختارات إلى الإنجليزية والفرنسية، ومن ثَم توزيعها على مراكز البحث والجامعات ومؤسسات صناعة الرأي في مختلف أنحاء العالم، وقبل ذلك إتاحتها لشباب المسلمين من غير الناطقين بالعربية.
يذكر أن ندوة «في الفكر النهضوي الإسلامي»، شارك فيها مفكرون وعلماء من 15 دولة عربية وإسلامية منها مصر، وتركيا، واليمن، والأردن، وسورية، ومالي، وتونس، وباكستان، والسعودية، وماليزيا، وقد انتهى فريق العمل في مشروع إعادة نشر مختارات من التراث الإسلامي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين من إعداد تقديمات لـ12 كتابا منها: «مقاصد الشريعة الإسلامية» لمؤلفه الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، و«دفاع عن الشريعة» لمؤلفه علال الفاسي، و«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» لمؤلفه عبد الرحمن الكواكبي، و«مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» لمؤلفه رفاعة رافع الطهطاوي، و«امرأتنا في الشريعة والمجتمع» لمؤلفه الطاهر الحداد.
******************************
الدكتور عبد الغني عماد في زيارة و لقاء حواري مع اسلام اون لاين
كذلك لبى الدكتور عبد الغني عماد دعوة شبكة اسلام اون لاين فزار الموقع الرئيسى للشبكة في مدينة 6 اكتوبر حيث كانت له جولة في اقسام الشبكة ثم شارك في لقاء حواري مع موقع اسلاميون التابع للشبكة حول تطور الحركة الاسلامية في لبنان وقد نشرت الشبكة على موقعها مقتطفات من الحوار
الصالون الثقافي لموقع الإسلاميون يناقش خصوصيات الحركة الإسلامية السنية في لبنان
عبد الغني عماد:
الحركة الإسلامية السنية فشلت في إنتاج خطاب يعكس خصوصية الواقع اللبناني
خديجة الزغيمي
د. عبد الغني عماد
للحركة الإسلامية السنية في لبنان خصوصيات تميزها عن غيرها من الحركات الإسلامية في العالم العربي، وتتعلق هذه الخصوصيات بالواقع اللبناني المختلف الذي يحفل بكثير من التنوع والتعقيد. هذه الخصوصيات كانت موضوع الصالون الثقافي الذي نظمه موقع "إسلاميون.نت"، واستضاف فيه د. عبد الغني عماد، المفكر اللبناني، والخبير في شئون الحركات الإسلامية، الذي تحدث عن تاريخ نشأة الحركة الإسلامية السنية في لبنان، والعوامل التي أثرت على مسار وتطور هذه الحركة،. أدار الندوة حسام تمام رئيس التحرير التنفيذي لموقع الإسلاميون وشارك بها هشام جعفر رئيس تحرير موقع إسلام أون لاين وعادل القاضي نائب رئيس التحرير وعدد من محرري المواقع التابعة لشبكة إسلام أون لاين.
أول العوامل التي تحدث عنها د. عبد الغني هي طبيعة البيئة التي نشأت فيها الحركات الإسلامية في لبنان، والتي تتميز سياسيا واجتماعيا بالتنوع والتعقيد الكبيرين، كما أن البيئة السياسية والديموغرافية في لبنان ليست سهلة أو مؤهلة لعمل الحركات الإسلامية؛ إذ إن التركيبة السكانية بها تنوع طائفي ومذهبي لا مثيل له في العالم العربي؛ حيث توجد في لبنان 18 طائفة يمثل المسلمون سنة وشيعة الأغلبية بحدود 67%، ويتساوى تقريبا السنة والشيعة من حيث العدد.
تأخرت الحركات الإسلامية في الظهور في لبنان، وعندما ظهرت لم تعبر عن الهاجس الذي كان يقض مضاجع المسلمين في لبنان، وهو الغبن الذي شعروا أنه وقع عليهم بتطبيق نظام المارونية السياسية الذي أنشأه الاستعمار الفرنسي قبل رحيله؛ إذ إن هذه الحركات كانت مشغولة بهَمِّ سقوط الخلافة والسعي لاستعادتها؛ حيث كان هذا هو هم الحركة الإسلامي في العالم العربي بأسره، وبالتالي لم تنجح الحركة الإسلامية اللبنانية في تحريك الشارع والاندماج به، وإنما من نجح في ذلك هم الزعماء التقليديون.
فبينما كانت الحركات الإسلامية عديمة الخبرة، وجديدة في ميدان العمل السياسي، قام هؤلاء الزعماء التقليديون بالتواصل مع الشارع، وبعضهم أنشأ مؤسسات -أغلبها تربوية- أسهمت في كسر الاحتكار المسيحي للتعليم قبل أن تبدأ الدولة في التعليم شبه المجاني، ومن أبرز تلك المؤسسات دار التربية والتعليم بطرابلس ومؤسسة المقاصد ببيروت، وكانت هذه المؤسسات والجمعيات تقوم بتحريك الشارع.
الجماعة الإسلامية
وتحدث د. عبد الغني عن أول حركة إسلامية تأسست كجماعة منظمة وهي الجماعة الإسلامية في لبنان، وهي تمثل الوجه اللبناني للإخوان، والذي تأخر في التبلور؛ حيث كانت تعرف في البداية بجماعة عباد الرحمن، ولم تكن تمثل الوجه الرسمي النظامي للإخوان، لكنها كانت متأثرة كثيرًا عبر مؤسسها بفكرة الإخوان المسلمين،
وتأثرت الحركة الإسلامية في لبنان كثيرًا، كما ذكر د. عبد الغني عماد بالسوسيولوجية السياسية اللبنانية؛ حيث يعيش المسلم منذ مولده في حالة احتكاك دائم مع كل الطوائف الأخرى، ويؤدي هذا إلى ذهنية مرنة تتقبل الآخر، وتعترف به، خاصة في المجالات المختلطة، إلا أنه عندما تتقطع الأوصال، وتنعدم المجالات المختلطة التي تتيح التفاعل بين المكونات السوسيولوجية للمجتمع تنمو حالة من الفكر الانعزالي لدى كل الطوائف وتكبر الهواجس، وهذا ما حدث أثناء الحرب، فالطائفية كانت موجودة قبل الحرب، ولكن على مستوى القيادات فقط، ولكن الحرب نقلتها إلى الشارع.
هذا التنوع الطائفي كان يفترض كما يرى د. عبد الغني أن يؤدي بالخطاب الإسلامي في لبنان إلى إنتاج رؤية إسلامية تعكس هذه الذهنية المرنة في مجتمع متنوع، وأن يكون سباقا لتقديم تجربة إسلامية تعكس فعلا ما يجري في مجتمع يتسم بالانفتاح وانتشار الحريات، وهذا ما افتقدت إليه معظم الحركات الإسلامية في العالم العربي التي نشأت في غياب الحريات، إلا أن إسلاميي لبنان -كما يقول د. عبد الغني- قصروا في إنتاج مثل هذا الخطاب، وفي إنشاء مؤسسة إسلامية تعكس طبيعة المجتمع اللبناني، وتصرفوا كأنهم في مجتمع لا يتميز بهذه الخصوصيات، وبنوا مؤسساتهم كأنهم في مجتمع ذي أغلبية إسلامية.
وأرجع د. عبد الغني سبب هذا في جزء منه إلى طبيعة تأسيس أول مؤسسة إسلامية حركية في لبنان؛ حيث نشأت في طرابلس التي تشبه مدن العالم العربي فـ 85% من سكانها مسلمون، وبقيت الجماعة كإطار تنظيمي في طرابلس، ولم تأت قياداتها من مشارب وتكوين وتربية اجتماعية متنوعة، وإنما كانت غالبية هذه القيادات من مناطق ريفية أو من طرابلس، ولم تأت من مناطق مختلطة، وبالتالي لم يكن هناك استيعاب لضرورة إنتاج تجربة متميزة تنسجم مع طبيعة لبنان ودوره في المنطقة.

جانب من حضور الندوة
الحرب الأهلية والثورة الإيرانية
وعرج د. عبد الغني على تأثير انفجار الحرب الأهلية اللبنانية وقيام الثورة الإسلامية الإيرانية اللذين أديا إلى تهميش الحركة الإسلامية السنية في لبنان، فالحرب الأهلية أدخلت الحركة الإسلامية في صراع عسكري دون أن يكون لها دعم من دولة خارجية، والمقاومة الفلسطينية التي قادت الصراع بداية ضد إسرائيل، ثم انخرطت في الصراع الداخلي اعتمدت على حلفاء من اليسار اللبناني واستبعدت الإسلاميين، في حين أعادت الثورة الإيرانية الروح للشيعة في لبنان الذين كان دورهم مهمشا قبل مجيء الصدر، ثم قيام الثورة الإيرانية التي دخل الشيعة بعدها بقوة على الساحة السياسية.
ثم جاءت المرحلة السورية التي لم تكن مواتية للحركات الإسلامية السنية في لبنان، بل كانت مرحلة صعبة عليهم تخللتها ايام سوداء
وفي عهد رفيق الحريري ومع شيء من الاستقرار السياسي لجأت للحراك السياسي من خلال الانخراط العام الانتخابي التي قررت الجماعة الإسلامية والجماعات المشابهة الانخراط به، أو من خلال الانخراط في مقاومة إسرائيل في الحالة الشيعية، إلا أن السنة وجدوا في رفيق الحريري، معبراً عن قضيتهم في حين لم يكن لدى الحركة الإسلامية كما يقول د. عبد الغني خطاب لمعالجة الإشكالية مع السوريين، وإنما لجأت للصدام، ثم انكفأت ولجأت للمساومة والتأييد وتدجن القسم الغالب منها، وهكذا نجد مرة أخرى أن الحركة الإسلامية لم تواكب حراك الشارع السني، وكل حركة لا تواكب تطلعات المجتمع الذي تعبر عنه تفقد فاعليتها.
الإسلامية السنية فشلت في إنتاج خطاب يعكس خصوصية الواقع اللبناني
يذهب د. عبد الغني إلى أن الحركة الإسلامية السنية في لبنان يتيمة نتيجة لافتقادها لرافعة خارجية، ولم تتمكن أي حركة سياسية في لبنان من الانتصار إلا بوجود دولة خارجية تحتضنها.
كما لا يوجد للإسلاميين السنة تعبير سياسي، ولا برنامج ولا رؤية سياسية موحدة، ولو استطاعوا الخروج بتعبير سياسي ورؤية سياسية ومشروع لبناني موحد، ولو تمكنوا من لبننة حركتهم سيكون لدينا لاعب سياسي ناشط وصاعد، إلا أنه لا توجد عوامل موضوعية تجعل هذا ممكنا في المدى المنظور.
وردا على تساؤل حول لماذا لم يتمكن الإسلاميون السنة من تزعم الشارع السني، بينما نجح في ذلك الإسلاميون الشيعة أجاب د. عبد الغني بأن الحركة الإسلامية السنية تعرضت للقمع والاضطهاد، وبالتالي لم يتمكن قادتها من تزعم الشارع ومنافسة الزعماء التقليديين.
كما لفت د. عبد الغني إلى أن الإسلامية اللبنانية متميزة فهي في صميمها عروبية، وبها خليط من مثلث العروبة والإسلام والانفتاح على الآخر، ولا تتقبل كثيرا الاتجاه العنيف المتطرف وايضا تستسيغ الطرح الطائفي المتعصب وتميل الى الاعتدال والوسطية بشكل عام ، وبرغم وجود بضع منظمات عنيفة فإنها لا تمثل التيار الإسلامي العريض؛ لأنه لا يوجد مبرر للعنف فبإمكان الإسلاميين الحركة والعمل بشكل علني.
وعن الوجود السلفي الصاعد في لبنان قال د. عبد الغني إن النمو السلفي في طرابلس وصل إلى ذروته، وهناك تضخيم اعلامي على هذا الموضوع ، وهذا التيار ليس لديه إمكانيات أكثر مما وصل إليه بالفعل، وبالتالي فإن السلفية بالمفهوم الذي تقدمه الجمعيات الناشطة في لبنان غير قابلة للانتقال لحالة حركية تنظيمية فاعلة على المستوى السياسي؛ حيث أثبت هؤلاء حتى الآن فشلهم في إنتاج خطاب يمثل رؤية سياسية لبنانية، وذلك بسبب تشظي الحركة السلفية في لبنان، وانتشارها غير المتوازن؛ حيث تنحصر في قطاع جغرافي ضيق أغلبه في طرابلس والشمال، وكذلك ضعف التسييس؛ حيث لا توجد قراءة للواقع السياسي، وإنما انغماس كلي في الحالة الدعوية التي تنتج حالة من الإيمان والفكر التقوي يتمركز حول مجموعة من المدارس والمساجد، ولكنها لا تحرك الناس؛ لأنها لا تتفاعل مع القضايا والتحديات التي ينتجها الشارع اللبناني بشكل مستمر.