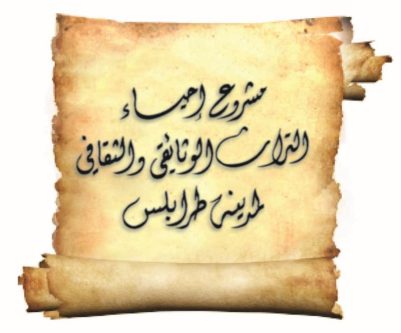| فهرس المقال |
|---|
| مذكرة أوغست أندريا |
مشروع إحياء التراث الوثائقي والثقافي
لمدينة طرابلس
لا يمكن قراءة التاريخ عموماً دون الرجوع الى الوثائق التي هي بمثابة الشواهد على أحداثه ومساراته ومحطاته. ولا يمكن بالتالي تصور تاريخ البشرية من دون مثل هذه الوثائق والمستندات.
ولقد تركت لنا العصور المتعاقبة أثاراً مكتوبة ومخطوطات مختلفة الأهمية ومتنوعة الشكل، وبالطبع متفاوتة المصداقية، غير ان المهم منها، والذي درج على تسميته بـ "الوثائق" بقي المرجع الأكثر ركوناً إليه من قبل المؤرخين والدارسين والباحثين.
وإذا كان البعض يعتبر "الوثيقة" مرآة للتاريخ، والبعض الآخر يرى فيها نبض حركة الجماعة أو الفرد في حقبة غابرة، فإن افتقارنا إلى وثائق كافية عن مراحل معينة من تاريخ مجتمعاتنا ضاعف من أهمية الوثائق النادرة والمتوفرة، أو التي لا يزال يعثر عليها بين الحين والآخر. وفي هذا السياق أنشئت المراكز والمعاهد المتخصصة، وشكلت فرق البحث والخبراء للتحقيق والعناية بهذه الكنوز المعرفية، وكان هذا الاهتمام سمة من سمات عصرنا الراهن، لا سيما بعد ظهور الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة المتخصصة، ومنها تحديداً تلك المعنية بمجتمع المعلومات، وبالحفاظ على التراث الإنساني.
ولا جدال في أن تطور تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات أكسبت الوثائق التاريخية قيمة جديدة، فهي بقيت تمثل ما يمكن اعتباره "النوع المعلوماتي الأصيل" مقابل "الكم المعلوماتي المتواتر" الذي يصعب التحقق منه بسبب سرعة انتشاره إلى درجة يصبح معها أحياناً من المسلمات المعرفية. لذلك فأن عالم التراث الوثائقي تتمتع به عادةً قلة من الباحثين والمعنيين بصون التراث وحفظه لكي يكون أداة حاسمة تجلو صورة الماضي، في قضايا قد تكون محط خلاف ونزاع في الحاضر، وربما في المستقبل.
- مشروع إحياء التراث الوثائقي والثقافي لمدينة طرابلس:
لا شك أن طرابلس مدينة عريقة بتاريخها وآثارها التي لا تزال، رغم كل ما أصابها من إهمال وتخريب، ناطقة ومعبرة عن دور حضاري فاعل لعبته على مدى أجيال وحقب تاريخية مديدة. فطرابلس تشكل منجماً غنياً من الناحية الوثائقية والأثرية والتاريخية، فيه من الحضارة والعراقة ما يحفزّ أقلام الباحثين إلى المزيد من البحث والتدقيق لكشف هذه الكنوز الوثائقية المبعثرة هنا وهناك.
وكم عانى الباحثون من أبناء طرابلس، ومن العلماء الذين أحبوا طرابلس من بلدان شتى عربية وأجنبية، كم عانى هؤلاء من مشقة البحث عن المراجع والمصادر الأصلية الخاصة بطرابلس، هذه الوثائق المبعثرة في عواصم شتى، بين استامبول والقاهرة، إلى باريس ولندن، بل حتى في قلب المدينة، هي أيضاً مبعثرة في مواقع شتى، وإن وجدت فهي تفتقر إلى الحد الأدنى من التوثيق والفهرسة والأرشفة الدقيقة والصحيحة، الأمر الذي يعرقل ويحدّ من إطلاق الدراسات الجادة حول تاريخ طرابلس ودورها الحضاري بشكل واسع.
لهذه الأسباب تلاقت جهود المركز الثقافي للحوار والدراسات مع الدور الطليعي الذي تقوم به جمعية العزم والسعادة الاجتماعية على المستوى التنموي في مدينة طرابلس لإطلاق مشروع إحياء الإرث الوثائقي.
- الأهداف العامة للمشروع:
جمع الوثائق الطرابلسية، وتحريرها وفهرستها، وتصنيفها بعد أرشفتها، ووضعها بتصرف الباحثين الشباب وتنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات بحث علمية حول تاريخ طرابلس الحديث على أساسها. ومن ثم نشر هذه الوثائق والدراسات لكي تكون مرجعاً بتصرف مراكز الأبحاث والباحثين في العالمين العربي والإسلامي من خلال طبعها بشكل يليق بتاريخ المدينة، وحفظها على أقراص مدمجة لتسهيل التعامل معها وفق أحدث الطرق المعلوماتية وبما يحفظها من التلف والضياع.
إن مشروع إحياء الإرث الوثائقي يتطلع إلى إنشاء مركز يحفظ ذاكرة طرابلس الثقافية والحضارية وهو يستهدف في خطته كمرحلة أولى:
- فهرسة وتبويب سجلات المحكمة الشرعية والتي تتضمن آلاف الوثائق والتي تبدأ منذ العام 1666م. وهي لا تزال كمخطوطات "مادة خام" في غالبيتها لم تتعرض للدراسة والفهرسة والتبويب، الأمر الذي يجعل من استفادة الباحثين فيها أمراً صعب المنال.
- تجميع وأرشفة وفهرسة الوثائق الخاصة بطرابلس والموجودة في مركز الوثائق والمحفوظات في اسطمبول، وهي وثائق على درجة عالية من الأهمية، نظراً لما توفره من معلومات حول تاريخ المدينة الاقتصادي والسياسي والإداري.
- جمع وترجمة مراسلات القناصل الفرنسيين والانكليز وغيرهم الذين كانوا في طرابلس والموجودة في بعض العواصم الأوروبية.
- العمل على جمع الوثائق والمحفوظات الموجودة في بيوت العائلات الطرابلسية ومكتبات أبنائها والمتعلقة بما تركه علماء طرابلس من آثار ومخطوطات وكتابات، وتحقيقها ونشرها، وهي كثيرة ولا تزال حبيسة هذه البيوت نظراً لعدم توفر الثقة عند هذه العائلات من جهة، وعدم وجود المؤسسات الأكاديمية والمهنية المختصة لتحقيقها والحفاظ عليها.
- نشر المخطوطات أو المطبوعات النادرة لعلماء وأدباء ومؤلفي طرابلس والتي لم تعد متوافرة للباحثين وأصبحت بالتالي كإرث ثقافي عرضة للنسيان والضياع.
- طباعة ونشر الدراسات الجامعية وأطروحات الدكتوراه التي تتعلق بتاريخ طرابلس وواقعها الراهن والتي تتمتع بالمواصفات العلمية والأكاديمية وتتفق بالتالي مع أهداف المركز.
- إنشاء مكتبة عامة متخصصة تتضمن كل ما كتب عن طرابلس، ومتابعة ما يكتب عنها من أبحاث ودراسات تتعلق بتاريخها وواقعها الراهن، بحيث تصبح هذه المكتبة مقصداً لكل الباحثين الذين يهدرون الكثير من أوقاتهم بحثاً عن المصادر والمراجع المبعثرة. هذا إن وجدوها.
- ترجمة الكتب الهامة التي ألفها الرحالة والباحثون الأجانب عن طرابلس ونشرها لكي تكون بتصرف الباحثين والطلاب.
- إصدار مجلة دورية تتضمن دراسات موثقة ومتنوعة تتضمن محاور تتناول مواضيع جديدة حول مدينة طرابلس من حيث التاريخ والعادات والدور الحضاري، والواقع الحالي في جانبه التنموي والثقافي والاجتماعي. وهي مجلة نتطلع لكي تكون إضافة نوعية تعتمد كمرجع أكاديمي في مجالها، لذلك سوف تكون مجلة محكّمة يشرف عليها نخبة من المتخصصين والأكاديميين.
إننا في المركز الثقافي للحوار والدراسات إذ نطلق مشروع إحياء التراث الوثائقي والثقافي لمدينة طرابلس فإننا نستهدف من هذا المشروع حفظ تراث المدينة الثقافي وصيانة ذاكرتها المدينية، وتجميع مخطوطات أبنائها وإنتاجهم الفكري والعلمي على مدى الأجيال، وحفظ وثائق المدينة وتراثها الغني، وإعادة الاعتبار إليه من خلال أرشفته وتحقيقه وفهرسته، ووضعه بتصرف أبنائها والباحثين من العالمين العربي والإسلامي فضلاً عن الباحثين والعلماء الغربيين، وذلك في مركز ثقافي حديث وكبير يليق بمدينة طرابلس التي كانت يوماً دار العلم والعلماء والتي نتطلع بشوق إلى إحياء دورها هذا من جديد.
- إنطلاق المرحلة الأولى من المشروع:
إننا والحمد لله، وفي سبيل هذا الهدف الحضاري، وفقنا وبالتعاون مع جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، في إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بتاريخ 1/7/2008 والتي تستهدف العمل على فهرسة وتبويب سجلات محكمة طرابلس الشرعية والتي تغطي وثائقها قسماً من القرن السابع عشر فضلاً عن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتحتوي على آلاف الوثائق الهامة والتي تعتبر سجلا يوميا لحياة الطرابلسيين في تلك المراحل، وهو العمل الذي سوف يترافق مع سلسلة من الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية حول هذه الوثائق يشارك فيها نخبة من الباحثين المختصين.
- لماذا هذه الوثائق وما أهميتها؟
يتضمن أرشيف المحكمة الشرعية في طرابلس العائد للمراحل العثمانية مئة وأربع سجلات تحمل الأرقام من 1 إلى 119 بالإضافة إلى سجلين غير مرقمين. وقد فقد بعض هذه السجلات ولم يتبقَ سوى 104 سجلات، وذلك بسبب الحريق الذي تعرضت له السرايا ودار المحكمة في طرابلس سنة 1976. ويومها تداعت بعض شخصيات المدينة لإنقاذ ما أمكن من هذه الوثائق التي حفظت أكثر من ثلاثة قرون، وكادت يد العبث ان تذهب بها في يوم مجنون من أيام الحرب عام 1976. وبمبادرة من الحاج فضل المقدم رحمه الله تشكلت رابطة لإحياء الإرث الفكري في المدينة عام 1982 أخذت على عاتقها بث الدعوة للحفاظ على هذه الوثائق، وتم حينها تصوير هذه الوثائق، فوضعت نسخة منها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ونسخة ثانية في معهد العلوم الإجتماعية وثالثة في مركز رابطة إحياء التراث الفكري في طرابلس بإنتظار أن يتم تبويبها وفهرستها نظراً لما تتضمنه من ثروة علمية وتاريخية لا غنى عنها للباحثين في تاريخ المدينة.
ومنذ ذلك الحين، وعدا المحاولات الفردية الجادة للإستفادة من هذه الوثائق والتي كانت تصطدم دائماً بغياب الفهرسة والتبويب اللازمين لتسهيل مهمة الباحثين، لم يتم القيام بأي محاولة مؤسساتية أو أكاديمية مدروسة لتنظيم وفهرسة وتبويب هذه الوثائق التاريخية التي لا تزال تشكل مادة أولية كمخطوطات تتضمن ثروة من المعلومات حول طرابلس بكل معنى الكلمة.
- ما أهمية هذه الوثائق؟
يعود أقدم ما بقي من سجلات محكمة طرابلس الشرعية إلى العام 1077 هـ/1666 م، وكانت طرابلس في ذلك الوقت لا تزال مركزاً لولاية قبل أن تصبح في القرن الثامن عشر تابعة لولاية دمشق ولولاية عكا في فترة من فترات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر.
والمخطوطات التي تتضمنها السجلات، متفاوتة في عدد صفحاتها وإن كان الأغلب يدور حول الـ 300 صفحة، وهي كتبت بالمداد الأسود، وبخطوط مختلفة، أكثرها جميل ومقروء، ومتنوع بين الخط الرقعي، والديواني، والنسخي، والثلث.
تتضمن المخطوطات والوثائق مواضيع شتّى جرى تسجيلها حسب ورودها إلى قلم المحكمة حينها دون أي تصنيف يتعلّق بموضوعاتها فهي متداخلة وغير مبوبة، وبالتالي يجد القارئ لهذه المخطوطات وثائق تتعلق بالنواحي الإقتصادية والتجارية، والأسواق، والمهن، والحرف، ومستوى المعيشة، كما يجد مخطوطات لها علاقة بالعادات والتقاليد والحياة اليومية للطرابلسيين، وبالعلاقات بين سكان المدينة وأوضاع المسيحيين واليهود إجتماعياً وإقتصادياً وقانونياً، وعلاقة الأهالي بالتجار الأجانب، وكل ما يتعلق بالأوقاف، والحياة العائلية من طلاق وزواج وإرث، إلى مسائل التعيينات والوظائف الدينية والإدارية والعسكرية، والعائلات، ومشايخ الطرق الصوفية، وعلاقة طرابلس بمحيطها الريفي وتطور هذه العلاقة...الخ
لا شك أن هذه المعلومات تفتح مجالات جديدة للباحثين والطلاب لإعادة قراءة التاريخ الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، وتفتح المجال لدراسات متفرعة عن هذه المواضيع مثل: الإدارة-الألقاب، الأسماء-الثقافة-الوظائف-الأشراف-تراجم الإعلام...
لقد بدأ الإهتمام بالوثائق والمخطوطات الموجودة في المحاكم الشرعية في دمشق وحلب والقاهرة وعمان منذ زمن، ونظمت العديد من المؤتمرات في سبيل الإستفادة منها، وما تمتلكه طرابلس من مخطوطات ومن ثروة في هذا المجال يضاهي ما هو موجود في تلك العواصم.
إن الباحث يقف فعلاً مذهولاً أمام جبل المعلومات والمعطيات المتضمنة في هذه المخطوطات التي تنتمي إلى الماضي الذي هو ماضينا، وبالتالي فإن معرفة الماضي التاريخي بشكل موضوعي تقود إلى فهم الحاضر، كما تنير آفاق المستقبل. لكن الماضي أو التاريخ ليس الأحداث الكبرى، بل الحياة اليومية المتواصلة عبر الزمن، والمتبدلة عبر التراكمات والمؤثرات المتداخلة، بل والمنقطعة عبر الإنعطافات الحاسمة. والإطلالة على كل ذلك ليست مهمة سهلة، فمهمة المؤرخ الإجتماعي والباحث الإجتماعي تتعدى وصف الأحداث إلى إستخراج تسلسلها المنطقي، وإعادة إنشاء صورة الماضي بأبعادها المتنوعة، وتحديد درجات حضور هذا الماضي في حاضرنا. وهذه مهمة تستدعي الجهد النقدي المُدقّق فضلاً عن التأريخي المُحقّق. إن هذه المخطوطات إلى جانب غيرها من التواريخ والمخطوطات الأهلية والوثائق الدبلوماسية وكتب الرحالة والرحلات المبعثرة هنا وهناك، يمكنها جميعاً أن تصحح نظرتنا إلى الماضي والحاضر بأبعاده المختلفة.
ولا يمكن أن نفعل شيئاً إذا ما بقيت هذه المخطوطات كماً متراكماً لا حياة فيها، لذلك كان هذا المشروع البداية والمنطلق لإحياء التراث الوثائقي والثقافي في المدينة. والذي أردنا من خلالة إتمام الفهرسة والتبويب وفق أحدث التقنيات وبإشراف فريق عمل أكاديمي متخصص ومدرب لكي تصبح المادة التاريخية المتضمنة في هذه المخطوطات بتصرف الباحثين والطلاب في طرابلس والعالم العربي والإسلامي، والتي سوف تعرض نتائجها تباعاً عبر حلقات نقاشية وندوات علمية ومؤتمرات متخصصة ومطبوعات متنوعة.
إن جهوداً كثيرة بذلت، وهي بلا شك مقدرة ومشكورة، للحفاظ على الإرث الثقافي في مظاهره الخارجية، كالأبنية التاريخية والمباني الأثرية الهامة، كالمساجد والكنائس والأسواق والخانات والحمامات والقلاع وغيرها، وهي على أهميتها وضرورة إستمراريتها وتطويرها، إلاّ أنها لا يجب أن تنسينا أن التراث الثقافي لا يختزل بمظاهره خارجية فقط، بل من حق هذا التراث علينا، أن نخرج كنوزه المدفونة ومخطوطاته المبعثرة، وأن نقوم بتحقيقها وجمعها وتبويبها وفهرستها وتقديمها في صورة علمية تليق بالفيحاء، وبما يجعل المباني الأثرية تتكامل مع المعاني الثقافية، والمظاهر الخارجية ناطقة بالمضامين الوثائقية والفكرية، فيحتضن الحجر ما أنتجه البشر من فكر وثقافة وأنماط حياة. هكذا تتكامل المباني والمعاني، والمظاهر والجواهر، وهذا هو البعد الحضاري لمشروع إحياء الإرث الوثائقي والثقافي لمدينة طرابلس.
إن انطلاق المرحلة الأولى يعني أنه لا يزال أمامنا مراحل أخرى تنتظر المزيد من الجهد والعمل، إلاّ أن إنطلاق هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع جمعية العزم والسعادة الإجتماعية يشكل حافزاً قوياً لنا الى المزيد من العمل والتعاون مع مثقفي طرابلس وفعالياتها وعائلاتها لانجاح هذا المشروع الحضاري الذي يحفظ تراث طرابلس الثقافي والوثائقي، فالمدن التي لا تحافظ على تاريخها وتراثها لا تستطيع أن تبني حاضرها ومستقبلها بجدارة.
المشرف على المشروع
ورئيس المركز الثقافي للحوار والدراسات
الدكتور عبد الغني عماد
باشوية طرابلس
في
مذكرة أوغست أندريا( )
ترجمة عبد اللطيف كرّيم
طرابلس أواخر أياّر 1812
تصل حدود باشاوية طرابلس حاليا حتى السويدية ، وسيليسيا القديمة شمالا، أي نهاية حدود اللاذقية ، ويحدها من الجنوب نهر الكلب أو ليكوس Lycus ، والبحر غربا على طول أراضيها، أما من الشرق فتحدها سلسلة جبال مرتفعة تفصلها عن وادي العاصي الضيق ومنها سلسلة جبال لبنان التي تبدأ من مسافة خمسة إلى ست ساعات شمال طرابلس وتنتهي عند وادي نهر الكلب .
باشا هذه البلاد برتبة ميرميران عادة أي باشا بطوخين( ) ، وكان من مهماته قبل قيام الوهّابيين بثورتهم وقطعهم طريق الحج أن يلاقي الجردة أي قافلة الحجيج عند عودتها إلى دمشق في البرج العشرين أي برج (كلمة غير مقروءة) الواقع في منتصف الطريق بين دمشق ومكة .
وعندما يلتقي باشا طرابلس بأمير الحاج فعليه أن يترجل ويسير في ركابه إلى أن يعفيه الأمير من ذلك بأن يدعوه للركوب ثلاثا . منذ بضع سنوات تمكن باشوات دمشق من الحصول على متسلمية طرابلس ولكن معظمهم لم يعرفوا المدينة ولم تعرفهم ولم يستطيعوا زيارتها بل قنعوا بسلطة أسمية هشة عليها . ولم يتحقق لهم حتى اليوم القضاءعلى روح التمرد التي واجهت خليل باشا والتي لا تزال مسيطرة على بعض النواحي التي أنحسرت عنها سلطة الباب العالي إنحسارا تاما .
إن نظرة سريعة إلى هذه الأحداث قد تسترعي إهتمامكم ، لا سيما وأن الراية الفرنسية ظلت فيها دائما خفاقة عزيزة رغم كل الحروب والأهوال .
بعد وفاة حسين باشا مسموما بأمر من الجزار باشا عيّن الباب العالي خليل باشا خليفة له وهو من آل العظم الأسرة المعروفة ، وكان خليل رجلا ضعيفا ، فأستغلت حاشيته نفوذها عليه لأرتكاب كل الموبقات، ولما ضاقت المدينة ذرعا بتلك الممارسات أعلنت العصيان وطلبت من الباشا مغادرة المدينة أو تسليم الجناة للأقتصاص منهم فطلب الباشا مهلة ثلاثة أيام ولكن المدينة لم تمنحه سوى يومين . ومر اليومان دون أن يتمكن الباشا من إتخاذ أي قرارفتسلل من المدينة إلى الميناء ومن هناك راح يهدد بأستعادة سلطته بالقوة .
لم يكن في نية الأهالي الخروج على سلطة الباب العالي بل كانوا يريدون إنزال العقاب بالظلمة الذين نكلوا بالمدينة وألحقوا بأهلها العار إذ استباحوا أعراض النساء ولم يوفروا العذارى وكانوا يعتبرون الباشا مسؤولا عن كل خروج على حكم الشرع .
فشكل الأنكشارية صفين من العسكر في خط طويل يصل بين السراي وباب المدينة القريب وسمحوا للباشا بأن يخرج بأمان مع كل ما يملك ، وقد قضى في هذه الأنتفاضة كثير من المطلوبين ، وقام الأهالي بتفتيش الصنادق الكبيرة خشية أن تحوي بعض المجرمين ولكنهم لم يسيئوا إلى عبود بك كاخية الباشا بل تركوه يسير في ركاب سيده .
ما إن صار عبود بك خارج المدينة حتى أنطلق بجواده إلى عكار موطنه الأصلي ، بعد أن وعد بالعودة مع جيش لجب للأخذ بالثأر ، وانتظره خليل باشا دون جدوى ولما يئس غادر هو الآخر بأتجاه دمشق ومات في الطريق متأثرا بهزيمته على ما زعموا .
وبقي في المدينة قائدان من قادة الأنكشارية : إبراهيم سلطان ومصطفى الدلبة . كان الأول إسكافيا وكان الثاني أبن فران وكلاهما من الأورطة 67 ، فتقاسما السلطة ، إستأثر الدلبة بالقلعة ليشرف منها على المدينة فيما حل سلطان في سرايا الحاكم ، ودام الأمر على ذلك الحال أربعة عشر شهرا .
أرسل الباب العالي يوسف باشا العظم ، عم خليل المخلوع ، ليحل محله فتودد هذا إلى الأهالي ليقبلوه ولم ينزل في السراي ولا في قصر الوالي تواضعا بل إختار الأقامة في القنصلية الفرنسية التي كانت شاغرة منذ الحملة على مصر وتظاهر بالتواضع والزهد بما لم يسبقه إليه أي حاكم ، فتوالى عليه جماعات من الأرناؤوط والسكمان والجركس يعرضون خدماتهم فكان يصد الجميع في العلن ولكنه كان يدخلهم سرا في الليل من باب صغير في سورالحديقة .
ولما إجتمع ليوسف باشا نحو 1500جندي (1800في تشرين الأول) أمرهم بالهجوم على المدينة فاقتحم العساكر البيوت بيتا بيتا وأحتلوا كل حارة النصارى . فلجأت المدينة إلى السلاح وخاضت معارك عنيفة على مدى ثلاثة أيام بلياليها وأنتصرت ما أضطر الحاكم إلى أن يتراجع حتى حدود بيته ثم غادر بيته ليلا إلى الميناء آملا في أن يعيد الكرة في ظروف أفضل ، وكفّ عنه أهل المدينة فلم يتعرضوا لمسكنه ، وكان قد لجأ إلى الحيلة إذ ترك بيته مضاء في الليل فلم يشك المهاجمون في أنه داخل البيت حتى أكتشفوا الحيلة في اليوم التالي فأنقضوا عليه من البساتين فواجههم بمدفعين حصل عليهما من أحد أبراج الميناء ولكنه بعد جهود فاشلة لاذ بالفرار على متن مركب متخليا عن أسلحته ومبحرا بإتجاه قبرص .
واستمر الأنكشاريان يتقاسمان السلطة ، وداخلهما الطمع فأختلفا ، أوكل مصطفى الدلبة القلعة إلى باش شاويش ليتفرغ لشؤون المدينة وبرز اسم بربر وهو من منشأ غامض فنجح في أن يشكل حزبا ثالثا يدين له بالولاء في المدينة وفي القلعة ، وأستعان بأنصاره في القلعة ليتسلل إليها ليلا فيفاجئ اسماعيل رفقي الباش شاويش المكلف بحراستها وهدده بقطع عنقه إذا لم يتخل عن القلعة فسلمه المفاتيح وخرج فأعلن بربر أنتصاره بأن أطلق مدفعا ورفع رايته فوق القلعة .
فر الأنكشاريان ابراهيم سلطان ومصطفى الدلبة ولم يجروء هذا الأخير على العودة إلى القلعة ويقال أنه مات خنقا بأمر السيد الجديد .
أدرك بربر أنه يحتاج في حكمه إلى شرعية ما ، فلجأ إلى عميل لبريطانيا توسط له لدى الكومودور سدني سميث ليحصل له من الصدر الأعظم على لقب آغا تثبيتا لسلطته على جماعة الأنكشارية في المدينة لعلمه أن ذلك الصدر الأعظم لا يرد للكومودور طلبا ولو على حساب هيبة الباب العالي وسمعته ، فكان له ذلك فشرع بترميم القلعة وأخرجها من واقعها المتردي جدا مستخدما في ترميمها حجارة سراي الباشا التي ارتأى أن يهدمها تماما بحجة أن ترميم القلعة ضرورة لا بد منها لحماية المدينة ولكن هدفه الحقيقي كان الحؤول بين السلطان وبين كل أمل بتعيين وال جديد لطرابلس . وقام بأستدانة 36 إلى 40 كيسا لأتمام عملية الترميم التي لم تكن ناجحة إذ ما يكاد ينتهي من ترميم جدار حتى ينهار أخر. وفي أثناء ذلك عُيّن أحمد باشا الجزارحاكما على سوريا كلها فجدد ثقته ببربر وثبته في حكم طرابلس ، وكان ذلك من مظاهر الضعف في سياسة الباب العالي وإدارته لشؤون الحكم لا سيما في باشاويتي دمشق وطرابلس .
وبعد وقت قصير توفي الجزار فتناوب على حكم طرابلس إبراهيم باشا ثم أبنه محمد باشا ثم كالندر باشا ولكن أحدا منهم لم يأت إلى طرابلس التي ظل فيها بربر السيد المطلق مواظبا على تأدية نفقات الجردة بإنتظام والبالغة 450 كيسا أي 225 ألف قرش سنويا ، ولا نعرف على وجه الدقة ما إذا كان قد دفع ثمن ما ينعم به من هدوء حاليا هدايا لباشاوات طرابلس حتي يبقيهم بعيدا عن المدينة .
وحل يوسف كنجي باشا محل كالندر باشا في حكم طرابلس وكان كرديا ومن فرقة الدالاتية كسليمان باشا والي عكا الذي كان الأثير لدى الجزار وكان يوسف كنجي باشا واليا على دمشق في الوقت عينه ، وجاء تعيين الكنجي على خلفية إنهاء حالات العصيان في باشوية دمشق ووضع حد للتهرب من المتوجبات المالية للباب فقرر الكنجي أن يقوم بجولة عسكرية في شتى أقاليم الولاية فجاء إلى صافيتا بجيش لجب بعد أن زار حماه وحمص وحصّل جزءا من الديون المتوجبة على مناطق النصيرية .
شعر بربر بالخطرالداهم وأدرك أن الكنجي يحمل حكما من الباب العالي بقطع رأسه فحاول أن يثنيه عن المجيء إلى طرابلس ومنّاه بمئتي كيس ثم حسب أنه سيكون بمنجى في القلعة بتأييد من سليمان باشا والي عكا فرفض الخضوع للكنجي ونقض عهده ، فكان ذلك بمثابة إعلان العصيان على السلطنة والشروع في حرب ضد الباشا ، فكان لابد من التفكير في حماية الناس من المواجهة الرهيبة بين الجبارين المتصارعين .
كان يوسف باشا قد أرسل من اللاذقية عدة رسائل أوبيورلديات تدعو الأهالي للهدوء والوثوق به ووعدهم بالعفو عن كل المخالفات السابقة والصفح عن كل تمرد سالف مع التأكيد للجميع بأن المطلوب رأس بربر وحده وهو طلب توافق عليه ثلاثة سلاطين .
وظن بربر خطأ أن الكنجي لن يأتي إلى طرابلس إذا عرف أنها خالية من السكان ، وكان له من النفوذ على الأهالي ما يكفي لأقناعهم بترك المدينة ومغادرة بيوتهم فيها . ولما رأى أن عملية النزوح بطيئة فكر بتسريعها بأن كلف مناديا لينادي في الناس بأن أبواب المدينة ستقفل كلها بعد ثلاثة أيام ويصبح من المستحيل الدخول والخروج . فتحركت الجموع للمغادرة بعضهم بدافع الخوف من البلاء القادم والبعض إرضاء لبربر وعملا بنصيحته وحملوا ما خف وغلا من أمتعتهم ووضعوا بعضها أمانة في القلعة أو وزعوها على الخانات ولم يبق من السكان داخل المدينة ولا من المتاع إلا ما عجز الأهالي عن حمله أوما تدنت قيمته عن كلفة نقله ، وظلت المدينة خاوية شهورا عدة كحوض فارغ ولم يبق مأهولا سوى شريط من البيوت المتاخمة لأسوار القلعة مأهولا بعوائل الأرناؤوط ممن هم في خدمة بربر ، ولم يبق في المدينة من السكان سوى عجوز أسمه خليل أفندي ظل يحرس داره لقلة ذات يده وسوى راهب من رهبان الأرض المقدسة وقنصل فرنسا بدافع من الواجب والشرف مفضلا ركوب المخاطر على تنكيس راية الأمبراطورية لما في ذلك من عار ومهانة .
لقد نبت العشب في الشوارع ، وحتى مدينة الميناء خلت من سكانها وحُملت المدافع من الأبراج إلى القلعة وصارت المؤن والأقوات كلها في عهدة بربر فعطل كل الرحى في المطاحن وأخفى محاورها وسد السواقي ومجاري المياه ولم يبق للمعتدي سوى مياه الأبار وكانت غير كافية ومعظمها ملوث وغير صالح للشرب . ولو أستطاع لنقل مدافع أرواد وحقق بذلك نصرا أكيدا ولكن سكان تلك الجزيرة لم يطاوعوه في ذلك وأعادوا المركبين اللذين أرسلهما لهذه الغاية خاويين خائبين
وأصبح بربر في أمان لولا ظهور تسعة مراكب مسلحة قدمت من أرواد (15 آب 1808) ورآها تقتحم الميناء ولم يكن لديه في القلعة سوى ثلاثمئة وخمسين رجلا فاستولى المهاجمون على كل ما في الميناء من مراكب تركها أصحابها دون حماية ولم ينج من تلك الغارة سوى مركبين حظيا بما يكفي من الوقت للهروب والأقلاع .
وبعد يومين دخل يوسف باشا المدينة مع الفجر على رأس أربعة آلاف مقاتل وكان أول إهتماماته التأكد من سلامة القنصل الفرنسي وسلامة الأديرة والبيوت المرعية بالحماية الفرنسية بالأضافة للأعراب عن أعجابه بشجاعة القنصل وتقديره لجلالة أمبراطورنا وأبدى رغبته بأن يرفق أقواله بالأفعال بأن أرسل إلى القنصلية جنديين لحمايتها ممن كانوا يتربصون بها من كل جهة وحتى لا يبررأي معتد عدوانه بالجهل وعدم المعرفة .
ولا يفصل مقر القنصلية النمساوية عن القنصلية الفرنسية التي تقوم مكان دير متهدم قديم سوى بستان صغير . قنصل النمسا فر من المدينة كباقي السكان بعد أن عرض على القنصل الفرنسي أن ينتقل إلى داره على رجاء أن داره لن تقصف من القلعة بما سوف يقصف به جيش الباشا . وقد تشرفت الراية النمساوية بأن رفرفت بحماية الراية الفرنسية مستفيدة من كل أمتيازاتها .
دخلت قوات الباشا من ثلاثة أبواب وبادرت إلى أعمال النهب وأقتحمت المقرات الرسمية كما بيوت المدنيين دون تمييز واستحوذ الجند على كل ما ينفعهم بكل سهولة لخلو المكان من السكان ، حتى المساجد نهبت وحطمت أبوابها ونوافذها . واقتحم الجنود دير الأرض المقدسة ونهبوه لأنه كان بعيدا عن القنصلية ونهبوا أيضا بيوت الفرنسيين القريبة من ابواب المدينة كما نهبوا بيوت الآخرين دون تمييز ولكن ما إن ظهر أحد المترجمين التابعين للقنصلية حتى توقفت الفوضى تماما ، وأعتذر الباشا عما تعرضنا له في غفلة منه وتعهد للقنصل بالتعويض من جيبه الخاص عن كل ما سببه الجند غير المنضبطين من ضرر.
استقدم يوسف باشا من دمشق أطقم النجارين والحدادين وعمال المياه ليعيدوا تأهيل المجاري للحصول على الماء ، ودفع مبالغ طائلة للحصول على البقسماط ( ) وبعض المؤن الأخرى من حمص وحماه ومن نواحي الساحل ، وكان معه نحو عشرين من مدافع الميدان وزوده الأرواديون بما استطاعوا من أسلحة الحصار وكانت تلك المدافع أعجز من أن تلحق الضرر بأسوار القلعة فكان بحاجة إلى أقوى منها مما ليس في جيشه مثله فلجأ إلى قنصل فرنسا ليزوده من قبرص بعسكريين فرنسيين مختصين بالمدافع وقد تردد القنصل بين أن يقدم هذه الخدمة التي لن تكون دون مقابل على فرنسا وبين تقديم الدعم لحليفنا الباب العالي لأعادة مدينة خارجة عن الطاعة منذ سنوات إلى كنف الشرعية . فجاء أحد الضباط ومعه عشرة من ذوي الأختصاص لتنفيذ تلك المهمات ، ولكن قائد تلك المجموعة لم يكن على المستوى المأمول لا خبرة ولا شجاعة فقد ركز مدافعه على ربوة قريبة مشرفة على القلعة من الجهة الشرقية وتركه بربر يفعل مع أنه كان يستطيع منعه ببندقية أم فتيل العتيقة ، أما المدافع التي نصبت في الأسفل من الجهة المقابلة فقد كانت قريبة جدا من القلعة ولكنها أشد تحصينا وأفضل حماية .
أما بربر الواثق من أن قلعته أمنع من أن تؤخذ عنوة فقد قرر أن لا يكون البادىء وأن يترك للباشا تلك المسؤولية . وبعد خمس أو ست طلقات من المدافع المهاجمة أطلقت مدافع بربر ثلاثة قذائف كانت كافية لأعطاب المدافع المهاجمة وتخريب تلك المساعي برمتها .
وقد أعتذر قائد تلك الوحدة الفرنسي عن ذلك الفشل بأن مدفعية الباشا لم تقم بالأسناد المطلوب وهو عذر غير مقبول حاول أن يغطي به على تقصيره وجبنه علما بأنه كان قد قبض سلفا من الباشا ألف قرش بدلا عن أتعابه . وكاد الباشا أن ييأس ويتخلى عن المهمة ولكن قنصل فرنسا شجعه على الأستمرار لما في الأنكفاء من ضياع للسمعة والشرف ، لا سيما وأن المحاصَرين كانوا لا ينفكون يهزأون منه ويكيلون له الشتائم من فوق الأسوار ويبشرونه بهزائم أقسى وأشد إذا لم يرعو ، ما دفعه إلى إتخاذ قراره بالأستمرار بالحصار حتى النصر أو الموت وقام بتركيز المدافع من جديد في أماكن أخرى وعندما نفذت كل القذائف عمدوا إلى صب قذائف جديدة من نحاس .
وفتحت النيران من كل الجبهات ولكن شجاعة الباشا كانت أكبر من حظه لاسيما وأن قواته تمردت عليه ورفضت الهجوم على القلعة ما لم يتعهد الباشا بأباحة موجودات القلعة للمهاجمين عندما تسقط ، فقد كان الجميع يحلمون بما تحويه من ثروات خيالية .
كان يوسف باشا أمام خيارات صعبة وأصعبها أن دمشق قد بدأت تتحرك مع أنه أحسن صنعا بالأحتياط من أي إنقلاب عليه في غيبته بأن استصحب كل من يمكن أن يشكل تهديدا بالأنقلاب عليه ، لا سيما رجلين أثنين كان يخشاهما كل الخشية .
كان سليمان باشا قد سبق الكنجي للتعامل مع الأنقلاب الجديد الحاصل في أسطمبول ولم يكن مطمئنا إلى نوايا السلطان الجديد . كان الكنجي محاطا بالخونة وضعاف النفوس ولم يكن واثقا من المدد الذي وعده به الباب العالي وكان سليمان باشا قد أخفى عليه نبأ ما كان على وشك أن يرسله إليه من مدد يشمل المدافع والمؤن والذخائروالأغذية ، بل نصحه بالتخلي عن المهمة وأرسل وفدا من قبله رفيع المستوى يعرض عليه التوسط بينه وبين بربر .
فلم يكن من يوسف باشا لجهله بما كان سيصله من مدد ، ولما كان الناس يتداولونه من أن السلطان الجديد على وشك أن يعزله ، وبسبب النكسات العسكرية التي مني بها ، إلا أن يعتبر الوساطة حلا مقبولا فقبل بأن يمنح بربر حرية الأنسحاب من القلعة مع أنصاره وحرمه وما يملك من متاع . وبعد أن إجتمع بربر بيوسف باشا إجتماعا قصيرا خرج من القلعة في موكب صغير ومعه نفر من أنصاره متوجها إلى عكا . بخروجه حل الخوف محل الوقاحة والتحدي فاعتمر قبعة الدالاتية ليستمد منها الأحترام والحصانة في عين غريمه الذي كان من قادة هذا الفصيل المرموق .
وعندما آلت القلعة إلى يوسف باشا أعاد إلى السكان كل ما كانوا قد وضعوه فيها من أمانات . وكان الأيفاء بالعهد كاملا ، ولم يحتفظ يوسف باشا لنفسه بشيء ولم يفرض على الأهالي أي تعويض أو مساهمة عقابا لهم ودعما لخزينة الدولة عن المبالغ الضخمة التي تكبدها والتي زادت على ثلاثة ملايين قرش فضلا عن رواتب الجند .
ترك بربر في القلعة ستين مدفعا منها ثمانية مدافع معطوبة ونحو مئتي برميل من البارود وبعض القذائف ( الكلل) وليس بينها أية قذيفة من العيار الثقيل . وقد مات في القلعة من الحصار نحو 300 نفر من مختلف الأعمار والأجناس ، معظمهم مات بالأوبئة ، لم يتضرر المحاصرون من القصف بل من الأمراض وعيّن يوسف باشا دزدارا على القلعة علي بك( ) من أكابر وجهاء عكار والذي عرف بشهامته وغناه ونبل مقاصده ، وعاد بعد ذلك إلى دمشق .
هدأت طرابلس في عهد علي بك ولكن الأضطرابات عاودتها سنة 1810 فقد إقترب الوهابيون من المزيريب على ثلاثة أيام من دمشق فأرسل يوسف باشا كنج معظم قواته لصدهم وزعم سليمان باشا والي عكا أن الباب العالي قد أمره بالمساعدة على دفع الخطر فتقدم من دمشق على رأس 14 ألف مقاتل معظمهم من الدروز يقودهم الأمير بشير والشيخ بشير شخصيا .( ) متكتما على أوامر الباب العالي بقطع رأس يوسف باشا.
وأدرك يوسف باشا حقيقة ما يضمره القادمون فخرج لمواجهتهم مع البقية الباقية لديه من العسكر ولاحت له في البدء بوادر النصر لشجاعته وشجاعة من معه ، وأنهزم الدروز من الصدمة الأولى وانهزم معهم سليمان باشا شر هزيمة لولا أن بعض قادتهم ترجلوا مقسمين على الموت أو النصر ما رفع من معنويات الدروز الآخرين ودعاهم للأقتداء بهم .
خسر يوسف باشا المعركة ولم تنفعه شجاعته ومع المعركة خسر دمشق وطرابلس فعهد سليمان باشا بالقلعة إلى أحد الأرناؤوط واسمه إسماعيل ماركو الذي كان من أبرز المقاتلين إلى جانب يوسف باشا ولم يتمكن هذا من تسلم القلعة إلا عندمت تنازل له عنها يوسف آغا وهو أرناؤوطي آخر كان قد أستلمها من دزدارها الأخير ورفض أن يسلمها إلى إسماعيل قبل أن يطلع بنفسه على الأمر بتعيينه موقعا من سليمان باشا . وقد حاول بعض العصاة من أهالي طرابلس إخراجه منها بالقوة رافضين تزويده بالمؤن فما كان منه إلا أن يرمي المدينة ببضعة قذائف .
أرسل بربر عبود بك البحري لإدارة المتسلمية بصورة مؤقتة ولما رفض علي بك تسليمها إلى عبود بك لجأ الناس إلى السلاح لطرد علي بك منها ، ووصل بهم الأمر أن يطلقوا عليه النار مع أن الكثيرين منهم ما يزالون إلى اليوم يعيشون على عطاءات علي بك وأفضاله .
لم يعد لبربر أية سلطة على القلعة بل منع من دخولها ويمكن الجزم بأن سلطته قد تقلصت إلى حد كبير عما كانت عليه . وله في المدينة خصوم ولكنه يسترضيهم بالكثير من الأعفاءات بحيث بات الجميع يشعرون بأن أي تغيير في السلطة ليس لمصلحتهم . في العهود السابقة كان المفتي ونقيب الأشراف وقاضي القضاة وكل الأفندية وقادة الجند لهم على المدينة تعيين وكان على أصحاب الأفران والجزارين أن يقدموا لحراس القلعة كل ما يلزمهم بنصف ثمنه وكان على المدينة كلما أتاها ضابط جديد أن تقدم له هبات معينة .
لقد ألغى بربر كل هذه التجاوزات ومنع الخوات تماما وحتم على جنوده وعلى نفسه أن يدفعوا ثمن ما يشترونه بالسعر العادي الذي يدفعه العموم ، وحرر الصناعات والحرف فحاز على
رضى الجميع ، والحق أن عنده ما يكفي من العفوية والذكاء الفطري وحسن الأدارة في ضبط الأمور . أبقى في خدمته على أربعين نفر فقط من الحرس الخاص وخصهم برعاية كافية ، ولديه دالي باشي أسمه جهير آغا وقائد أرناؤوطي إسمه سعيد آغا نجحا في تجنيد ثلاثمئة نفر من الفرسان وسلاح المدفعية ووضعاهم في خدمته . هؤلاء القادة لا يضمرون له إحتراما كبيرا ولكنهم مخلصون في خدمته إنفاذا لرغبة الباشا الذي يدفع لهم رواتبهم .
هو نفسه عقد مع الباشا اتفاقا ملزما بالأمتناع عن فرض أية ضريبة طارئة خلافا لباقي المتسلميات . إنه غني بالمال والعقارات والأراضي ، ولكي يقطع على خصومه كل أمل في ثروته فقد أوصى بثلثي ثروته لأولاده لو رزق أولادا والثلث الباقي لأرقائه إذا مات دون عقب . وعنده إثنا عشر رقيقا بين ذكور وإناث يقاسمون أفراد أسرته في كل شيء ، إنه يحاول فعلا أن يبدو مسلما حسن الإسلام .
تقوم طرابلس على ربوتين يمكن اعتبارهما جزءا من جبال لبنان ويشرف على هاتين الربوتين في شمال المدينة جبل سماه الأوروبيون سقف السفينة لما رأوه فيه من شبه بخيمة القادس ( ) . وقد يبلغ هذا الجبل ربع عقدة طولا في أحسن تقدير ونصف عقدة عرضا .
وليس للمدينة من سور فعلي ولا من خندق يزنرها ، وبيوتها متلاصقة وتشكل هي نفسها سورا منيعا ، يناهز عدد أبوابها السبعة عشر بابا بين كبير وصغير وقد ألغى بربر نصفها .
نهر قاديشا ينبع من مغارة تحت غابة الأرز المقدس ثم يتلقى روافد عدة من جبال لبنان ومن الضفتين قبل أن يقسم المدينة إلى شطرين غير متساويين ، الضفة اليمنى هي الأصغر والأقل أهمية ، ويصل بين شطري المدينة جسران ليس لأي منهما ما يميزه لا حجما ولا فنا .
كل بيوت المدينة من حجر وهي تعاني الأهمال والتلف ولكنها عالية نسبة لسماكة جدرانها الخارجية التي تتألف من حجر واحد لا يزيد سمكه غالبا على ثماني بوصات ( ) وكل بيت من بيوتها يمكن أن يتحول إلى قلعة صغيرة إذا قرر سكانها القتال ضد معتد غير مزود بمدفعية.
شوارعها مبلطة وفيها كثير من القناطر والعقود الحجرية الداعمة للأبنية من الزلازل ، تستند إلى هذه القناطر أو إلى بعضها خزانات الماء التي تنز بإستمرار بسبب بعض الفجوات ، والخزانات موصولة بالنهرمن مسافة ساعتين من المدينة لجهة الجنوب الشرقي فوق درويشية من أجمل مناطق المدينة وعلى بعد ربع عقدة من المدينة قناة تقوم على قناطرثلاث يبلغ طولها 140 خطوة، وظيفتها أن تضيف ماء الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى لتزويد الحمامات والأحواض وسواقي الري في المدينة ، لم يبق من هذه القناطر سوى أثر غامض لصليب منقوش على القنطرة الوسطى يدل على إمكانية أن تكون تلك القناطر صليبية ، وتحت هذه القناطر جسر ضيق للمشاة لا يتسع لأكثر من رجل واحد يعود على الأرجح إلى العهد نفسه ويسميه الناس جسر البرنس . ( )
ليس في المدينة ما يدل على القدم إلى ما قبل العهد الصليبي والمآذن ليست سوى أبراج النواقيس للكنائس القديمة . وإن توالي الألوان بين الأبيض والأسود في قباب المداخل وزخارفها وكذلك في النوافذ تشير إلى تأثر فن العمارة بالفن الأيطالي إلى حد بعيد .
هذا المزيج بين الأسود والأبيض نجده في معظم جدران الأبنية العامة والخاصة التي لها شأن . وليس من النادر أن نجد في الأبنية الخاصة أرضيات من الرخام الملون بألوان زاهية عديدة تشكل موزاييكا جميلا . هذا الرخام يؤتى به من مقالع في الضنية على خمس ساعات من طرابلس( ).
تقوم القلعة التي سبق أن تحدثنا عنها في الجنوب الشرقي من المدينة . وهي مكشوفة للمدافع من ثلاث جهات ويمكن نصب المدافع فوق الهضاب المشرفة على القلعة والتي تعلو إحداها قبة مسجد كبير تدعى قبة النصر الي بنيت تخليدا لذكرى إنتصار المسلمين على الصليبيين .
ليست الجدران الداخلية للقلعة على قدر كبير من الصلابة ما سهل دكها بالقنابل وأدى إلى تدميرها ، ولقد أكتفى بترميم ما تهدم منها في الجهة الجنوبية . أما الأسوار الخارجية فهي أصلب وأسمك ويشد بين حجارتها ملاط متين من حصى متماسك . وتكثر في الناحية الجنوبية تلال صغيرة من الأتربة والردميات يسهل نصب المدافع فوقها وتوجيهها نحو القلعة من مسافات قصيرة لا تزيد عن مرمى بندقية . وفي حرم القلعة خزانات للمياه وآبار لا بأس بها وهي تستوعب ألف مقاتل ويقوم على حمايتها في هذه الأيام قائد من الأرناؤوط على رأس مئة جندي راجل ، وهناك بالأضافة إلى بابها الطبيعي في الجهة الشمالية دهليز سري يقال إنه في الجهة الجنوبية .
ليس في طرابلس ساحات عامة . وفيها سبعة خانات لم يبق منها بحالة جيدة وصالحا للأستعمال سوى خمسة ، وأسواقها معتمة وليس فيها ما يلفت ، وفيها سبعة أو ثمانية حمامات نظيفة ودزينة من الجوامع وكنيس وكنيسة للروم يخدمها مطران وأربعة مضافات للأرساليات الأوروبية وهي إرسالية الأرض المقدسة والآباء الكرمليين والكبوشيين واليسوعيين ، وقد حل العازاريون محل اليسوعيين منذ أن حل تنظيم هؤلاء .
هذه المضافات بإستثناء مضافة الأرض المقدسة لا يأتيها من أوروبة أية مساعدة ولذلك فهي بحالة يرثى لها ولا يقوم على خدمتها أي رجل دين في الوقت الحاضر . وقد نزل قنصل فرنسا في خرائب الأرسالية العازارية لأنه لم يجد مكانا أفضل لسكناه وهو يدفع مبالغ باهظة بدل أيجار.
أما المضافات الأخرى فتشغلها عائلات من أهل البلد الحائزين على الحماية الفرنسية ويدفعون بدلات تتناسب وحالهم من البؤس .
يمكن تقدير سكان طرابلس بخمسة عشر ألف نفس مقسمين كما يلي :
1300 أنكشاري من الأورطة 36 و67 وهذه الأخيرة أكثرعددا .
100 من حرس السواحل
800 من الأشراف أي الأسر التي تعودبنسبها إلى النبي
2700 يونانيين( المقصود روم)
200 كاتوليكي (المقصود موارنه)
100 يهودي
9000 تركي ( المقصودمسلم )
------
14200 المجموع
في فصل الشتاء يرتفع هذا العدد بنزوح فقراء الموارنة من الجبل إلى الساحل ، إما بحثا عن عمل أو بسبب الثلوج التي تغطي جبالهم فيقيمون في مغاور يحفرونها في الصخر على جانبي وادي النهر الواقع في آخر سلسلة جبال لبنان ( ) أو في بيوت طرابلس المهجورة ليصل عدد سكان المدينة إلى 15000 نسمة .
تجدر الأشارة إلى أن هذا العدد يشمل أيضا سكان الميناء الذين يناهزون ثلاثة آلاف نفس .
تنتهي آخر جبال لبنان كما ذكرت آنفا بسهل منبسط وشاطيء ساحلي متصل بعرض نصف ساعة وهو سهل رملي تغطيه أشجار البرتقال والليمون الحامض وبعض الثمار السكرية كالفرصاد (التوت) والمشمش وهو ثمر مرغوب من السكان المحليين ولكنه يؤذي الأوروبيين . في بعض نواحي هذا السهل القريبة من البحرمستنقعات ، وقد كان هذا السهل محميا في القديم بستة أبراج ما تزال قائمة ولكن الأهمال حوّل بعضها إلى خرائب وجردت من مدافعها فأصبح الشاطىء دون دفاع ، ويفصل بين البرج والآخر مسافة طلقة أم فتيل ( ) ، ويبدو أنها من بقايا الصليبيين ، أحدها يحمل اسم برج السباع . وله رنغ ( ) ما يزال بحالة جيدة وعلى أحد وجهيه صورة لبرج تشبه صورة الشاطيء وفيها وشم يحمل كلمتي civitas tripolis ، وعلى الوجه الآخر صورة أسد في رنك مثلث ( وهو إذا لم أخطئ شعار أسلحة آل تولوز ) مشفوعة بهذه الكلمات vis comitis tripolis وهذاما يؤيد أقوالي ( ) .
هذا الرصاص الذي لم يتلف منه سوى إسم صاحب الرنك يذكر أن ريمون الثالث رابع وآخر كونت حكم طرابلس والذي توفي دون عقب قد أوصى بالمدينة لبوهيموند الثالث أبن عمه أمير أنطاكيا .
أما الأبراج الثلاثة العليا فهي مميزة بعمارتها عن الأبراج الأخرى ، وفي برج القناطر كتابة بالخط العربي من ستة عشر سطرا وقد سمي البرج برج القناطر لأن في مدخله عدة قناطر غير متقنة الصنع لعلها من بقايا المنتصرين على الفرنجة وهي متخلفة عن تلك التي إلى الشمال . وإن البرج الجنوبي من البرجين هو برج الميناء ومعظم سكانه من اليونانيين ( المقصود الروم ) وفي هذا القسم مخازن كبيرة وسراي هامة مكتظة دوما بالغادين والرائحين . وفي هذا القسم تعقد معظم الصفقات وتنجز كل النشاطات التجارية وفيه ورشات بناء المراكب المجسّرة وغير المجسرة وفيه تبنى منذوقت غير بعيد مراكب الكاييك بحمولة سبعة إلى ثمانية آلاف كيلو اسطمبولي ( ) . وعيب هذه المراكب أنها لا تعمر طويلا بسبب الوصلات غير المتقنه بين أجزائها بشكل عام وبسبب نوعية الخشب الرديئة بشكل خاص . وليس في طرابلس سوى مرسى واحد جدير بهذا الأسم وهو محمي ببعض الصخور الناتئة التي تصد الأمواج من ناحية جزيرتي الأرانب والحمام .
هذه الصخورالطافية تسمح بمرور المراكب الصغرى وتحمي الميناء من عنف الرياح الجنوبية الغربية وهي الأعنف والأدوم بدليل إنحناء التلال الرملية والأشجار إنحناء حادا بإتجاه الشمال الشرقي
أرض المرسى من صخر كلسي بين برج السباع وبرج النمر وبعضها موحل القعر بحيث لا خوف من العطب إذا جنحت فيه المراكب الصغيرة .
وبين برج النمر ومصب النهر أرض من حصى . يتسع المرفأ لعدد كبير من السفن تفصل بينها مسافات تتناسب مع حجم السفينة ، وتحرص الفرقاطات والسفن الكبرى أن لا ترمي مراسيها إلا على مسافة أربعة أميال بحرية من الشاطئ في كنف جزيرتي الأرانب والحمام اللتين كانتا مأهولتين ثم أقفرتا سنة 686 هجرية (1287م) وهو تاريخ عودة المسلمين إلى إحتلال البلاد .
وما تزال بعض أشجارالنخيل ترى في جزيرة الأرانب ولقد حال عدد الأولاد المتجمهرين علينا عند وصولنا الى تلك الجزيرة دون إكمال زيارتنا لدراسة أحوالها وما يمكن أن يكون قد بقي من مساكنها الدارسة .
إلى الشمال وعلى مسافة ثلاثين ميلا يبدو في الأفق رأس الحصن الذي تقع خلفه مدينة طرطوس. وإلى الجنوب وعندما نتجاوز الحواجز الصخرية التي تشكل حدود الميناء فإن الشاطيء ينكشف عن مرسى آخر يمتد جنوبا إلى مسافة 15 ميلا وينتهي عند جبل داخل في البحر ( ) بإنحدار عمودي أشبه ما يكون بجدار عظيم ، وفوق قمة هذا الجبل ينبسط نجد سهلي( ) . في سفح هذا الجبل بقايا صخوريصعب الأقتراب منها بسبب تكسر الأمواج العاتية عليها.
في تلك الجهة وعندما يصفو الجو تنكشف مساحات لا بأس بها من الصخور الطافية التي تشكل أجرانا ذات أرضية مسطحة ومتفاوتة العمق وكأنها قد صنعت خصيصا لأنتاج الملح من تبخر المياه في حرارة فصل الصيف .
تقوم الميناء على أنقاض مدينة طرابلس القديمة ويلاحظ في الجهة الجنوبية بقايا سور قديم كان يحمي طرابلس وكان عريضا جدا ولكنه مختلف الصلابة . وفي أسفل الأبراج وعلى طول الساحل تنتشر قطع أعمدة الغرانيت الرمادية الضخمة وقد أستخدم بعضها في بناء الأبراج ، وفي الشاطيء كميات من الرخام الملون بشتى الألوان ومن الزجاج الذي تقشّر بفعل الزمن ونتج عن تقشره قطع ذات شعاعات لونية متقزحة رائعة الأشكال والألوان . ولقد بدأ منذ بعض الوقت بالتنقيب الجدي فأكتشفت أحجار بناء وكتابات يونانية ولاتينية وخطوط عربية كوفية وبعض تماثيل صغيرة وأجزاء من الأنصاب ولكن لم يوفقوا حتى اليوم إلى إكتشافات ذات قيمة كبيرة ، وما عثر عليه من منحوتات لا قيمة له ، ويعود تاريخه إلى العهد الروماني المتأخر وقد يقعون أحيانا عل قطع صغيرة من الذهب التي قد يبتلعها مكتشفها إعتقادا منه أنها ذات مفعول أكيد في الشفاء أوالوقاية من الأمراض.
أهم صناعات المدينة صناعة الحرير وهم ينتجون منه اليوم أكثر مما كانوا ينتجون في الماضي بسبب زيادة الأهتمام بزراعة الفرصاد (التوت) وانتشارها على مساحات جديدة كانت في الماضي مستنقعات ثم جففت فتحسنت فيها الظروف الصحية بعد أن كانت على درجة من السوء كما في قبرص والأسكندرون .
وبين أنواع الحرير المعروفة يأتي حرير طرابلس في الدرجة الأولى لما تميز به من بريق خاص وصلابة في الخيط ، لذلك فهو المفضل لدى مصانع النسيج في مدينة ليون المتخصصة بصناعة مواد الزينة من الحرير المقصّب (gallons) .
وفي المدينة نحو 50 نولا تنتج نحو 5000 شملة ( ) يباع منها في السوق الداخلية ما يباع ويصدر الباقي إلى أهم العواصم في الأمبراطورية العثمانية . روعة النسيج وثبات ألوانه ومتانة خيوطه تجعل منه المفضل على كل ما عداه . تباع الشملة حاليا بصرف النظر عن ألوانها بخمسة عشر قرشا الأونصة وتزن الشملة خمسة أونصات وكل اونصة بخمسة دراخمات ويعني ذلك أن سعر الواحدة يتراوح بين 70 إلى 80 قرشا .( ) هناك بعض الأنوال المخصصة لأنتاج القطنيات من نوعية أدنى بكثير وبعضها مدبوغ باللون النيلي الخاص بأثواب النصارى ويؤتى بالقسم الأكبر من القطن من جزيرة قبرص .
وفي طرابلس ثلاث مصابن في ذروة إنتاجها ( ) وهي مربحة لأنها محافظة على أسعارها ولأن بضاعتها من الضرورات التي لا غنى عنها ، صناعة طرابلس من الصابون مميزة ورائجة ويفضلها الناس على صابون كريت أو صابون البلاد السورية الأخرى ، زيت هذه الصناعة ينتج محليا وهو غاية في الصفاء والجودة ومع أن موسم الزيت يكون جيدا كل سنتين فإن الموسم الجيد يغطي الموسم الماحل ويفيض . والقلي الذي ينتج بعضه في طرابلس لتوفر النبات الذي يستخرج منه على طول الساحل يشتري الطرابلسيون أكثره من حماه وضواحيها بأسعار زهيدة .
القلي والكلس يدخلان بنسبة متساوية في صناعة الصابون وبما أن سعر الصابون يساوي سعر الزيت أو يزيد أحيانا فإن الربح من هذه الصناعة كبير ومغر لأن سعر مركبات الصابون الأخرى أدنى بكثير من سعر الزيت . يربح صانعو الصابون 25% بشرائهم الصابون من كريت وإعادة طبخه لغنى الصابون الكريتي بمادة الزيت ونقص القلي فيه فيضيف الطرابلسيون إلى الصابون لكريتي ربع وزنه من القلي بعد أن يعيدوا طبخه .
يصدرالصابون الطرابلسي إلى حمص وحماه وحتى إلى قبرص وطرطوس عندما تكون الأسعار مناسبة .
وليس في المدينة سوى مدبغة واحدة تستورد الجلود المملحة من مصر ويدبغ فيها أيضا السختيان الأصفر والأحمر والأزرق ما يسد حاجة البلد .
صناعة الفخار صناعة عادية لا تمتاز بشيء اللهم إلا قلب الغليون وقلب النرجيلة وهما من فخار نقي أملس وصلب ويؤتى به من بيروت .
النجارون وعاملوا السقوف والحدادون والحرفيون الآخرون متخلفون لنقص في الكفاءة وفي المعدات .
يتاجر الطرابلسيون تقليديا مع مصر(دمياط) وحمص وحماه ودمشق وحلب . ويشترون من مصر المنسوجات الكتانية وجلود الجواميس والبقر والرز والبن والحنة وملح النشادر والصموغ وأنواع العطارة ويبيعون لمصر الحرير وخيوط مشاقة الحرير والعطارة الحلبية وأصناف العطور وهي جيدة المردود يصل ربحها إلى 15% وقد يصل إلى 25%.
ويشترون من دمشق المنسوجات الحريرية والقطنية ووبر الحشيّات الذي لا غنى عنه لمعظم سكان المدينة والجوار . ويأتون من حمص وحماه وحلب بقماش serbage وكميّات من الحرير والقطن من نوعية متواضعة الجودة مما تنتجه دمشق ومن الأنسجة القطنية الطبيعية والمصبوغة من ديار بكر وبغداد ويصدرون إليها بالمقابل شملات الحرير وخيط مشاقة الحرير والرز والمنسوجات المصرية والزيت وأصناف العطارة .
وتشكل الحمضيات جزءً مهما من صادرات المدينة إلى جميع هذه الأقطارمع العسل والشمع والعفص والخمور والحبوب والفاكهة التي يكثر إنتاجها في طرابلس وبذلك تتكون عندنا فكرة كاملة تقريبا عن مداخيل المدينة . أما التجارة مع الفرنسيين فقد بدأت تتراجع منذ 1790 ، لأن حرير طرابلس الذي كان في أساس التجارة مع فرنسا قد تراجع الطلب عليه في فرنسا بصورة متزايدة يوما عن يوم بسبب الثورة التي أتت على تجارة الكماليات .
وجاءت الحرب الأخيرة لتقضي على البقية الباقية من التجارة مع فرنسا وليس في طرابلس اليوم أي تاجر فرنسي ، فالقطن والعفص والشمع والأسفنج الناعم الذي تنتجه الشواطئ بكثرة بدأ يصدر إلى أسواق جديدة وأقطار أخرى .
كنا نستورد أيضا كميات من الحبوب من سهل عكار وصافيتا عندما يفيض الأنتاج على الأستهلاك المحلي . ولا ينبغي لنا أن نأسف على الفرص الضائعة لأن سنين القحط قد تكررت مؤخرا كما تسببت القوارض بكوارث مميته في مواسم السنة السابقة بالأضافة إلى إحتكار الحكام لتجارة الحبوب ، كل ذلك لم يترك لنا أي أسف على ما فات .
وعندما تزول أسباب هذا البوار في التجارة فعلينا بالحذر والحيطة من تغيير بعض قواعد التعامل التي ألفناها سابقا . وفي رأي أن إختيار قنصل ذكيّ غيور وعادل كفيل بوضع حد للتجاوزات التي كانت تحصل لاسيما تلك التي يتعدى فيها الحاكم حدوده في فرض الرسوم ، ونرى أن من مصلحتنا إستبدال بنود الأمتيازات المطبقة اليوم بين فرنسا والباب العالي بمعاهدة تجارية تضمن مصالحنا وتغنينا عن اللجوء إلى حق الحماية كلما تعرض فرنسي أو أحد المشمولين بالرعاية الفرنسية لمظلمة أو أراد أن يتجنب سوء تطبيق القانون .
تتألف باشوية طرابلس بدءا من الشمال من :
1. أقليم طرطوس : ومعظم سكانه من المسلمين وعددهم ألفان تقريبا وفيها قلعة غير مهمة وكنيسة قديمة جدا .
وفي الجهة المقابلة لطرطوس ، على مسافة ميلين أو ثلاثة أميال من الشاطيء جزيرة أرواد وهي صغيرة المساحة ، شعبها نشيط يتقن الأعمال البحرية وقد أستفادت الجزيرة من توقف المراكب الفرنسية لتقوم بأعمال المساحلة (الملاحة الساحلية) . ويحكم الجزيرة قبطان باشا.
2. أقليم صافيتا : وهو غني بالقمح والشعير والحرير والخضار وجميع سكانه من من النصيرية وعددهم نحو أربعين ألفا ، واسم الحاكم الشيخ زكّاروهومتسلم الأقليم . في صافيتا بقايا حصن قديم من الحصون التي يرتادها أمراؤهم الملقبون بشيوخ الجبل في مواعيد محددة ليشرفوا على توجيه الشبيبة وتدريبها على الطاعة لشيوخها طاعة مطلقة بحيث ينفذون أصعب المهام دون تردد وبكل إخلاص ولو كلفهم ذلك حياتهم .
3. عكار : يقسم الأقليم إلى ثلاث مناطق يحكمها ثلاثة متسلمين : علي بك وعبود بك وقدور بك . وجميع السكان تقريبامسلمون وعددهم ثلاثون ألفا
4. عرب قبيلة الجحيش: يعيشون في خيام بين صافيتا وعكار وعددهم 1500 تقريبا .
5. إقليم الشعرا فيه أكثرية مسلمة ونسبة كبيرة من الروم والنصيرية ولا يزيد عدد سكانه على 2000 وقد أشتهر بإنتاج الحرير
6. الضنية وهو الأقليم الواقع إلى الشمال الشرقي من طرابلس في الطرف الشمالي من جبال لبنان وقد يبلغ سكانه خمسة آلاف نسمة من المسلمين فيه متسلم أسمه علي رعد وهذا الأقليم غني بالأشجار المثمرة وخشب البناء والعسل والرخام من شتى الألوان وأزهاها ومنه يأتي الطرابلسيون بالثلج لتبريد شرابهم في فصل الصيف .
7. أقليم المنية : يقع في أسفل الضنية وقد جعل منه حاكم طرابلس الحالي مالكانة وفيه نحو ألف نسمة من المسلمين .
8. أقليم جبيل الكبير التابع لأمير الدروز بشير والذي يقسم إلى مقاطعات يسكنها موارنة
وروم وبعض المسلمين وهي :
أ- جبّّة بشري أو جبال بشري إلى الشرق من طرابلس وفيها نحو عشرة آلاف ماروني
ب – منطقة الزاوية جنوب شرق طرابلس متسلمها من آل الخازن الذين حازوا على لقب
(قنصل فرنسا في بيروت) ويلتزمون المنطقة من الأمير بشير . ويبلغ عدد سكان الزاوية سبعة آلاف معظمهم من الروم
ج – منطقة الكورة السفلى والكورة العليا وفيها نحو ثمانية آلاف نفس ، في الكورة العليا غالبية من الروم مع قلة من المسلمين وفي السفلى يتعادل المسلمون والروم والأقليم مشهور بزراعة التبغ وهو أجود من التبغ اللاذقاني .
د – أقليم البترون وفيه مرفأ صغير وتلحق به قرية دوما المعروفة بمنجم الحديد وهو حديد مطاوع يلزم امير الدروز المنجم إلى بعض العائلات بمبلغ سنوي يبلغ عشرين كيسا ، والحديد المستخرج يستخدم في صنع حدوات الخيل في جميع أنحاء سوريا ويحقق مستثمروه مرابح كبيرة.
ﻫ - جبيل وهي ساحلية وسكانها مع سكان البترون يبلغون 25 ألفا .
بلغ مجموع ما جُبيَ من هذه الأقاليم في العام السابق 192731 قرشا ولم يزد مدخول الجمارك على 18764 قرشا وقد حدث في الماضي أن تحصل مثل هذا المبلغ في ثلاثة أشهر إذا كانت التجارة في أوجها .
يبلغ خراج طرابلس 4794( ) قرشا ومن البساتين 2580 قرشا ومن الميري والحرير 35000 قرش ومن المطاحن 525 قرشا ومن المسلخ 1560 قرشا و6000 قرش مداخيل أخرى متفرقة ليصبح المجموع أكثر من 531 كيسا بقليل .
لم يكن في السابق يصل إلى خزينة السلطان أي قرش من هذه المبالغ لأنها كانت تذهب إلى الجردة بنحو 450 كيسا . أما اليوم وبما أن الحج قد توقف منذ مدة فإن الباشا يحتفظ بهذا المبلغ لنفسه وقد يدفع جزءً يسيرا منه للجردة .
عندما كانت الطريق إلى الحاج سالكة فإن مبلغ 450 كيسا وفوقه مبلغ آخر أكبر منه كان يحصل من اللاذقية لم يكن ليكفي لتسديد النفقات والتي كانت تشمل المؤنة من شعير ورز إلخ .. وأيجار الجمال لتحمل تلك المؤن لأطعام الحجيج مع مبلغ 82732 قرشا كانت تدفع للأعراب حتى يسمحوا لها بالمرور بالأضافة إلى عطاءات أخرى كانت تقدم إلى زعماء القبائل وتبلغ 690 لفة جوخ و99 عباءة و344 قفطانا و370 غمبازا و350 شالا دمشقيا غطاءً للرأس و346 سروالا من الجوخ الأحمر والبرتقالي و301 قرش ثمن بوابيج (أحذية من الجلد الأصفر) و341 زوجا من لأحذية وثمانية عباءات من (غير مقروءة) وخلعتان من الفرو السمور وخلعتان رماديتان .
هذه النفقات جعلت من طرابلس باشوية غير مرغوبة لأنها لا تترك للمتسلم سوى هامش ضيق للربح . وبالأضافة إلى الأقاليم الثلاثة عشر هناك أربع قرى تلزم حصرا لأربعة مشايخ محددين مرتبطين مباشرة بالمتسلم ومعفيين من التحصيل لأنهم محصنين في جبال نائية .
" ثم ينتقل أوغست أندريا إلى الحديث عن متسلمية اللآ ذقية لينتهي بخلاصة للمذكرة تقول:"
يستنتج من هذه اللمحة العامة أن عدد سكان باشوية طرابلس (بما فيه إقليم اللاذقية) 267,490 نسمة وأ ن واردات الباشوية 1100 كيس تقريبا . ويمكن القول أنه لو توفرت أدارة أحسن وأعدل لزادت الواردات بما لا يقاس دون أن تثير غضب العامة .
التوقيع
أوغست أندريا
عادل إسماعيل – وثائق دبلوماسية وقنصلية – م4 – ص 357/379
ترجمة عبد اللطيف كرّيم