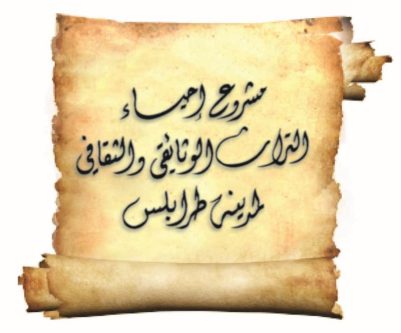| فهرس المقال |
|---|
| البحث الأول: الحراك الفكري في طرابلس أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرينأ. مارون عيسى الخوري |
| البحث الثاني: لطف الله خلاط، الأهل والمدينةد. عاطف عطية |
| البحث الثالث: غريغوريوس حداد، نموذج فريد في العيش الإسلامي المسيحيالأب ابراهيم سروج |
| البحث الرابع: رشيد رضا والمسألة العربيةد. أنيس الأبيض |
| مناقشات الجلسة الرابعة |
الجلسة الرابعة ترأسها الدكتور فريدريك معتوق عميد معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية وجاء في كلمته:
أيها الحضور الكريم أيها الزملاء أيها الطلاب الكرام ،
سأركز كلمتي المختصرة على الجانب الأكاديمي من المشروع الذي سينطلق اعتبارا من هذا المؤتمر في إحياء التراث الثقافي والوثائقي لمدينة طرابلس .
وثائق المحكمة الشرعية كما هو مدون في الكراس وثائق هامة جدا تعود الى العام 1666 م 1077 هجري ، وهذه الوثائق تضم 300 الف قضية موزعة على أكثر من 100 سجل مختلف ، حفظت هذه السجلات في العهد العثماني حفظا لائقا ثم بعد ذلك في عهد الانتداب الفرنسي حفظت أيضا في المحكمة الشرعية في مدينة طرابلس
، ولكن عندما بدأت الحرب عام 1975 أتى عليها بعض العبث سنة 1976 ، إلا انه عام 1982 اتاني الدكتور خالد زيادة وقال لي : يقال ان الاجتياح الإسرائيلي الذي وصل الى بيروت سيصل الى طرابلس ويبدو ان الاجتياح الاسرائيلي قد دمر سجلات المحكمة الشرعية في صيدا ، فعلينا ان نحافظ على سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس ، فدب فينا "الدكتور عمر تدمري وخالد زيادة وانا" دبت فينا الهمة وعملنا مباشرة على تصوير جميع السجلات والتي كانت 300 الف وثيقة يدوياً لمدة شهر ونصف في مكتب الأستاذ رشيد جمالي رئيس بلدية طرابلس الذي كان مسؤولاً عن مكتب "أوليبتي" ، فاشترينا كجامعة آلة التصوير وآلة "دراونز" والورق والحبر وصورنا ، ثم جلدنا ، حتى ان بعض الوثائق جلدتها في بيتي انا ، كل ذلك يعني ان المشروع ليس مشروعا محصورا فقط بالطرابلسيين إنه مشروع يعنينا كلنا في الشمال ، ولذلك سيكتب لهذا المشروع النجاح ، وقد طبع السجل الأول في مطابع الإنشاء عام 1982 ولا زال موجود، واشتهر عبر العالم العربي وجاءتنا تنويهات من شتى البلدان العربية على هذا المشروع ، لماذا؟ ، لان محتويات الدعاوى والقضايا المدونة في سجلات المحكمة الشرعية هي ذات بعد إسلامي عربي لبناني وطني وقومي ولذلك لا يجوز لأحد أن يستأثر بها لنفسه ، فهي وثائق وطنية وعلى هذا الأساس تعاملت معها الجامعة اللبنانية واحتضنتها ، صورنا نسخة وضعناها في مكتبة العلوم الاجتماعية وأخرى في مكتبة الآداب واشتغل العديد من طلاب الجامعة اللبنانية ، على هذا الأساس بادر الدكتور خالد زيادة إلى تأليف كتابين في هذا الصدد ، الأول هو كتاب الصورة التقليدية للمجتمع المديني انطلاقا من سجلات المحكمة الشرعية المطبوع عام 1983 وها قد طبع منذ ثلاثة أشهر هذا الكتاب مجددا في مصر في منشورات وزارة الثقافة المصرية وهذا شرف كبير لمعهد العلوم الاجتماعية في الشمال وأيضا ألف كتابا ثانيا هو "أركيولوجيا المصطلح الوثائقي" عام 1986 حيث هناك شرح لجميع المفردات التي يحتاج إليها الباحث في المؤلفات ، مثل البيك ، والمير والأقجا وجميع المصطلحات التي ترد في السجلات، كذلك فعل الدكتور عبد الغني عماد عندما اصدر رسالته الأولى استنادا إلى السجلات بعنوان " الجهاز الديني والعائلات الدينية في طرابلس " عام 1985ثم اتبعها بكتابه الهام " السلطة في بلاد الشام " استنادا الى وثائق وسجلات طرابلس ودمشق وحلب العام 1990من هنا جاءت فكرة ان الوثائق تتضمن تاريخ المدينة وتاريخ لبنان، وانه علينا ان نستثمر هذا الوثائق وانه لا ينبغي التعامل معها ككنز نخبئه ، بل نتعامل معه كرأس مال ينبغي ان نستثمره ، وهذه الفكرة التي بلورها الدكتور خالد زيادة التي نظر لها في كتابه الأول ومنهج لها في كتابه الثاني هي نفسها التي ينتقل مشعلها اليوم الى الدكتور عبد الغني عماد ويتابع حاليا في موضوع يرى هو نفسه أهمية أكاديمية له وأهمية ثقافية ووطنية .
أحببت ان أوضح هذه المسائل لأن تأصيل الفكرة ضروري عند المنعطفات ، وأعتبر ان وثائق المحكمة الشرعية بين أيد أمينة حالياً وهي ستشهد حياة جديدة على يد المركز الثقافي للحوار والدراسات فنهنئ هذا المركز الجديد .
وأمامكم كوكبة من الباحثين ليلقوا الضوء على مدينة طرابلس
الحراك الفكريّ في طرابلس أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين
مارون عيسى الخوري
- باحث -
لم تتضّح، حتّى الساعة، تفاصيل الزّمن العثمانيّ في طرابلس على نحوٍ قريب من التّمام، فالذين كتبوا عنها، لبنانيين وعرباً وأجانب، رسموا لها صورة متفاوتة الألوان، مهتزّة القسمات، تسود فرشاة بعضهم خفّة ورشاقة وفرح، وتغشى فرشاة بعضهم الآخر غاشية الثّقل والتربّد والاكتئاب، الأمر الذي يحمل الرّائي إليها على التّظنّن في تفسير خطّ تفحّم لونُهُ، وخطّ آخر تورّد صبغُهُ، وخطّ ثالث لم يستوفِ حقّه في إتمام غرضه من الصّورة؛ وكلّ هذه الخطوط على تباين مناحيها، تسعى إلى تقديم مجسّم سياسيّ أو دينيّ في الغالب على حساب الإجتماعيّ والإقتصاديّ، في الوقت الذي نحاول فيه التماس الجوانب الفكريّة في الزّمن الأخير من الحضور العثمانيّ. وهذا لا يعني بالضرورة عزوفنا عن الأخذ بناصية ما له صلة بالسياسة والإجتماع والإقتصاد بقدر، فهذه مداميك لا محيص للباحث عنها في تشييد البناء الفكريّ، حجراً من هنا، وحجراً من هناك، حتّى يرتفع على النحو الذي كان عليه تقريباً، وليس على ما كنّا نتمناه أو ننشده. ولقد اعتدنا أن نجمع مؤونتنا للبناء من مراجع تدور حولها شبهات، أو من مصادر مدانة بالانحياز، بمعنى أنّه طغى على الأولى من الإسقاط الذاتيّ ما جعل الموضوعيّ فيها غائباً كلّه أو جلّه، كما طغى على الثانية منها تغليب المصلحة السياسيّة لا سيّما إذا كانت من عمل قنصلٍ ما مثلاً يرصد ما يجري بعين احتشدت فيها رغبة ما يريد، لا حقيقة ما هو قائم. والحقيقة، إنّ استبعاد الموضوعيّ ههنا في حدود ما، وتغليب الذاتيّ عليه أحياناً بقدر يزيد أو ينقص، عائدان إلى قربنا من الحدث؛ فالعصور العثمانيّة الأخيرة ليست ممّا ينتسبُ إلى عصور ما قبل التاريخ حتّى نتكهّن حوادثها أو نضرب بالحصى لاستنبائها، بل هي على مرمى حجرٍ منّا، ذاق فيها جدودنا وآباؤنا صنوفاً من العذاب والمهانة والقهر، والفتك والتجهيل والفقر، ما لا قِيل لأحد المياسير أن يتفهّمه ويتحمّله. ولكن، من باب التجرّد في قول الحقّ، لا نقدر البتّة إلاّ على الاعتراف بأنّ سماء تلك العصور لم تكن بالكامل فضاءً مسكوناً بالقَيْمِ الأسود، والرّعد القاصف، والبرق الراعب، فقد كان لصفاء الجوّ أحياناً وانقشاع الغيم، وسطوع الشمس، ما يجعل المواطن يستبشر خيراً بعد عنتِ الأحوال وقسوتها عليه. ولأنّ العصر العثمانيّ الأخير صار في متناول اليد بسجلاّته الشرعيّة ودفاتره الرسميّة الهاجعة في استانبول (دفتر طابو)، سهل علينا العودة إليها لتغطية الجوانب السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة تغطية مُطمئنة؛ أمّا النّواحي الفكريّة فلنا في نصوص كتّابها ما يُغنينا عن الرّجم بالغيب، خصوصاً ونحن نركّز على مدينة واحدة في عصر، وليس على دولة متّسعة في دهر. ولكن قبل أن أرفع مرساتي لأبحر إلى شاطىء المدينة التي يُرفأ فيه هذا المسعى، تحدوني طبيعة هذا المؤتمر أن ألتفت إلى حدثين قرأتُهُما في ذمام مطالعاتي المستمرّة لعصر اليقظة العربيّة الذي بدأ مسارُهُ في وقت كانت الشيخوخة والمحن فيه قد أنهكت الجسد العثمانيّ. الحدث الأوّل يشير إلى الحضور المسيحي المبكّر في المدينة والذي يُعتبر استمراراً وتواصلاً لديمومة من جبلّتهِ، كان يتوهّجُ حيناً ويخبو ضوءُه أحياناً على حسب ما كانت تتمخّض عنه الظروف السياسيّة والاقتصادية في سلبيّاتها وإيجابيّاتها، وقد استُمدّ مضمونُهُ من دراسة تعتمدُ على جملة سجلاّت من دفتر طابو في استانبول وضعها الباحث رالف هاتوكس RALPH HATOX بالانكليزيّة في مجلّة الأبحاث الصادرة عن الجامعة الأميركيّة في بيروت بعنوان: طرابلس في القرن السادس عشر، وقد نقلتها إلى العربيّة ونشرتها تباعاً في جريدة صوت الفيحاء عام 1991.
أمّا الحدث الثاني، فاستقيتهُ من مخطوط قديم يعود زمنه إلى ما يزيد على مئتين وخمسين عاماً، يحمل أخباراً تتّصل بالكنيسة الأرثوذوكسيّة الإنطاكية وقعتُ عليه في أحد الدُّيورة الكسروانيّة، وفيه خبر مُفاجيء عن سينودس أرثوذوكسيّ عُقِد في طرابلس خلال شهر أيّار سنة 1680، أي بعد وقوع الحدَث الأوّل بمئة واثنتين وستين سنة، ممّا يعني أنّ الدولة العليّة كانت حتّى زمنها الثاني متسامحةً مع الروم الأرثوذوكس تحديداً، في ممارسة شعائرهم الدينيّة، وعقدِ مؤتمراتهم أنّى شاءوا من حواضرهم العثمانيّة.
الحدثُ الأوّل
ممّا تعترف به دراسة هاتوكس، وهي في الأصل معقودة اللواء على طرابلس من الناحية الإقتصاديّة، بأنّ الإسلام وجب أن يكون غلب على المدينة غلبةً بييّنة ما يقرب من نصف قرن من الحضور العثمانيّ الذي امتدّ ظلّه أربعة قرون ويزيد. وكانت ديموغرافيا المدينة تشير، في إحصاء متسرّع أجري في أعقاب الاندحار المملوكيّ بقليل إلى أنّ فيها 2047 أسرة و 147 عازباً و 12 رجل دين، وقُدّر مجموع سكّانها بـ 12528 نسمة ، وهو إحصاء أوليّ أظهرت تفاصيله أنّ عدد المسلمين والمسيحيين واليهود كان مرتفعاً. إلاّ أنّه في سنة 1525 – 26، تمكّنت إدارة ثانية من القيام بإحصاء أكثر دقّة وجديّة، آملةً بأن يضمّ أعداد الذين هربوا خلال فترة الإحصاء الأوّل، وكان الصراع المملوكيّ العثمانيّ في خواتيمه، والتجأوا إلى مراكز سلطة محليّة أخرى، أو احتموا ببعض العوائل في الريف وكان بوسعهم أن يعودوا على نحوٍ تدريجيّ؛ وتوحي الزيادة المرتفعة للسكّان اليهود، في فترة قصيرة جداً، بهجرة لهم من مكانٍ ما. إلاّ أنّه – بين جداول الدفتر العائد إلى سنة 1525 – 26، والتقدير اللاحق الذي تمّ وضعه في سنة 1575، نجد أنّ طرابلس قد عانت من هبوط دراميّ، إذ خسرت من مجموع سكّانها ما نسبته 38%، على غرار ما حصل في بقيّة أنحاء سوريّة وفلسطين، وإن بقدرٍ أقلّ. ففي حين هبطَ عدد السكان المسلمين هبوطاً حادّاً 51% تدنّى كذلك عدد السكان اليهود حوالي 18%، بينما تابع السكان المسيحيون ارتفاعهم العدديّ في الفترة نفسها، وليس ثمّة تفسير مرضٍ بالكليّة لمثل هذه الظاهرة. أتُراه حصل ذلك بسبب ارتال الجراد التي رومّتِ المحاصيل، أم بسبب النّقص في الغذاء وغلاء الأسعار اللذين ضربا المدينة سنة 1525؟ فضلاً عمّا كان لرغبة العثمانيين عن الأمراء المحلّيين من الأثر الكبير في إطلاق يدهم في المنطقة، إذ شرعوا يتعاملون مع الزعماء والشعب تعاملاً مزاجيّاً، ممّا أسهم، إلى حدّ كبير، في خلق حالة تقلقل سياسيّ ساد المنطقة كلّها قبيل سنة 1541 ... وربّما كان هذا كلّه مجتمعاً هو ما أكرَهَ كثيراً من المسلمين على الهجرة من جديد والاحتماء بالعوائل المقيمة بالأماكن الخلفيّة التي تسيطر عليها سيطرة شبه تامّة، فغادروا المدينة تباعاً، وهو أمر كانوا قادرين عليه أمام حوادث كهذه، وإلاّ كيف يمكننا أن نفسّر الارتفاع المستمرّ في عدد السكّان المسيحيين ونعلّل تدنّي عدد اليهود الذين كانت فرصهم في العثور على مكان آمن أمراً مشكوكاً به جدّاً؟ إنّ اختفاء قسم كبير من السكّان قضيّة تنتظر المزيد من البحث ... وكان نتيجة ذلك كلّه تغييراً ديموغرافيّاً لمصلحة المسيحيين استمرّ خمسين عاماً (1525 – 1575). وبعد هذا التاريخ بدأ يعود إلى المدينة كثير ممّن تركوها، كما تدفّق عليها كثير من الأسر الحورانيّة والمصريّة والمغربيّة، فضلاً عمّن تَديّرَها لاحقاً من اليونان لأسباب تجاريّة.
الحَدَث الثاني
يتعلّق بسينودس طرابلس الأرثوذوكسيّ الذي انعقد في المدينة عام 1680. يومذاك أفضت الأحداث المتعاقبة لاحقاً، إلى قيام بطريركيّة إنطاكيّة طغى عليها لونان: واحد محافظ على التقليد القديم، ضنينٌ بإرث الأرثوذوكسيّة كما ورثه إبّان عهد الإنقسام ... وآخر متشبّث بدوره بالتقليد الأرثوذوكسيّ نفسه، على أنّه متمسّك في آنٍ معاً بوحدته مع الكنيسة الرومانيّة. وكان على البطاركة الأنطاكيين أن يكونوا في الغالب واحداً للكلّ من غير تمييز أو تفضيل، لأنّهم كانوا – على تمسّكهم التقليديّ – على علاقة بالفكر المسكونيّ عبر المرسلين اللاتين الذين اتّخذوا، باديء ذي بَدءٍ، حَلب قاعدة عملهم، ونقطة انتشار رسالتهم في البطريركيّة الإنطاكيّة على وجه التّحديد. والحقّ إنّ هؤلاء البطاركة هيّأوا من خلال وسطيّتهم مناخاً يسمح لجمهرة الأساقفة والكهنة بأن يعلنوا كاثوليكيّتهم على سنّ الرّمح، أو أن يعلن من يشاء منهم أرثوذكسيته بالجهر ويخفي كاثوليكيّـه بالتقيّة، خوفاً على نفسه من الهلاك، واتّقاءً لشرّ مستطير كان يترصّده على غير موعد ... ويُعتبر الزمن الممتدّ من سنة 1680 حتّى 1724 زمناً تواصى فيه الأرثوذوكس الكاثوليك على إعلان عقيدتهم الوحدويّة، فعَقَد اساقفتهم مجمعاً في طرابلس ضمّ كلاًّ من:
1- مكاريوس، مطران طرابلس
2- سلفستروس دهّان، مطران بيروت
3- أغابيوس، مطران صيدا وصور.
4- أفثيميوس، مطران حمص.
5- برثانيوس، مطران بعلبك.
وكانت غايتهم من هذا السينودس (وهو واحد من المجامع التي التأمت منذ جاهر فوتيوس بالعصيان على المجمع الفلورنتينيّ المنعقد عام 1439 لأجل اتّحاد الكنيستين) اتّخاذ أكثر الوسائط موافقةً لتأكيد الإيمان الكاثوليكيّ، وذلك بطلب من البطريرك كيرلّس الزّعيم الذي أحجم عن حضور المجمع المشار إليه خوفاً من الأرصاد والأعين التي تترقّبه من قِيل خصومه الذين انتخبوا لاحقاً أثناسيوس الدبّاس بطريركاً خصيماً سنة 1688. وكان كيرلّس رجُلاً إمّعة، أي متقلّب الرأي، يهمس في أذُن الأرثوذوكس قائلاً: أنا أرثوذوكسيّ؛ وفي أذن الكاثوليك قائلاً: أنا كاثوليكيّ. والواقع، إنّ قرارات المجمع ظلّت في منأىً عن الإعلان، وإنّ تدوينها قد عبثت به الأيام. على أنّ هذا لا يمنع في شيء من استقراء الدلالات التالية:
1- إنّ مكاريوس مطران طرابلس كان كاثوليكيّ النِّحلةِ، وأنّ قاعدته الوحدويّة في المدينة كانت واسعة وذات شأن، وإلاّ لما أمكنه أن يستضيف مؤتمراً فيها، لا سيّما والمدينة يومذاك قاعدة ولاية هامّة من الولايات العثمانيّة في بلاد الشام.
2- إنّ الوالي العثمانيّ في المدينة محمّد باشا، سمح بانعقاد المجمع المسيحيّ، لأنّه لم يلمس أيّ امتعاض أو تذمّر من قِبل روم المدينة أو روم القرى اللائذة بها.
3- إنّ رهبان البلمند الذي تجدّد عام 1602، وتجدّدَت فيه الحياة الرهبانيّة، والقائم على كتف المدينة إلى الجنوب، لم يكونوا بمعزلٍ عمّا كان يدور أمامهم من تحوّلات، فلم يُبْدُوا أي اعتراض أو استنكار؛ ولن ننسى أنّ بعض رهبان هذا الدير الحلبيين كوّنوا النوّاة الأولى لنشأة الرهبنة الباسيليّة الشويرية بفرعيها البلديّ والحلبي بعد عقدين من الزمن.
4- إنّ خطّاً وهميّاً نمِدّهُ من طرابلس إلى بيروت، فصيدا وصور، ومن ثمّ إلى بعلبك فحمص، على إختلاف في الاتّجاه، يدلّ على أنّ الساحل اللبناني كلّه، كان مزروعاً بالأرثوذوكس الكاثوليك على نحوٍ لافت للنّظر، فضلاً عن حلب التي شكّل كاثوليكيوها الحجر الأساس في الانتفاض.
ولئلا لا نكون في موقع الانحياز لهذا المجمع الذي سكتت عنه المصادر الأرثوذوكسيّة ولم تُعرهُ أيّ اهتمام في كتاباتها، يحقّ للباحث أن يسأل: لماذا انعقد هذا المؤتمر في زمن متقدّم نسبيّاً؟ ولمَ كان انعقاده في طرابلس بالذات؟ ألا يعني ذلك أنّ السلطات العثمانيّة في الآستانة – وهذا مجرّد احتمال - غضّت الطرف عمداً عن هذه القضيّة، وعمّا كان يجري بين الحين والحين من امتعاض عند روم الكرسي الإنطاكيّ خاصّةً، لتحرج الكرسي القسطنطينيّ الذي ميّزته ورأّسته على كلّ الكنائس الروميّة الأرثوذوكسيّة في المملكة الواسعة الأطراف، وتظهر سوء بلائه في معالجة موضوع من اختصاصه، وعن تشريفه برعاية لا يستحقّها، فيكون لمعاقبته، عندئذٍ ، مبرّرٌ مقنع أمام الروم جميعاً؟! أمّا مسلمو المدينة فقد اطّرحوا التدخّل في شأن خاصّ لا يعنيهم، وآثروا الحياد على تعكير صفو العيش الواحد مع مواطنيهم، فلم يفسدوا على المجتمعين مؤتمرهم بالتعدّي، بحجّة أنّه سينودس مسيحيّ الهويّة، ويُعقدُ في مدينة تمثّل قاعدتها أكثرية مسلمة؛ ويؤكّد هذا الموقف الرّاقي أنّ مفهوم التعايش معاً والاعتراف بالآخر ليسا جديدين ولا عابرين في هذه المدينة، وإذا شابتهما في بعض الأحايين شائبة، فبِدسّ أجنبيّ نفثَ سمّه في عقل مريض، لقد ظلاّ على البقاء أقوى من السّم والجنون.
***************
آثرتُ في بحثي عن الحراك الفكريّ في طرابلس صرف النظر عن خمس شخصيات أعتبرها من ألمع رجالات المدينة فكراً، وأغزرها عطاءً، وأثقبها عقلاً، بسبب نزوحها عن طرابلس التي ضاقت رقعتها بقاماتها السامقة.
وأوّل هؤلاء الأربعة الرجال: الشيخ إبراهيم الأحدب (1829 – 1891) واضع كتاب: كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزّمان، وكتاب فرائد اللآل في مجمع الأمثال، وثلاثة دواوين شعريّة، وغير ذلك؛
والثاني هو سليم دي نوفل (1825 – 1902) الذي غادرنا إلى روسيّة، وتقلّد مناصب في الدّولة هناك، وعلّم العربيّة في جامعة بطرسبورج، وأعماله بالفرنسيّة تفوق في أهميّتها ما وضعه بالعربيّة، منها: مطابقة الدين الإسلاميّ للمدنيّة الحقيقيّة، النّسل والطلاق في الإسلام، وسيرة الرسول، والزّواج في الإسلام، والملكيّة في الإسلام ... وسواها. والثالث هو فرح أنطون (1874 – 1922) أحد أكبر المفكّرين في الشرق ريادةً، وأجرأهم مصاولةً، وأشدهم اندفاعاً في طرح الفكر العلمانيّ، وإجلال العلم والعقل، ويكفيه فخراً على أرجحيّة العقل عنده كتابه: ابن رشد وفلسفته.
والثالث هو الإمام الشيخ محمّد رشيد رضا (1865 – 1935)، صاحب المنار: مجلة الدّعوة والإرشاد والدفاع عن الإسلام عقيدة ومنهجاً، ومؤلّف الوحي المحمديّ: دين الأخوّة والانسانيّة.
وأمّا الخامس فالشيخ عبد القادر المغربيّ (1868 – 1956)، تلميذ الشيخ حسين الجسر، وأحد علماء اللغة الكبار؛ أسهم في تأسيس المجمع العلميّ العربيّ في دمشق، ثم تولّى نيابة رئاسته فرئاسته. كان عضواً في مجمع اللغة العربيّة في القاهرة، وله على صفحات مجلّتيهما بحوث ماتعة يطبعها عمق النظرة والجدّية والطّرافة. كما أنّي، من جهة أخرى، أقصيتُ الشّعر عن البحث حتّى لا أثقل ما أنا ماضٍ في سبيله بما لا يقوى على احتماله.
********************
أطلّ عصر الأنوار على الفيحاء متلازماً، في حدودٍ ما، مع إطلالته على القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد، فأفاض الحياة في المدينة، بعْد ما يشبه المُحل الذي كاد يغطّي على دار العلم وتوهّجها في العصر الوسيط ... وعلى هذا، فإنّ ما أسميناه الحراك الفكريّ الذي احتدّ أُوارُهُ لم يأتٍ من فراغ، وإنّما كانت بُؤرُه التي فتَرَت، موزّعةً في محيط المساجد والجوامع منذ عهد بعيد يرقى إلى عصر المماليك. ولستُ أعتقدُ أنّ مدينةً وصل فيها عدد هذه البُؤر التعليميّة على مساحة العالم الإسلاميّ، وبالقياس إلى حجم المدينة، إلى ما بلغتهُ طرابلس، إذ تجاوز عدد المدارس فيها ثلاثمئة مدرسة، تعطّل، على توالي الحِقب، معظمها، واستمرّ بضع عشرة مدرسة منها تتابع سيرتها الأولى في التّعليم. ومن البديهيّ أن نفهم من ذلك حقيقتين: الأولى، عراقة المدينة في انتسابها إلى العلم؛ والثانية، فتورها في بعض الزّمن العثمانيّ عن التألّق، حتّى كادت أن تتساوى بسبب الانحطاط بأيّة مدينة عاديّة. ولكنّ التميّز في الإقبال على التّحصيل في مدارسها عاد إلى نشاطه وفعاليّته؛ وما القرطائيّة والسّقرقيّة والخاتونيّة وخيريّة حُسْن والرّفاعيّة والنّوريّة ... وما اندثر منها وما بقي، بِناسِيَةٍ أشياخها وطلبة العلم فيها، فأطيافهم لم تزلْ تطوف جدرانها وأجواءَها وتنضحها بفيض من عبَق العلم والقداسة ... وكذلك، لم تكن دور العبادة مَفَاءَةً للصلاة فحسب، بل كانت، في الوقت نفسه، موائل للعلم والمعرفة، يتحلّق حول أشياخها الطلاّب ويأخذون ألواناً من المعارف الدينيّة والفقهيّة واللغويّة أخذاً يتّسم بالشوق والحرارة. أمّا الطلاّب المسيحيّون فكانوا يفيئون إلى مدارس بسيطة غلب عليها طابع القَصد أو الارتجال في اختيار مواقعها، تتألّف الواحدة منها – على ضآلة عددها – من غرفة كبيرة أو غرفتين، على الأكثر، بجوار كنيسة، أو في الحيّ الذي يكثر فيه المسيحيّون، وتسود البدائيّةُ طُرُق التدريس فيها، يقوم على تعليم الصّبيةِ مباديء القراءة والكتابة والخطّ والحساب وخَتْم بعض المزامير معلّمٌ، حظّه من العلم لا يتجاوز حدود ما يلقّنه تلاميذه كثيراً ... وبإزاء هذه المدارس وتلك، لم يكن للتّعليم الرسميّ في المدينة وجود قبل ولادة نظام المعارف الصادر في 24 جمادي الأولى 1286 هـ / 1869 م؛ وقد خصّ هذا النّظام الدراسة بخمس مراحل هي: المرحلة الإبتدائيّة فالرشديّة فالإعداديّة فالسلطانيّة فالمدارس العالية. وقد عرفت المدينة تباعاً بعض هذه المدارس، باستثناء المدارس العالية التي كانت تشمل داري المعلّمين والمعلّمات ودار الفنون في استامبول، ومكاتب الفنون والصّنائع المختلفة. وكان حظّ طرابلس من نتائج الطلاّب الذين درسوا في هذه المدارس ضئيلاً جدّاً لقِصر عمرها الذي لم يتجاوز في المدينة أكثر من ثلاثة عقود إلاّ قليلاً ... لذلك أنت ترى إنّه بمثل هذه العدّة لا تقوم يقظة لتكون منطلقاً للنهوض؛ ذلك لأنّ مؤونة المسلمين العلميّة تقليديّة، وأنّ مجاورة بعضهم الأزهر تشبه في حصائلها منْ قصَد العَيْن ليتروّى، فلمّا مَلأ كوبهُ منها وشرب اكتشف طعم مائها آسناً، فتلمّظ طويلاً ثمّ قال: اللهمّ إنّي ارتويت. فالأزهر يومذاك لم يكن أكثر من قفير تمتصّ نحلاته ما صينَ من ثمر اللغة والفقه وبعض ما أصبح هَمَلاً من علوم الأوائل، فلا جبر ولا هندسة ولا فيزياء ولا كيمياء، ولا مجرد تفكير في إطلالة على علوم العصر ومخترعاته واكتشافاته ... ولمحمّد عبده نضال مرّ من أجل إصلاح هذه المؤسسة العلميّة ذهب أدراج الرّياح أمام صمود الأزاهرة وعتَتِهم وتشبثهم بما هو قائم ... ومؤونة المسيحيين العلميّة ساذجة ضحلة لا يُعتدّ بها، إزاء "اليُسر العلميّ الإسلاميّ" الذي كان ييسّر لصاحبه وظيفة إمام أو خطيب في جامع أو منصب واعظ أو مُفتٍ أو مدرّس، أو أيّ مركز في الجهاز الدينيّ ... يبقى أنّ الذين درسوا في المدارس الرسميّة، فإنّهم – على قلّتهم – كانوا يعملون مدرّسين ونظّاراً أو مديرين في المدارس الرسميّة، ودَخَل بعضهم المدارس الحربيّة في الآستانة، وتخرّج منها، واستقرّ ضابطاً في الجيش ترْقى به أهليته وإخلاصه إلى مراتب الترفّع العالية ... لكنّ جُماع هؤلاء بلا استثناء – مسلمين ومسيحيين ومتخرجيّ مدارس رسمية – كانوا أوهى في زحفهم السلحفائيّ إلى الغد من الأرنب في وثباتها وقفزاتها، بل لنقُل إنّه لم يكن لهم شأنٌ بالتطلّع إلى الحاضر البائس للبحث فيه، ولا إلى القادم من الزمن المشرق هناك والاسترشاد بأنواره منهجاً، والتنعّم بأوكسيجينه نفساً. وبكلامً آخر: إنّ "محصولهم العلميّ" مغلقٌ على نفسه، يتردّد ولا يتعدّد، ويتكرّر في موضوعاته ولا يتجدّد، حاله شبيهةٌ بحال المريض الزّمِن المحتاج إلى دمٍ جديد، فخدعته تلك المؤسسات حين راحت تسحب من وريد يده اليمنى ليتراً من الدم لتضخّه في وريد اليد اليسرى.
ولم يكن ثَمّة حلّ إلاّ بفتح نوافذنا على العالم ليدخل الهواء والشّمس إلى بيوتنا الغاصّة بثاني أوكسيد الكربون؛ كما أنّه ما كان سهلاً قطّ على علماء مدينة يعيشون على سمعةِ مكتبة بني عمّار، وإرث الفقه من جهة، وتقاليد التصوّف من جهة أخرى أنْ يتخلّوا عن تراث اعتقدوه كلّه نعمةً وبَرَكَةً، ناسين أنّ الذي نحملُهُ في دواخلنا ممزوج تِبْرُهُ بالتّراب، وأنّ غربلته من القذَى وَغَثيثهِ صونٌ له من الضّياع، وأنّ في بثّ روح العصر فيه استمراراً وبقاءً. وانقسم القوم بين مُدبرٍ إلى الماضي ويَبَاسِهِ، ومُقبلٍ على الآتي بحذرٍ ووجلٍ وخفَرٍ لا يشارك في صُنْعهِ لملكَةٍ أحكمتْ تقييد حركته، ولكنّها غَبَطَتْهُ حين سمحتْ لسِواهُ بأنْ يركب ريح العصر في هبوبها، ونستثني من هذه الطبقة الشيخ حسين الجسر الذي لم يكن بحاجةٍ إلى غبطة أحدٍ ورضاه في عرض مشروع خاصّ بهٍ بدأت تفاصيله تتوالى بلا هوادة، وسنعود إليه في سياق هذا البحث. كانت الريح قد شَرَعتْ بالتحرّك وئيداً من زمن غير يسير، وكانت تجمُّعها في أفق المدينة قد تباطَأ لأسباب شتّى، أهمّها السلبيّة التي وُوجهتْ بها. ويمكننا أن نذكر ثلاثة تيارات على الأقلّ، تجمّعت في طيّاتها هذه الريح:
1: آ- اتّصال الشرق بالغرب عن طريق التبادل التّجاريّ بين المدينة وأوروبة، ولطرابلس تاريخ عريق في تجارتها مع بعض المدن الساحليّة في إيطالية وفرنسة منذ عهد المماليك وما قبل.
1: ب- السلك القنصليّ، وكان لفرنسة وانكلترا وإيطالية والروسيّا وغيرها مقارّ دائمة تُؤمّن مصالح بلادها السياسيّة والتجاريّة مع المدينة والداخل السوريّ.
2: آ- والاتّصال الثاني تمثّل في سياحة الغربيين في المنطقة، بما فيها طرابلس، وهم كُثُرٌ نكتفي بذكر واحد منهم قصدَ المدينة ومكثَ فيها بعض الوقت وزار بعض أعيانها وسجّل انطباعه عن بعضهم، وهو لامارتين في كتابه: "رحلة إلى الشرق 1832 – 1833" ALPHONSE DE LAMARTINE: VOYAGE EN ORIENT 1832 – 1833
قال في زيارة لطرابلس يوم كانت حملة إبراهيم باشا في عزّها: ... وعلى مَبْعَدَةِ عُقْدَةٍ من المدينةِ التَقيْنا رَكْبَاً مِنْ تُجّارِ الإفْرَنْجِ الشّبابِ المؤلّفِ مِنْ جِنْسيّاتٍ مُخْتلِفَةِ وبَعْضِ ضُبّاطٍ منْ جَيْشِ إبْراهيم هُرِعُوا لِمُواجَهَتِنا، وَكَانَ بَيْنَ هؤلاءِ نَجْلُ السّيّدِ لُومْبَارْد LOMBARD التّاجِرِ الفَرَنْسيّ الذي يَسْكُنُ المدينَةَ، وقَدْ جاءَ باسْمْ وَالِدِهِ يَدْعُونا لِلْحُلُولِ عِنْدَهُ، وَلكِنّنا خَشَيْنا أنْ نُثْقِلَ عَلَيْهِ، فَتَوَجّهْنا إلى دَيْرِ الآبَاءِ الفرَنْسِيسكانيّينَ الذي كانَ يَسْكُنُهُ رَاهِبٌ وَاحِدٌ لا غيْر، وحَلَلْنَا في هذا المَسْكنِ المُتّسِعِ. وبعْد انْقِضاءِ يَوْمَيْنِ تَنَاولْنا الطّعامَ عِنْدَ السّيّدِ لُومْبَارْد، وَلَكَمْ يَسْعَدُ المَرْءُ حِيْنَ يَلْتَقي عائلَةً منْ بلَدهِ، وَيَلْقَى عنْدَها استِقْبالاً حارّاً. وفي المساءِ قضيْنا ساعَةُ في زيارةِ السّيّد والسيّدةِ كاتْسفْليس، وكان الرّجُلُ تاجراً منْ أصْلٍ يونانيٍّ، شغَلَ مَنْصِبَ قُنْصُلِ روسِيّة في المدينَةِ؛ وتَعودُ سُكْنى العائِلةِ في طرابُلُس الشّام إلى عهْدٍ بعيدٍ حيْثُ تمْلَكُ فيها قصراً بديعاً. وكانتِ السّيّدةُ كاتْسَفليس وبِنْتاها أشهَرَ نِساءِ بِلادِ الشّام جَمَالاً ورُقيّ سُلُوك، وهُنّ مزيجٌ يجْمَعُ الذّخْرَ الآسْيوِيّ والعَفْوِيّةَ الأنيقَةَ في النّساءِ الإغريقيّاتِ والتّهْذيبَ الكامِلَ لأكْثرِ الإناثِ أناقَةً في أُوروبَةَ. اسْتقْبَلُونا في بَهْوٍ معْقودٍ رَحْبٍ تُضيئُهُ قُبّة، وَيُشيعُ البُرودةَ فيهِ حوْضٌ يَجْري المَاءُ فيهِ بِلا انْقِطاعٍ. جَلسَتِ الأمُّ وَبنْتاهَا على دِيوانٍ نِصْفِ دائرِيٍّ يُطِلُّ عَلى عُمْقِ القاعَةِ. كُلُّ شَيْءٍ كانَ مُغَطّىً بالسّجادِ الفَاخِرِ، وعَلَى مِثْلِ هَذَا السّجَّادِ كانَتْ تَنْتَصِبُ النّارجيلاتُ والغَلاَيينُ، وَعلَى مَقْرُبَهٍ مِنْهَا إنَاءٌ مِنَ الزَّهْرِ وإبْريقٌ مِنْ عَصيرِ الفَاكِهَةِ. وَكانَتِ النِّسْوَةُ الثّلاَثُ المُرْتَدِيَاتُ الزِّيَّ الشَّرْقيَّ، تَحْمِلُ الوَاحِدَةُ مِنْهُنَّ، بِسِحْرِ جَمَالِها، صَفْوَةَ أَبْهَى المَزَايا التي يُمْكِنُ لِنَظَر رَجُلٍ أَنْ يَقَعَ عَلَيْها. وهَكذا قَضَيْنَا سَهْرَةً لَطيفَةٌ يتَخلَّلَها حَديثٌ مَاتِعٌ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا عَلَى أمَلِ اللِقاءِ في طَريقِ العَوْدَةِ.
3: آ- وأمّا الاتّصال الثّالثُ فكان من خلال المدرسةِ الحديثةِ بِبرامجِها العلميّة واللغويّةِ وطرائق تدريسها التي تميّزت بها المدارس الإرساليّة الأجنبيّة، إلى جانبها مدرستان وطنيّتان عصريّتان، فَعَلَتْ مُجْتمِعةً في مدىً قصير فِعْلَ المُعجزة. والحقّ أنّ الحضور الإرساليّ كان قديماً في المدينة؛ فابتداءً بسنة 1629، أي بعد دخولنا في حكم الترك العثمانيين ب 112 سنة ليس غير، هبط الآباء الكبُّوشيّون LES CAPUCINS في الفيحاء وابتنوا لهم ديراً بمحاذاة الجامع الحميديّ في حيّ الزّاهريّة، يحملون الإنجيل بيدٍ لردّ أرثوذكس البلدة إلى الكثلكة، وتقديم الخِدمِ الروحيّة للأجانب المقيمين فيها، وكتاب المعرفة باليد الأُخرى لتعليم أولاد المرتدّين ونَسْخِ الجهل عن بصائرهم.
وتلاهم في الحضور بعد أربع سنوات فحسب، اي في سنة 1634 الآباء الكرمليون LES PERES CARMES الذين رَفَعُوا لهم ديراً في المدينة بعد أن استقرّوا في بلدة بشرّي بالعام نفسه على ما زَعَم أحدهم الأب فرنسوا طُنْب. ثمّ تَبِع هؤلاءِ على الأَثر الآباء اليسوعيّون LES PERES JESUITES (1650)، وشيّدوا بدورهم ديراً تميّزت حركة رهبانه بتبشير المسيحيين في عاصمة الولاية والجوار من عكّار إلى اللاذقية شمالاً، وفي زغرتا والزّاوية شرقاً، وَرفْدِ أولادهم بالمعارف الممكنة. ولّا الغى الكرسي الرسوليُّ رهبنتهم حلَّ محلَّهم الآباء العازاريُّون LES LAZARITES، ونشطوا في طرابلس والزّاوية، وكان ذلك في عام 1783. وقد اكتشف العازاريّون، بعد حين، أنّ العناية بتعليم الإناث لا وجود لها فسَعُوا بعد ثمانين سنة من حضورهم إلى استدعاء راهبات المحبّة المعروفات في بلادنا بالعازاريّأت LES SOEURS DE LA CHARITE، وكان ذلك سنة 1863.
وكان الفرنسيسكان LES PERES FRANCISCAINS قد سبقوا الرّاهبات إلى الحضور التبشيريّ والتعليميّ، وكنّا رأينا لامارتين في النصّ الذي أدرجناه له منذ قليل كيف نزل في ضيافتهم خلال الحملة المصريّة عام 1832 – 1833، فأنشأوا في الميناء ديراً أشرف على بنائه الأب جوزيبّي سبيغا SPIGA الذي لم يلبث أن مات ودُفِن في كنيسته، إلى جانبه مدرستان: واحدة للذكور والثانية للإناث، فضلاً عن دير وكنيسة في المدينة تقعان في عُقْرِ الحيّ الأرثوذكسيّ قبالة كنيسة مار جاورجيوس الأرثوذكسيّة. وخلال هذا التسابق الإرساليّ المحموم على امتلاك روم المدينة، ألقى المرسلون الأميركيون البروتسطانت AMERICAN MISSON دّلْوَهُم بين الدّلاءِ، وكان حضورهم غير الثابت يعود إلى زمن حملة إبراهيم باشا على البلاد الشّامية، لكنّهم أقاموا بعد لأْيٍ في الزاهرية أيضاً، على مقربة من كنيسة مار جاورجيوس الآنفة الذكر، داخل طبقتين في بناء لآل مسعد، ولم يلبثوا أنْ أنشأوا على عَجَلٍ مدرسة في المدينة وأخرى في الميناء (1854)، ألغِيتا لاحقاً وقامت مكانهما مدرسة راقية للذكور في القبّة عام 1912 بإدارة ولْيم نِلْسون، وأخرى في الزّاهرية عام 1919 بإدارة مرغريت دوليتل MARGARET DOOLITTLE. واكتشف الرّوس متأخّرين تقصيرهم تجاه ملّتهم المنهوبة التي كانت عرضةً للاختطاف و"التّناتش" من قبل الكاثوليك والبروتستانت، فأقبلوا مدفوعين بِسائق المحبّة والغيرة على أُخوة لهم في المسيحيّة نخرَهم التسلًُّط اليونانيّ والإهمال المزمن على صعيد الدّين والتّعليم أجْيالاً في بلاد الشّام عامّة وفي طرابلس على وجه التحديد، وأنشأُوا في طرابلس والميناء أربعَ مدارس: اثنتيْن للذكور واثنتيْن للإناث عام 1887، على غرار المدارس التي أقاموها في حواضر سوريّة ولبنان وفلسطين وقراها؛ عُرفتْ بإسم "المدارس الأرثوذكسيّة الروسيّة الفلسطينيّة" وتوّجوها بدار للمعلّمين في النّاصرة، وبدار للمعلمات في بيت جالا. وأمام الهجْمتيْن الأميركيّة البروتستانتيّة والروسيّة الأُرثوذكسيّة اللتين أحْرزَتا نجاحاً مًرْموقاً، تدفّق على المدينة من جديد سنة 1886 سيْلٌ من إخوة المدارس المسيحيّة LES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES، واشتروا دير الكبّوشييّن، وهدموه لاحقاً ورفعوا محلّه مدرسةً كبرى أتبعوها بمدارس ابتدائيّة ثلاث: واحدة مجانيّة قرب معهدهم العالي، وواحدة في الميناء، وثالثة في عكّأر لم يذكر الأرشيف مكانها، وأصابوا في مسعاهم نجاحات لم تعرف المدينة لها ندّاً، وليس في ذلك ما يُدهش، فالفرير هم أكثر الرّهبنات براعة في فنّ التدريس بين المؤسّسات الكاثوليكيّة. فبالمقارنة بين المؤسسات التعليميّة الحديثة هذه، والمؤسسات التقليديّة السلفيّة نلمس أنّ الثانية لم تكن ذات برامج معاصرة، ولا كان أشياخها أصحاب مشروع متقدّم يتجاوز حدود التّلقين المألوف إلى نشْر الوعي وترسيخ الإيمان معاً، وكأنّ ديْدنُها من حيث لا تدري تعميق الشّرخ بين العلم والدين، على خلاف ما تصدّى له الشيخ حسين الجسر في مشروعه التّعليميّ الجادّ، الذي يمثّل المدرسة الوطنيّة الحديثة المطلوبة.
فعلى رمال هذا الساحل الذي كان شطُّه ينحسر عن جَزْرٍ مًسْرِف، ومَدٍّ يشتطُّ في اندفاعه، انتصبتْ في وجهنا مدرستان وطنيتان: المدرسة الوطنية الإسلاميّة، ومدرسة كفتين الوطنيّة الأُرثوذكسيّة.
1- الأولى أنشأها الشيخ حسين الجسر، جامعةً في منهاجها بين القديم والجديد، فعلّمت العلوم الشرعيّة إلى جانب العلوم العصريّة من ريّاضيات وطبيعيّات وفلك وفلسفة واللغتين الفرنسيّة والتركيّة، ليواجه بها مدرسة الفرير الكبرى التي لم يكن لمدرسة الوقوف في وجهها. وقد حظيت على رضى الخاصّة والعامّة، وكانت تقبل التلاميذ من غير المسلمين؛ كما نالت رضى مدحت باشا الشهير وإعجابه، ولكن أمرها لم يطلْ فعُطّلت من قِبل الدّولة سنة 1299 هـ وقد عرفت هذه المدرسة كثيراً من الأسماء التي نهلتْ من مَعين الشيخ حسين كان في طليعتها الشيخان محمد رشيد رضا وعبد القادر المغربيّ.
2- المدرسة الوطنيّة الثانية هي مدرسة كفتين الوطنيّة الأرثوذوكسيّة التي قامت في دير قديم سنة 1881 م برئاسة المطران صفروفيوس وهمّة وجهاء الطائفة في طرابلس، منهم: اسكندر كاتْسفليس وأسعد خلاط وجرجي ينّي وقيصر نوفل ونسيم خلاط وغيرهم؛ وكان من أساتذتها، في سنتها السّادسة، داود أفندي عيسى . ب . ع أستاذ الطّبيعيات والإنكليزيّة، والشيخ إبراهيم أفندي الفتّال أستاذ العربيّة والشريعة الغرّاء، وجبر أفندي ضومط . ب . ع أستاذ الريّاضيّات والفلسفة الطّبيعيّة والإنكليزيّة، وإلياس افندي مخلوف مدير وأستاذ الفرنساويّة، ومصطفى أفندي الشريف أستاذ التّركيّة، ويوسف افندي رزق اللّه، ناظر ومدرّس الفرنسيّة، وعليّ أفندي غالب مدرّس التّركيّة، وموسى أفندي خلاط، مدرّس المبتدئين، والدكتور ميخائيل ماريّا طبيب المدرسة. من هذه المدرسة تخرّج المفكّر الطائر الشّهرة فرح أنطون، واللباحث المبدع بندلي الجوزي، أستاذ العربيّة في جامعة باكو، وهو من بيت المقدس، وعيسى العيسى، صاحب جريدة فلسطين، وهو من يافا، فضلاً عن عشرات المتخرّجين اللذين أمّوها من كلّ أنحاء بلاد الشّام ومصر وتركيّة ... الخ. والحقّ أنّي شئتُ أن أذكر أسماء أساتذتها عن عمْدٍ لأقيم الدليل على أنّ فكرة العيش الواحد ليست أمراً طارئاً ولا ملقاً سياسياً أو اجتماعيّاً، مزجتْ في هذا التّجمع الأكاديميّ الإنجيليّ البروتسطانتيّ والمارونيّ والمسلم والأرثوذكسيّ على نحوٍ حضاريّ راقٍ، كما ذوّبت في بوتقتها الوطنيّة الطرابلسيّ والكورانيّ والكسروانيّ والمتنيّ والبيروتيّ ... الخ لبناء وطنٍ يحضُنُ الجميع بلا تمييز، على غرار المدرسة الوطنيّة التي أنشأها المعلّم بطرس البستانيّ في بيروت.
3- ومن جهة ثانية، أودّ أن أشير إلى أنّي وقفْتُ منذ ثلاثين سنة على السّجل العامّ الذي دُوّنتْ فيه اسماء التلاميذ الذين دَرَسوا في كفتين وتعجّبتُ بل دهِشْتُ لدى اطّلاعي على أسماء عرفْتُ بالبداهة انتماء أصحابها إلى الأُرثوذكسيّة والمارونيّة أو البروتسطانتيّة أو الإسلام، واسماء المسلمين بينها ليست بالقليل قطُّ ... وكانت حصيلة هذا التواجه بين المدارس السلفيّة والمدارس الأجنبيّة مضافاً إليها مدرستا الشيخ الجسر وكفتين انصراف السّلفينن إلى ما كانوا عليه من انغلاق، وإفراطاً في إتلاع رقابهم إلى الوراء، واندفاع المحدثين إلى ركوب العصر بما تيسّر لهم من أدواته في اللغات والعلوم، فشاعت الفرنسيّة والإنكليزيّة والإيطاليّة والروسيّة، صاحبها أشتات من الوعي العلميّ والحداثيّ؛ وبمعنى من المعاني، لقد كوّنت هذه المدارس طبقة جديدة يصحّ أن نطلق عليها اسم أنتلّيجنسيا استوعبت ما كان يدور في الغرب من حركات التغيير، ووعت القوانين التي أحدثت في أُوروبّة التحوّل في الدساتير، ووثبات في التكنولوجيا، والانتقال إلى الحريّة والديموقراطيّة. ومن داخل هذه الأنتليجنسا وعناصر أخرى تكوّنت خارجها ظهر لأوّل مرّة في تاريخ المدينة حراك فكريّ تمثّل في الجمعيّات كان في طليعتها:
- الماسونيّة: أنشأت محفلاً في المدينة سمته محفل قاديشا، وقفّت عليه بمحفل آخر في الميناء أطلقت عليه اسم: فم الميزاب، وكانت تُلْقى في المحفلين المغلقين على الإخوة الخُطبُ والقصائد الوطينّة والاجتماعيّة، وتناقش الأفكار الفلسفيّة التي تخدم أهداف المحفل في أغراضه غير المعلنة.
- يخبرنا جرجي زيدان صاحب الهلال في مصر، أنّ صديقه جرجي ينّي أعلمه أنّه اتّفق أواخر القرن الماضي (التاسع عشر) مع بعض الأدباء وألّفوا جمعيّة أدبيّة رئيسها إسكندر كاتْسفْليس وكاتبها جرجي ينّي نفسه، وانضمّ إليها كثيرون؛ وكانت تُلقى فيها الخُطب في موضوعات شتّى. فلمّا نشبت الحرب العثمانيّة الروسيّة سنة 1876 أقْفِلتْ.
- وبعد مرور اربع سنوات على توقّف الجمعيّة الطرابلسيّة الأولى، عاد جرجي ينّي فأنشأ جمعيّة أخرى باسم جمعيّة النادي الأدبيّ، وكان من أعضائها شقيقه صموئيل وفرح أنطون وأسعد باسيلي وغيرهم، وأُقفلت بسبب حوادث الأرمن سنة 1891، وكان غرضها إلقاء الخطب على الجمهور.
- ومن طريف ما وقَعْتُ عليه بين أوراقي مخطوط تضمّن نصّ الجلسة السادسة عشرة لجمعيّة اسمها: روضة الآداب لم يرد سامها في المراجع المعروفة، يقول النصّ: التأمت الجلسة السادسة عشرة القانونية لجمعيّة روضة الآداب في قاعتها الخصوصيّة تحت رئاسة قدس الأب الخوري الياس المرّ، وذلك مساء الأربعاء الواقع في 10 تشرين الأوّل. وبعد أن تلاَ كاتبها أسعد أفندي باسيلي وقائع الجلسة السابقة ومصادقة الأعضاء عليها، قرأ الكاتب المذكور تحريراً ورد للجمعيّة من العضو جرجي أفندي دياب يذكر فيه وصوله سالماً إلى نيويورك. وبعد تقرير المجاوبة على التحرير المذكور، لفظ العضو الياس أفندي أنطون خطاباً موضوعه "البِراز"، ثم تباحث المتباحثان داود أفندي موسى وجرجس أفندي نعوم في المسألة: أيّ ينفع الإنسان أكثر، العلم أم المال؟ فأجادوا كلّ الإجادة. وبعد مداولة ومناقشة بين بقيّة الأعضاء حكم الرئيس للوجه الايجابيّ وهو العلم ...
وبالمقابل، فقد رصدتُ كلّ المراجع المطبوعة وبعض المخطوطات التي وسعتني القدرة على مطالعتها بهدف العثور على جمعيّة أدبيّة لا خيريّ’ في الجانب التقليديّ من الحياة الثقافيّة الطرابلسيّة، فلم أظفر بشيءٍ وذهبت جهودي أبابيد .
- ثمّ كانت المفاجأة التي لم ينتظرها الطرابلسيون، لا بل لم تخطر على بال أحد، وهو وقوفهم دهشين في باحة المدرسة الأرثوذوكسيّة في الميناء أمام خشبات متّصل كلها بالطول والعرض، يقوم عليها أشخا من لحم ودم، ينقلون بالصوت والإيماءة حركات الجسد الذي لبِس أزياء التّاريخ، حياة "الشيخ الجاهل"، وهي مسرحيّة كتبها ودَكْوَر مسرحها، ومكْيجَ شخوصها الكاتب والشّاعر ميخائيل ديبو (1842 – 1924)، وكام ذلك عام 1872، ثمّ أتْبَعَ الرّجُلُ ريادتَهُ على صعيد المسرح بجملةٍ من الأعمال منها: "العشيقة المجهولة" و "شقاء الحب" و "داود وشاوول"، و "غرائب الغرام" ... وتُعتبر مسرحية " "الشيخ الجاهل" ثاني عملٍ بعد مارون النقاش رائد المسرح العربيّ، أو ربّما الثّالث بعد الشيخ إبراهيم الأحدب على رأي د. نزيه كبّارة. وإذا كان تاريخ المسرح في طرابلس قد أطّر صورة ميخائيل ديبو وعلّقها في مُتحفهِ، فإنّ مدرسة الإخوة LES FRERES تستحقّ كذلك أن نُعلّق صورتها على الجدار نفسه، ذلك أنّها أنشأت محفلاً أدبياً عربياً أطلقت عليه اسم: "محفل اللغة العربيّة، قام أعضاؤه بنشاطات ممتازة منها تقديم مسرحيّة "نبوخذ نصّر" أمام 400 مشاهد، في الرابع عشر من حزيران سنة 1892، فأحدث عرضها دهشةً في المدينة. ثمّ قدّموا في العام التالي (1893) مسرحيّة "سميراميس". وفي العام 1899، عرضُوا عملين آخرين، مسرحيّة "الغفران" باللغة العربيّة، ومسرحيّة "الأسيران" LES DEUX CAPTIFS باللغة الفرنسيّة. وساء قدّم تلامذة الفرير، عبر محفل اللغة العربيّة، أو محفل اللغة الفرنسيّة الذي أقاموه لاحقاً، أعمالهم المسرحيّة كثمرةٍ من ثمار حديقتهم، أو بحبر غيرهم، فإنّ مآثرهم في هذا الحقل، مسبوقةً بعطاءات ديبو تأسيساً، تحمل البذار الأُولة للمسرح الطرابلسيّ في نهايات زمن كان ينغلق على قرن وينفتح على قرن آخر.
- إلاّ أنّه قبل أن ينغلق القرن بتمامه بسبع سنين، أي في سنة 1893 على وجه التّحديد، أبصرت جريدة "كرابلس الشّام" النّور، بناءً على طلب ترخيص تقدّم به محمد كامل البحيري (1856 – 1920) إلى السلطان في الآستانة، فتفضّل جلالته بصدور إرادته السنيّة وأوامره الشاهانيّة، ونشر بالإذن "لهذا العاجز" بإنشاء مطبعة طرابلس الشّام تسمّى "مطبعة البلاغة"، ونشر جريدة أسبوعيّ’ تدعى "طرابلس"، تسعى بخير الوطن، وتخدم اللّه والدولة بكلّ منهجٍ مؤتمن. وقد تسلّم رئاسة تحريرها الشيخ المفكّر حسن الجسر الذي نشر على صفحاتها مشروعه الإصلاحيّ والدينيّ والاجتماعيّ... عُمِّرت هذه الجريدة أربعة وعشرين عاماً، أي حين حُمّ القضاء بالبحيريّ سنة 1920. والحقيقة إنّ "طرابلس الشام" أسدت خِدماً في إطلاع القاريْ على آخر المستجدّات المحليّة والعثمانيّة والكونيّة، وكان لها – كما أخبرني المرحوم عزمي البحيريّ نجل صاحب الجريدة، مراسلون في متصرفيّة طرابلس وفي الآستانة عاصمة الدولة العليّة يمدّونها بكلّ جديد. وتُعتبر "طرابلس الشام" باكورة الصحافة العربيّة في المدينة، وقد ظهرت في أعقابها الجرائد التالية:
- "لباب الألباب"، خطيّة ظهرت في معهد كفتين في 9/2/1883
- نزرة الأباوة للشيخ منير الملك والحاج كامل بحيريّ 1897
- الشّعلة، لا ذكر لإسم صاحبها.
- الرغائب، لحكمت شريف (1907 – 1914)، ثم عادت إلى الظهور في اللاذقيّة بعد انتهاء الحرب الأولى
- المباحث، لجرجي ينّي وأخيه صموئيل (1908 – 1914) – (1918 – 1941)
- جامعة الفنون لأحمد كمال الحداد (1909)
- الوجدان، لمحمد سامي صادق (1910)
- شمس الإتّحاد، لعبد الرحمن عزّ الدين (1910)
- الأجيال، لتوفيق اليازجيّ (1910)
- المحاميّ، لأحمد سلطان (1911)
- المدلّل، للشيخ محمد منير الملك (1911)
- كراكوز، لصلاح عبد الحليم مراد (1911)
- الحوادث، للطف الله خلاط وعبد الله كسّاب (1911)
- البرهان، للشيخ عبد القادر المغربي (1911-1915)
- البيان، لمصطفى البارودي والشيخ جميل عدرة (1911)
- السعدان، محمد صلاح الدين مراد (1911)
- صدى الشعب، للأمير أسعد ألأيوبيّ (1913)
- الضمير، لناصيف طورباي (1914)
إلاّ أنّ هذا الحراك الذي تمثّل بالمدرسة، قديمة وحديثةً، منطلقاً، والجمعيات الأدبيّة والمسرح والصحافة تعبيراً، وبالمطبعة تنفيذاً، وقد آثرنا ترك الكلام عليها لضآلة أثرها، هنا، قياساً إلى مطابع بيروت ... سلك طريقه إلى الإفصاح الدينيّ والفنيّ والعلميّ والتاريخيّ عند نفرٍ من المتنوّرين والتقليديين في المدينة التي أخذت تخرج من عزلتها، وتخلّصت من صمتها، فشاركت بيروت ودمشق وحلب والقاهرة في الإنتاج، والواقع أنّ هذا العطاء في معظمه عبّر عن هواجس وقناعات وتطلّعات اتّخذت في توجهها مناحيَ أو تيّارات أهمّها ثلاثة:
1- التيّار السلفيّ: وجلّ بحوثه دينيّة، إن لم تكن كلّها من صلب الدّين، وعلى رأسه بلا منازع الشيخ حسين الجسر الذي تظلم اجتهاده وتسيء إلى ذكائه وبُعد نظرهِ وقدراته العقليّة الخارقة إذا وضعتْهُ في منزلة واحدة مع سلفيّ آخر هو أبو المحاسن شمس الدين محمّد القاوقجي الذي فسّر القرآن، وما أكثر من فسّره من قبل ومن بعدُ، وأسرف في الكلام عن الحديث الموضوع، وفي المكتبة الإسلاميّة نظائر لا تحصى من هذه الأعمال ... أو إذا قارنتَهُ بالشيخ محمود نشّابة الذي قضى عمره في وضعِ الحواشي على متن البيقُونيّة في مصطلح الحديث النبويّ، والتعاليق على شرح الضنّاويّ في المنطق ... الخ أو إذا وازنْتَهُ بالشيخ عبد الغنيّ الرافعي الذي سلخَ بعض عمره في التّعليق على حاشية إبن عابدين، وعلى أسرار الاعتبار في التّصوّف، وما أكثر ما خطّته أقلام الفقهاء في أمثال هذه الموضوعات!! ولن أزيد كَمّ هؤلاء نوعاً إنْ أضفتُ إليها أسماء سطعتْ في زمنها كالشيخ درويش التّدمري الكبير والشيخ خليل الثّمين والشيخ محمّد إسحق الأدهمي وغيرهم. فالذي عندي لصاحب الحصون الحميديّة لمحافظة العقائد الإسلاميّة، والرّسالة الحميديّة في حقيقة الديانة الإسلاميّة، أنّه استنّ في علم الكلام طرائق غير مسبوقة عند أقطابه في قمّة عطائهم، دفاعاً عن الإسلام، على غير تقليد أو اقتباس. إنّه بالفعل عبقريّ مبدع، مجدّد في حقله تجديداً تضيق على عنانه حلقة الانتساب إلى التيّار السلفيّ. ولولا طبيعة الموضوعات التي طرقَها، وهي لا شك من صُلب التقليد، لاعتُبرتْ معالجاته على النّحو الذي ذكرنا، الرّقم الذي لا يجارى في الخلقِ والتّجديد. وصفوةُ الكلام في تقليد الشيخ حسين أنّه ابتدع أقيسة وموازين لو وُضِعت في بناءٍ معاصر لكان – وهو لا ريب كذلك، من أكبر المفكّرين الإسلاميين، إن لم يكن أكبرهم بلا مراء، في العصر الحديث ...
الى ذلك الوقت، لم يفُت مسيحيي المدينة الاشتراك في النّقاش حول صحّة العقيدة الأُرثوذكسيّة، وقد يهون الأمر معهم لو ظلّ الخلاف محصوراً بينهم وبين المبشّرين اللاتين حول القضايا الخمس، وهي في حقيقتها قضايا سخيفة، ليست من جوهر العقيدة في شيئ، ولكنّها "جُوهِرَت" لأسباب سياسيّة، ونالت من المكابدة والعنَتِ اللاهوتيين ما لا تستحقَه بسبب غطرسة رومة و غباء القسطنطينيّة. ولكنّ الذي استجدّ على الساحة الطّرابلسيّة الأُرثوذكسيّة أدهى من السكوت عليه وأخطر من أن يُحتمل : إنّها البروتسطانتيّة التي حضرت تزلزل العقيدة و الطّقوس، وتدعو إلى مسيحيّة من نوع آخر لم يألفها الأُرثوذكس من قبلُ. من هنا كانت المناقشات تدور حادّة بين روم المدينة والمرسلين البروتسطانت، وفيها من المواقف السّاخرة ما يُضحِك ويُبكي، من ذلك ما رواه هنري جَسَـب في كتابه: "ثلاث وخمسون سنة في بلاد الشام" عن أول إنجلييّ في بلاد الشام، وهو أنطونيوس ينّي، قال: لقد كان رعبه عظيماً حين تسلّم كرّاسة دينيّة من الدكتور طمسون في الميناء، فأمسكها على بعد ذراع، وركض ميلاًََ ونصف الميل إلى بيته في طرابلس وأحرقها في موقد المطبخ، ثمَّ توجّه إلى الكاهن واعترف له بخطيئته. وبعد أن استمع الكاهن إلى إعترافه فرضَ عليه ثلاثة قروش لأنّه تسلّم الكرّاسة وغفر له، ولكن حين علم الكاهن أنّ الذي أحرقه ينّي كان بعض مزامير النبيّ داوود، فرض عليه أن يدفع ثلاثة قروش أخرى. وهكذا وقع صاحبنا مرتبكاً بمنطق الكاهن.. وممّا هو مأثور في الأدبيّات المسيحيّة، هنا، الخلاف الذي شجَرَ بين نوفل نوفل الذي إعتنق البروتسطانتيّة وابن عمّه سليم دي نوفل المتمسّك بأهداب الأُرثوذكسية، وكان سليم قد لام نسيبه على صبائهِ الى مذهبٍ ليس من إرث أجداده في شيء، ووضع في ذلك كتاباً سمّاه "الفضنفريّ"، فردّ عليه نوفل بكتاب عنوانُه "جُوَيْب كُليْماَت الشيخ نصر الدين الفضنفريّ" يحمل فيه على الأرثوذكسيّة ويتّهمها بالتّحوير والتّزوير، ويدعو معتنقيها الى نبذها وإستلهام الحقيقة من الإنجيل، و التخلّص من الشّعائر الوثنيّة التي تُهيمنُ عليها.
2- التيار الليبرالي، واللفظ من اللاتينيّة LIBERALIS ، بمعنى ما يتّفق مع الإنسان الحرّ ويتوافق مع الحريّة الفرديّة. وللفظ تفاسير و تآويل كثيرة لا تتفق مع حقيقة المرحلةالتاريخيّة التي كانت عليها طرابلس في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وقد استعرناه من سياقه التاريخيّ استعارة شكليّة على الأقل، لنصف به أفواج المتخرّجين من المدارس الأجنبية المحليّة أو الذين أنهوا تحصيلهم في أوروبة، أو تخرّجوا من كفتين، وآمنوا بالفكر الحرّ سبيلاً للخروج على القديم، ودعوا إلى الحداثة والانفتاح على الغرب والإفادة من إنجازاته الفكريّة والسياسيّة والإجتماعيّة، يضاف إليهم فصائل من العصاميين الذين تجاوزوا السلفيّة وانحازوا إلى الليبراليّة ... والذين حُسبُوا، بشكل أو بآخر، في عداد هذا الخطّ ليسوا قلّة قط، ولا هم ممن لا يحسب لهم حساب ... كان بينهم وبين السلفيين ما يشبه الحرب غير المعلنة، ولكنّها كانت واضحة في المنحى الذي فيه يكتبون، وطبيعة الموضوعات التي تطرح، فمن يرى الأبيض على هذا الجانب، يدرك الأسود في الجانب الآخر، ويعرفه نقيضه الذي لا تجمعه به صفة في اللون، ولا حضور في السّمْت. ونحن نفهم من ذلك أنّ من ملكوا الساحة الطرابلسيّة فكرياً قروناً كثيرة بدأوا يفقدون امتيازاً في الامتلاك خُصُّوا به دهوراً، وأنّ الإغراق في الماضي واجترار قضاياه على غير طائلة، مضيعتان قد تؤخران التسريع في عجلة التغيير، ولكنّهما – على إصرارهما – لا يقويان على إلغاء العجلة وحركتها. ونحن إذ نقول إنّ الحرب لم تكن معلنة بين الطرفين، لصفات اتّصف بها أهل المدينة، منها أن أهل السّلف امتازوا على الدّوام بترفّعهم عمّا يشين يحدوهم إلى ذلك خلق نبيل وتربيّة إسلاميّة شفّافة، كما امتاز الليبراليّون بتهذيب جمّ وتوقير سمْحٍ حضنته المدينة في تراثها أيام قضت المقادير أن يهاجر هذا التراث بلا رجعة بين الدخان وألسنة النّار وحقد الغزاة الأسود .. وكان في طليعة ما نتج عن الحراك الحضاريّ انشغال الليبراليين بهاجس البحث عن الهويّة والانتماء الوطنيّ. وكانت هذه القضيّة محسومة عند أهل السّلف، فالدولة العثمانيّة دولةٌ أبديّة البقاء، وبناءً على ذلك فانتماؤهم أمميّ في الإسلام، وعثمانيّ في الولاء تمثلانه قاعدة الدولة في استانبول برئاسة خليفة هو السلطان عبد الحميد خان أو محمّد رشاد أو من يشبههما في السلطة من السابقين واللاحقين ... ولم يكن الآخرون من هذا الرأي، فقد رأوا بأمّ العين أنّ الدولة مقبلة على زوال بفعل عوامل داخليّة تتّصل بالإقتصاد المنهار والديون المتراكبة والانتفاضات العرقيّة في جسمها الشائخ، وتردّي الأوضاع السياسيّة والإجتماعيّة ... فضلاً عن علاقاتها الخارجيّة المضطربة مع باقي الدّول، وكثرة الحروب التي خاضتها، فأنهكتها بشرياً ومادياً وجرّدتها من معنوياتها وثقتها بالنفس. وقد قاد هذا التيّار نوفل نوفل وجرجي ينّي ...
3- التيار الخدميّ أو البرجوازيّة الصّاعدة: ويمثّل مجموع الموظّفين الذي اكتسبوا المعرفة المكتبية والإدارية في المؤسّسات الخاصّة، والتي كان يشغلها من قبل موظّفون متوسطو المعرفة، فزادهم المراس الطويل والخبرة حسن المزاولة وكان الأخوة LES FRERES قد أنشأوا سنة 1907 في معهدهم فرعاً لتعليم التجارة، آخذين بعين الاعتبار سوء الحال في حياة المؤسسات العامّة، ومتطلعّين بعين الأمل على تطوّر طرابلس في المستقبل القريب وحاجة إداراتها ومؤسساتها التجارية إلى موظفين أكفياء يجيدون اللغات الأجنبيّة، وبارعين في تدبّر الأمور التي تسند إليهم ...وكانت مدّة الدراسة في فرع التجارة ثلاث سنوات. ولتنفيذ ذلك قاموا بتحقيق ثلاثة أمور:
1- استحضار برنامج المدارس التجاريّة المعمول به في فرنسة.
2- استحضار الكتب والمراجع المقرّرة في المدارس الفرنسيّة.
3- استقدام عناصر من رهينتهم متخصّصة في هذا العلم.
وبعد ثلاث سنوات أي سنة 1910 تخرجّت الدّفعة الأولى، وتوزّع أفرادها على المؤسسات التجاريّة والمكتبيّة والمصارف، بل إنّ كثيراً من أمثال هذه المؤسسات استعانت ببعض التلاميذ الذين أنهوا دروسهم في المعهد من غير أن يكونوا من المنتسبين إلى فرع التجارة، لا لشيء، إلاّ لأنهم يعرفون العربية والفرنسية والإنكليزية، وزوّدوا ثقافة عريضة، منها الوعي التجاريّ، تؤهلهم على تعاطي هذه الأعمال بجهد قليل وتجربة مواكبة. وليس من المبالغة في شيء أن نجزم أنّ مثل هذه الثقافة توافرت لهم من خلال محفل القديس جورج الذي كانت لغته فرنسيّة. في هذا المحفل أجروا قراءات مطولة وبحوثاً شتّى تدور حول: العمل، رأس المال، الانتاج، الملكية، العامل وأجره، النقابات، التعاون، الإضرابات، المال، القِرض، المصرف، التجارة، الادّخار والترف السكانيّ والفقر، الضريبة والدخل الماليّ الخ..
وكمثال للمتخرّجين من معهد الفرير وفرع التجارة نذكر أن البنك العثمانيّ، ومركزه في البناء الذي يقع فيه "مقهى فهيم" على ساحة التل. عمل فيه نجيب برنس، والد المحامي الأستاذ موسى برنس، وفؤاد صوايا الذي انتقل فيما بعد إلى مصرف حماه، فدمشق، وأصبح لاحقاً المدير الثاني للبنك في كل فروعه. ولا ننس أن ذلك كان قبل 1914.
المصرف الألماني الفلسطينيّ وكان مركزه في بناية نحّاس في الزاهرية (محل نقابة معلمي المدارس الخاصّة اليوم) كان مديره ألمانياً، ونائب المدير موسى الدومانيّ.
مصرف سالونيك: وكان مركزه في محل أميوني لاحقاً، شارع التلّ. توظف فيه وهيب النيني قبل التحاقه بكلية الطبّ اليسوعيّة، وجوزيف عبد، شقيق السيّد أنطوان عبد مطران الموارنة في طرابلس، وميشال حسّون وجوزيف خلاط ابن زاهي خلاط المصرفيّ الذي قام محله مقابل بنك سالونيك.
وبالطبع ليس لي أن أتحدّث عن مئات غيرهم عملوا في التجارة أو أنشأوا مكاتب لتخليص البضائع، أو كانوا موظّفين كباراً في البلدية، أو شركات البواخر، أو من تاجروا بالحديد والخشب، أو استوردوا أدوات البناء، فضلاً عمّن هاجروا إلى مصر أو البرازيل أو الولايات المتحدة الأميركية ...
كما أني لن أتحدّث عمّن تخصّصوا في بيروت أو الخارج بالطبّ أو الصيدلة أو أقاموا مختبرات طبيّة أو من درسوا القانون وأنشأوا مكاتب محاماة الخ.
**************
وهذا حراك تكوّنت أجنّته في رحم المدينة ثم أطلقته بركة في الدين المتسامح والمدارس السامية والأدب الرفيع والدراسات الراقية والحياة الإجتماعيّة التي توافرت خدمها في كلّ أرجائها. أكان ذلك كلّه قبل الحرب العالمية الأولى؟ نعم. كان حلماً أطلقته اليقظة، وسيكون له شأن هامّ، بعدما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، متوزعة مسارات، يندفع بعضها إلى المستقبل، ويرتجع بعضها الآخر إلى الماضي مسكوناً بالحنين والاشتياق.
المنارات الخمس
نستصفي من أعلام طرابلس الكثر خمسة و نعرض لكلّ واحد منهم بموجز سيرة تحاول أنّ ترسم بعض ملامح تفكيره المعلنة أو التي تنتظر من يعلن عنها في الزمن اللاحق من الدارسين .
وليس في استصفائنا الخمسة الأعلام ما يحطّ من منزلة الغُفلْ ممّن سكتنا عنهم، وهم كثرٌ، ولكنّا آثرنا من الجمع العامّ لشريحة النابهين أمريّن: الإحساس الشديد بالحاجة القصوى إلى التجديد، والعمل بجدّ متواصل على ترجمة هذا التجديد بحبرٍ زاهٍ زادته جدّة النصّ إشراقاً، أو ممّن أسهموا على غير علمٍ منهم بالحراك الثقافيّ من خلال المنظور الرسميّ، ضمن المقارنة بين الواحد و الآخر،فالضدّ يظهر حسنه الضدّ .
الشيخ حسين الجسر
إذا كان العبقريّ هو من يستكشف المخبوء الممكن من هموم الفكر، ويحلّ ما إستعصى على غيره فهمه وحلّه ودفعه إلى التنفيذ، بآلة تستعصم بالعقل أسلوباً، في دواعي الحباة، فحسين الجسر عبقريّ بإمتياز. أبصر النور في الفيحاء سنة(1261ه / 1845 م ). أبوه أبو الأخوال محمد بن مصطفى المشهور بفضله وصلاحه، وأمّه السيدة خديجة من آل رمضان.فقد أباه وهو لم يتمَّ العام الأول من عمره بعد، فكفله عمّه الشيخ مصطفى وأحسن وصايته. قرأ القرآن الكريم ، وتعلم الخطّ ، ثم إنتقل إلى حلقة الدروس العلمية فقرأ على الشيخين عبد القادر وعبد الرزاق الرافعيّ ، وعلى الشيخ عرابي مبادئ اللغة و الفقه،ثم إرتحل إلى الازهر في مصر فأكبّ على تحصيل العلوم الدينيّة و العقليّة واللغويّة طوال أربع سنوات، إضطر على أثرها إلى العودة ألى بلده بسبب إشتداد المرض على عمه الذي كفله وقام مقام أبيه على تربيته.
إشتغل في طرابلس بالإرشاد و التعليم فذاع صيته وتخرج به كثيرون منهم نجله الشيخ محمّد الجسر رئيس مجلس النواب اللبنانيّ و الأشياخ امين عزّ الدين قاضي طرابلس، وإسماعيل الحافظ، وعبد القادر المغربيّ عضو المجمع العلمي العربي في دمشق و القاهرة و رشيد رضى صاحب المنار ....
تركّ من الآثار المطبوعة و المخطوطة ما يزيد على خمسة عشر مؤلّفاً من أهمها عملان : الرسالة الحميديّة في حقيقة الديانة الإسلاميّة، و الهديّة الحميديّة لمحافظة العقائد الإسلاميّة ....
فضلاً عن مقالاته التي جمعت و طبعت في عشرة مجلّدات، بعد موته، بعنوان: رياض طرابلس الشام. أدركته الوفاة في طرابلس عام 1327ه /1909 م عن 64 عاماً. ودفن فيها .
أمام ما كان يعصف بالعالم الغربيّ من تحوّلات وتبدّلات في السياسة و الإجتماع و الإقتصاد، ومن تطوّر على الصعدّ العلميّة النظريّة و العمليّة ، والشرق بَدَنٌ ( والبدن في التشريح هو الجسد ما سوى الرأس و الأطراف) ضعيفٌ متهافتٌ تنخره الأمراض وندرة الترياق والجوع الذي لا يرحم، فإذا أضفنا إليه اليدين و الرجلين والرأس ليستقيم تجميعه، أكتشفنا يدين خائرتيّن من فرط الكسل في الإنتاج، ورجليّن كسيحتين من قلّة السعيّ و الحركة، وأما الرأس فمغارة مظلمة تعشعش فيها وطاويط الخرافات و الأساطير و الجهل وأفكار الأمجاد الماضيّة...
وحاول المصلحون والعقلاء وبعض العلماء إنقاذ المريض من إحتضاره، وردّ أذى الغرب عنه بأفكاره العلمية غير المحققة التي تشكك بإيمانه و عقيدته. وشذّ عن هذا العجز الإسلاميّ الشيخ حسين الجسر الذي كانت سلفيته تقوم على وجوب ممشاة الدين للعلم باضطراد ذلك أنّ تخلّف أحدهما عن الآخر مهواةٌ عميقة الغور ليس لها قرار،سيكون المسلمون ضحاياها من غير ريب، فتكلم وأوفى على ما تكلم به علماء الكلام، وإرتقى بهذا العلم الى درجةٍ غير مسبوقة ليقف في وجه التحدّيات النظريّة العلميّة التي تواجه التوحيد الأسلاميّ . ويعتبر هذا المسعى موقفاً متقدّماً تجنّب الخوض فيه وتهيّبه كلّ من جمال الدين الأفغانيّ (1838/1897م) في كتاب "الردّ على الدُّهرييّن"، ومحمّد عبده(1845/1905م) في "رسالة التوحيد" لصعوبة مناقشته علميّاً وقلّة بضاعتهما فيه. وفي طليعة النظريّات العلميّة التي يتعرض لها الجسر، النظريّة النشوئيّة ، كما فهمها لَدُنْ قراءتها في مكتبة الكليّة الإنجيليّة السوريّة في بيروت( الجامعة الأمريكية اليوم) فشرحها وناقشها مناقشة عقليّة تلقى إرتياحاّ في القلب وترسخ الإيمان فيه، ولكنّها لا تدخلّ في النظريّة بتفاصيلها العلميّة على النحو الذي تفصِّل فيه الهواء مثلاً على أنه جسم مؤلّفٌ من عنصريّن أساسيين هما الأوكسجين والهدروجين وما هما؟ وما نسبة واحدهما في الليتر الواحد؟ وما العناصر الضئيلة من ثاني أوكسيد الكربون، والأرغون، وغازات أخرى وما يعلق فيه من تراب وجراثيم؟...إذا، لو ناقش العلم بالعلم لجاء نقاشه على مستوى السطح العلميذ لدارون. وقد إعتُبِرَ مذهب دارون(1809/1882م) يوم ذاك إنتصاراً للماديّة البحت، ولكنّه إنتصارٌ لم يكن حاسماً ولا قاطعاً، غير أنّ الفكر بعدما إصطدم بصخرة" التطوّر"، مضى يتخبّط غير مستقرّ، ومضى زمان طويل قبل أنّ يدرك سواد النّاس أنّ دارون إنما تناول في بحثه العلميّ عصر "ما بعد الخليّة" التي هي أساس الحياة بكلّ صورّها، ولكنّه لم يعرض للبحث في عصر ما "قبل الخليّة"، ليعرف كيف نشأت الحياة في تلك الصورة البسيطة، ومن أين هبط ذلك السرّ الرهيب: سرّ الحياة الذي جعل من المادّة الجامدة كائناً حياً؟ فعندما شعرّ الماديّون بأن إنتصارهم لم يكن حاسماً، وانّ الحياة، وإن شئت فقل: ما الحياة؟، وهي الصخرة التي تتحطّم عليها أسس المادّيّة، قالوا: بالتوالد الذاتيّ، أيّ إن الحياة تتولّد ذاتياّ من مادّة غير حيّة، غير انّ ذلك لم يقم على شيئٍ من العلم ولم يثبته الأسلوب العلميّ، لأنّ العلم يثبتّ أنّ كلّ حيّ إنّما يتولّد من حيّ مثله. إذاً، هناك حادث خطير وقع فاصلاً بين عصريّن: عصر "ما قبل الخليّة" وعصر "ما بعد الخليّة" وفي الكشف عن السرّ الذي يختفي من وراء ذلك الحادث ينطوي مستقبلُ الإنسانِ كُلُّه: أيتّجه إلى المادّة، أمّ يتجه إلى الروح؟ عبقرية الجسر تتجسدّ في ذلك الجدّل "الكلاميّ" المقنع في إستحالة حركة المادّة الصمّاء من دون محرّك، أيّ إستحالة حركتها ذاتياً لذلك شكك بنتائج العلم المبني وهماً على نظرية التوالد الذاتيّ، وهي نتائج تشكّك في التوحيد والإيمان بأنّ الله واحد أحد، خالق كل شيء وهما ركنان أساسيان من الأركان التي تنهض عليها الشريعة الإسلاميّة. وربّما كان الشيخ حسين من أوائل من تنبه في العالم إلى موضوع الخليّة فأمسك بتلابيب دارون ومناصريه في كلامه عن موضوع الحياة في الخليّة فأفسد على الدارونيين نظريتهم في التولّد الذاتيّ وقضى عليها قضاءً شبه تام. بمثل هذا الإندفاع الصادق إقتحم معركة الإلحاد دفاعاً عن المسلمين في إيمانهم بعد ما بدأت نتائجها تتسرب إلى قلوب أنصاف المتعلمين من المسلمين. ولا شكّ أنّ الجسر إستطاع، في محيطه الطرابلسي على الأقل أن يرعى جيلاً عريضاً من المريدين الذين حافظوا بتعاليمه، لمدى طويل، على روح الإسلام المتسامح في المدينة. وليس ثمّة شكّ بأنّه الرجل الوحيد الذي ملك زمام الحراك الفكريّ بكافة ألوانه في زمنه وبعد رحيله، و الذي ما تزال أطيافه تحوّم في أرجاء الفيحاء.
***
نوفل بن نعمة الله بن جرجس نوفل
ولّد في الفيحاء عام 1812م، ودرس مبادئ العربيّة في طرابلس، والخطّ و الإنشاء على أبيه الذي لم يلبث أنّ حمله إلى وادي النيل، فتلقى في إحدى مدارسها التي أنشأها محمّد عليّ باشا بعض العلم، ثم دخل مأموريّة قلم المحاسبة في طرابلس واللاذقيّة، كما إنتقل إلى عدّة وظائف أخرى في بلاد الشام....وكان لا يطول غيابه عن المدين، فيؤوب إليها على عجلٍ، فآله وسكنه الأساس ومكتبته فيها. عمل سحابة عشرين عاماً في بيروت ترجماناً في القنصليّة الألمانيّة أولاً، ثم في القنصليّة الامريكيّة حتى أدركته الوفاة سنة 1887م بلا عقب، تاركاً لنا مجموعاص ضخماص من التآليف الموضوعة والاعمال المنقولة عن التركيّة.
نقل عن التركيّة: قانون المجالس البلديّة، وأصل الشركس ومعتقدهم والدستور العثمانيّ في جزئين كبيرين، وكتاب حقوق الدوّل. وألف في العربيّة زبدة الصحائف في أصول المعارف، وهو كتاب موسوعيّ المعلومات فيه تاريخ و فلسفة الكلدان و الفينيقيين والإيرانيين و الهند و الصين و مصر و اليونان، كما انّ فيه فصولاً في الفلسفة وفِرَقِها، وبحوثاً في أصول العلوم، والمنطق ، واللغة، والرياضة، والطبيعة، والطب والتاريخ و الجغرافيا و الجيولوجيا والكيمياء والمعادن والنبات. ويلي هذا السِّفْرَ الضخم أسفارٌ أخرى منها: زبدة الصحائف في سياحة المعارف، وسوسنة سليمان في العقائد و الاديان، وصناجة الطرب في مقدمات العرب.... إلى غير ذلك من الاعمال التي كانت في واقع الحال الضرمَ الأولَ الذي أشعلَ الحراكّ الثقافي في خلال القرن التاسع عشر. ويقول عنه مؤلّفا "ولاية بيروت": قصارى القول أن نوفل أفندي من الذين لهم الموقع الأسمى في تاريخ العلم السوري، لا في النهضة العلميّة الطرابلسيّة فقط، وعليه فليفتخر الكيان العلمي في طرابلس بما خلّفه هذا المبشّر المبجّل من الآثار النفيسة.
***
جرجي ينّي
في سياق الحراك الثقافيّ الحديث، كان جرجي ينّي الذي أبصر النور في طرابلس عام 1854م ، من أسرة يونانيّةٍ الأصل. أُرسِلَ في صغره إلى كتّاب من كتاتيب المدينة يلتقط الحرف و الخط على مدى لاث سنوات، ثم إنتقل إلى المدرسة الأمريكية البروتسطانتية في المدين لعامٍ واحد أخذ فيها مبادئ الإنكليزيّة و الحساب و التاريخ و الجفرافية و شيئاً من المعارف الطبيعيّة هيأته لدخول المدرسة الوطنيّة التي أنشأها المعلمّ بطرس البستانيّ في بيروت التي كانت مدرسة كفتين مثلها الاعلى في الوطنيّة ، فتلامذتها من كلّ الطوائف و المذاهب المسيحيّة و الأسلاميّة و اليهوديّة و كذلك معلموها. تعلّم العربيّة و الإنكليزيّة و الفرنسيّة و اللاتينيّة و الرياضيّات و الطبيعيّات و المنطق و الفلك و الفلسفة و التاريخ و الجغرافيا، و مكث فيها خمس سنوات متواصلة فشدا طوال هذه المدة من المعارف ما لم يستطعه غيره في عشر سنوات. وقد ذهب صاحباه" ولاية بيروت" إلى أنّه تعلم في الجامعة الامريكيّة بينما يتحدث في مذكراته التي نحتفظ بدفتر رقم واحد منها عن تلقّيه دروسه البيروتيّة العالية في المدرسة الوطنيّة. عام 1873 قفل راجعاً إلى طرابلس وهو في التاسعة عشرة أو العشرين من العمر، فخلف أباه بجميع أعماله المصرفيّة و الساسيّة. أسهم في إنشاء معهد كفتين، وأنشأ مع نفرٍ من متنوري المدينة عام 1884م كأسعد باسيلي وفرح أنطون والدكاترة ميخائيل ماريّا ومتري السيوفيّ وخليل الحايك وعفيف عفيف و آخرين منهم يعقوب نعّوم و نسيم نوفل وشكري الفاخوري و جرجي الخوري و أخوه صموئيل .... وكان من قبل أي في عام 1876م قد جمع بعض المتنورين في جمعيّة أدبيّة رأسها إسكندر كاتسفليس، تُلقى فيها الخُطبُ في موضوعات ذات بعدٍ تقدميّ في الدين و الثقافة و العلوم و الأقتصاد و الإجتماع و الادب، ولكنها أُ قفلت بأمر من السلطات بسبب الحرب الروسيّة العثمانيّة.
عام 1908م أصدر بالإشتراك مع أخيه صموئيل مجلة"المباحث"، وكانت من أرقى المجلات المشرقيّ تعنى بنشر بحوث في التاريخ اللبنانيّ خاصّة وتاريخ سورية وفلسطين والعراق و تركيا وغيرها عامةً تعتبر بحقّ من أدقّ البحوث وأرقاها ظلت تصدر على نحوٍ متواصل، بإستثناء سنوات الحرب العالميّة الأولى حتى أعيا. قضى عن سبعة و ثمانين عاماً(1936م) تاركاً وراءه مكتبةً في التاريخ و الثقافة العامّة، بلغات مختلفة ، عزّ نظيرها في مكتبات لبنان الشماليّ بلا إستثناء. وقبل أنّ أتحدث عن مؤلفات ينّي،أستدرك لأشير إلى أن المدينة كانت تحفل بأرهاطٍ من المثقفين ذُكرت بعض أسمائهم في أثناء الكلام على الجمعيّات الأدبيّة التي أنشأها جرجي ينّي، فيما غابت أسماء أخرى لم تزاول النشاط الفكري في إطار جمعيّات هادفةً إلى بثذ أفكارها بعد مناقشتها في الغرف المغلقة. والملاحظة الثانية أن جلّ هؤلاء المثقّفين و بينهم دكاترة، لم يُخلّف عملاً مكتوباً في موضوعاتٍ معينة أو في غُفْلٍ من التعيين، ولكنهم من خلال إختلاطهم بالمجتمه كانوا يشيعون حراكهم الشفويّ فيه، فينثرون بذلك حركة الوعي العلميّ بدرجات متفاوتة، و لسنا نرى في إطّراح النشر بالطبه عيباّ فيهم، فالشيخ الأفغانيّ على عظمته الفكريّة ، لم يترك وراءه إلا كتاباً واحداً هو الردّ على الدُّهْريين، ومثله الشيخ محمّد عبده الذي وضع رسالته في التوحيد فضلاً عن مئات الأبحاث المنشورة في مجلات إندثرت يسعى الباحثون الى إستنقاضها وجمعها في أسفار. والحق أن مشاغل المثقف الخاصّة و ظروفه الإستثنائيّة كثيراً ما تهدر وقته وتصرف همّته عن تدوين خاطراتها و حصيلة تجربته في كتاب، لو توافرت له ظروف الإعداد و الطبع لكان في ذلك خير للناس و التاريخ ولكن هيهات!
ترك أنطونيوس ينّي بعد موته أربعة اولاد: بنتين، بربارة وتيودورة، اللتين إلتقفهما زواج ألحقهما بنسب زوجيهما، وذكرين هما صموئيل الذي قضى عزيباً عام 1919م، وجرجي الذي مات حزيناً على وريث من صلبه لم يولّد. وهكذا أُسدل الستار على عائلة انطونيوس بوفاة جرجي بلا عقب، لكن الرجل المنكوب بوريثٍ لم يأتِ، أزهر قبل غيابه و بعده بما لا قِبَلَ لاحدٍ أن ينكر شميمه وشذاه: جُمْلةً من الأعمال الموضوعة والمنقولة غلى العربيّة، فضلاً عن مئات الأبحاث التاريخية التي أودعها صفحات مباحثه، وصفحات مجلتيذ الهلال والمقتطف في مصر من قبل. منها:
-إسكندر الثاني قيصر روسيا، تاريخ حرب فرنسا و ألمانيا، كتاب عجائب البحر و محاصيله التجاريّة (تعريب) تاريخ سوريا، وهو الأشهر وسنبين محتوياته لاحقا بإختصار شديد.
ومن مخطوطاته: تاريخ الآشوريين و البابليين، تاريخ فارس، تاريخ الماثوني العام(خمسة أجزاء) تاريخ سوريا المطوّل في واحد و ثلاثين مجلداً ويبلغ عدد صفحاته 6462 صفحة من القطع الكبير ومعجم الميتولوجيا.
تاريخ سوريا: طبع في بيروت سنة 1881م، وهو في السابعة و العشرين من عمره، وتشير محتوياته التي إستقاها من أكثر الأسانيد ثقة على علوِ كعبه في وضع كتابٍ كبير الحجم ناهزت صفحاته ال600، في مثل هذه السنّ المبكّرة. و يتألف من مقدمة بحث فيها عن الأحوال العموميّة في سوريا، ثم مجمل تاريخ الأمم السوريّة منذ الفينيقيين إلى ايامه، ثم أتبعه بإجمالً تاريخّ عن أشهر البلاد السوريّة، وقد تجلّت الجديّة بإعتراف مؤلفيّ كتاب"ولاية بيروت" بهجت و التميمي" اللذين قابلاه وقت إعداد كتابهما وهي جديرة بالذكر.
***
محمّد أمين الصوفيّ السكريّ و حكمت شريف
ومن العاملين على إثارة الحراك الثقافيّ في طرابلس الشام محمّد أمين الصوفيّ السكريّ باشكاتب مجلس إدارة طرابلس شام سابقاً و صاحب كتاب "سمير الليالي" وهو جزءان في مجلدً واحد، وكتاب "نور الالباب"، وهو مجموع مقالات تدور حول موضوعاتً شتّى. وقد ذُكر في المراجع التي عدنا إليها أنّ المؤلف قضى عام 1316ه/ 1898م دون ذكر تاريخ مولده الذي يتسامح الباحث فيه إذا أعياه التنقيب .أما وفاته في التاريخ المعلن فَوَهمٌ بدليل ان الرجل وضع مقدمة جديدة لسمير لياليه سنة 1327هـ/1909م وأشرف على طبعه في مطبعة الحضارة في طرابلس فكيف تصحّ كتابة مقدمة الطبعة الثانية بعد الوفاة بسبع سنين هجرية أو ثماني سنوات ميلادية؟ و على ذكر سمير الليالي لمحمد أمين الصوفيّ السكريّ تجدر الإشارة إلى أنه ينتمي في تآليفه إلى التنويع في موادّه، حيث لا رابط أحياناً بين الفصل و الفصل ولا تتابع في إستكمال موضعٍ ما برأسه. إنه أشبه شيء بكتاب الكشكول لبهاء الدين العامليّ الذي جمع معارف متعدّدة من مصادر شتّى، لا لشيْ إلا للإفادة و التسلية و إبعاد السآمة عن القارئ. فالسكري نفسه لا يدّعي وحدة التأليف في عملّه بل يصرّح في مقدمته قائلاً: هذا كتاب جمعت فيه ما عثرت عليه في غضون إنكبابي على المطالعة في أسفارٍ شتّى و جرائد و صحف متنوعة، وما وعاه سمعي من أفواه الأخيار وأحاط به علمي و نظري خلال الأسفار. وهو مجموع ما شِمْتُ من سبقني على أسلوبه و محتوياته و بدائع أخباره و لطائف مستظرفاته."
وقد حوى الجزء الأول كلاماً على أوروبا العثمانيّة وآسيا العثمانيّة و إفرقيا العثمانيّة، ومقدار نفوسها وألويتها وأقضيتها واماكنها ومعابدها. وفي الجزء الثاني تحدث بإيجازٍ عن أخبار الدولة الامويّة و العباسيّة و السرجقيّة و الحروب الصليبيّة، ثم عن الدولة العثمانية و سلاطينها، وعن الإنكشارية وحروب الدولة مع اليونان و الروس وغيرهم. وتشمل الأجزاء الباقية على غرائب الأخبار والمسموع من عجائب الأختراعات العصري، وحكايات علميّة و أدبيّة، وأمثال شعريّة ونثريّة وعاميّة، وتفسير بعض الكلمات الأجنبيّة المستعملة بالتركيّة، وألغاز وأحاجي، وحكايات ومناقب عن الصحابى الكرام... ويظل الكاتب في قسمه الثاني على منواله السابق في إيراد المفيد و المسلّي حتى يأتي الكتاب على خواتيمه. وكأن هذا النوع من الكتب مصدر إسعادٍ لقوم يتحلّقون في مطالع الليالي حول قارئٍ يتلو عليهم بالصورة و الحركة ما حفل به هذا الكتاب من تآريخ جرت على أرض المسلمين من عرب و عثمانيين في أزمان مختلفة، يتخللها نوادر وأفاكيه وحكايات غريبة، من هنا كانت تسميته "سمير الليالي".
وفي سياق هذا الحراك الذي زاد إستحراره، والقرن التاسع عشر يسير إلى نهايته، تدفق سيلٌ من الأعمال ذات الطابع التاريخيّ، منها ما أُعلن عنه بالطبع وقرأه الناس مستقلاً في كتاب، ومنها ما رآه الناس مختصراً في الجرائد الطرابلسية وكان متنه كاملاً حافظ على إنطوائه مخطوطاً في الأدراج المغلقة. ومن هؤلاء الحراكيين كان حكمت شريف الذي عاصر بعض أنداده السابق ذكرهم.
وفي هذا التسلسل الزمني لأمثال هؤلاء الحراكيين: نوفل وينّي والصوفيّ السكريّ و شريف نلاحظ ظاهرةً ربما لم يفطن إليها أصحابها و هي إكبابهم على دراسة التاريخ القديم و الحديث، والمحلي والخارجي، فلماذا؟ ترى هل كانوا يبحثون عن هوياتهم القومية أم الدينية، أم يؤكدون هويتهم العثمانية، في زمن كانت أوروبا نفسها تعيش عصر القوميات؟ نحن نعتقد أن أكثر هؤلاء قلقاً في موضوع البحث عن أنتماء نوفل نوفل. صحيح أن ثقافته الأجنبيّة كانت تركيا وأن إستخدمها لنشر أعمالٍ رسمية بقلمها كالدستور العثمانيّ، وهو عمل ضخم في مجلدين كبيرين و قوانين المجالس البلديّة واعمال تاريخيّة و قانونيّة. نقلها كذلك عن التركية كمعتقدات الأم الشركسية وكتاب حقوق الأمم المكتوب أصلاً بالتركية بقلم الكونت أوطوكار النمساويّ. غير أنه من ناحية ثانية وضع بالعربية كتباً تتناول الجوانب الدينية و الحضاريّة عن الامم القديمة و منها العرب وقدّ نستنتج من ذلك أن إنتماء الرجل في قرارة نفسه إنساني في خصوصية عربيّة، سواءٌ كانت تذكرته عثمانية أم مصرية، وأن دينه هو المسيحيّة المحمولة على البساطة و العقل بإنحيازه إلى الأنجيلية و موته عليها و تقديم مكتبته الثمينة إلى سدنتها في المدرسة الأنجيليّة السوريّة في بيروت.
ويلي نوفلاً في قضية الانتماء الديني والقوميّ جرجي ينّي، فهو في الاصل يوناني الجذور، أورثوذكسيّ المذهب على إنفتاح و تسامح، حمل عن ابيه التبعية الأمريكية ثم تخلّى عنها و إتخذ الجنسيّة العثمانيّة بديلاً. حار في إنتمائه المذهبي بين الأورثوذكسيّة المنفتحة و البروتسطانتية الأنقلابية، ورسا إيمانه في الدين في شاطئ أجداده التقليديّ على غير تعصب و تعنت وأقرب الظنّ ان إنتماءه الوطني كان سورياً في إطار الدولة العثمانيّة التي غلب الإسلام فيها على الإنحياز العرقيّ الطورانيّ في أول العمر، ولا عجب فتركيا مركز الخلافة، تحكم بإسم الإسلام ديناً وشريعاً امما شتى في آسيا و أفريفيا وأوروبا إختلفت قومياتهم و لغاتهم وأديانهم ومذاهبهم و عاداتهم وتقاليدهم. فمهما طال الزمن وغلت هذه الدولة في عُتُوّها فقد بدأت الأمراض تتناهشها بالثورات و الانتفاضات و حركات الإستقلال و الإطضرابات السياسية و الأجتماعية و الإقتصادية، وتضيق الدول الأوروبية الخناق عليها، فهي مقبلة على إنهيار أو تفتت تتوج سورية في أحدهما بإستقلال تام أو قريب من التمام. من هنا علينا أن نفهم وضع ينّي لعملين عن سوريا طبع الأول منهما في بواكير عطاءه، بينما ظلّ الثاني مخطوطاً، وهو الأهم، عن تاريخ سوريا (32 مجلداً) يعجز عن طبعه بل تعجز المؤسسات الكبرى اليوم عن إظهاره إلى النور.
أما محمّد أمين صوفي السكري وحكمت شريف فقد تذاوب الإسلام فيهما مع العثمانيّة إلى حد الشك بقدرة أن يكون الإنسان عثمانية وهو على دين آخر. فبنوا عثمان إعتنقوا الإسلام ديناً على نحو متشدد، ونقلوا خلاقته العربيّة إلى عقر عاصمتهم، وأشاعوه بإيمانٍ منقطع النظير في بلادهم والبلاد الواقعة في ظلهم، ففضله عليهم أنه هداهم، وإكرامهم له أنهم نشروه في كلّ صقع وصلت إليه اقدامهم. لذلك لا معنى لهم بلا إسلام، ولا إمتداد لإسلام قوي بدونهم. وعلى هذا إرتبط الإسلام عند الرجلين بالعثمانيّة فتشكّلت عندهم هوية واضحةٌ هي: الإسلام العثمانيّ. وقد تظهر هذه الهوية المزدوجة عند حكمت شريف أكثر من زميله محمّد السكريّ لكونه تركيّ الاصل، فهو حكمت شريف بن محمّد بك شريف بن محمّد أمين بك إبن همزة يكن زاده، وأمه تركيةٌ ، و يكن لفظة تركية معناها إبن الأخت، وتُلفظ كالجيم المصريّة. وفي العادة لا يكون هذا اللقب إلا لإبن أخت ملك أو أمير.. ونرجّح أن يكون حمزة باشا يكن إبن أخت أحد سلاطين بني عثمان.
وُلد حكمت شريف في طرابلس الشام عام 1870م على خلاف المصادر التي تزعم أنه أبصر النور سنة 1880، وأخذ علوم العربيّة والدينيّة من قرآن وحديث و فقهٍ على اعلام عصره كالشيخ محمود نشابة (ت 1890) والشيخ عبد الغني الرافعي (ت 1890) والشيخ عبد القادر الرافعي (ت؟؟) ونهل التركيّة في البيت وبعض المدارس الإعداديّة والفرنسيّةعلى بعض الأساتذة الخصوصيين، ولا نعرف أين نال شهادته العالية، وهو العارف العربيّة و التركيّة والفرنسيّة على قسط مقبول، فضلاً عن الفارسيّة والأورديّة. زاول فور تخرّجه التأليف و الكتابة الصحافيّة فراسل سبعاً وثلاثين جريدةً ومجلّةً عربية في لبنان و سوريا ومصر وفلسطين والعراق وبعض المهاجر الامريكيّة، وتعين لاحقاً باشكاتب المجلس البلديّ في طرابلس، ثم رئيساً لمجلس بلديّة اللاذقيّة حيث إقترن بإبنة مفتي المدينة الشيخ عبد القادر المفتي، فلم يعش له من الأولاد إلا ثلاث بنات. أصدر في طرابلس سنة 1907 جريدة الرغائب توقفت عن الصدور أيام الحرب العالمية الأولى لفقدان الورق و غلاء أسعاره.أعاد إصداره عام 1929 بالإشتراك مع محمّد محلوس، والمرجحّ انها توقفت نهائياً بوفاته عام 1948.
المطبوع من أعمال الرجل قليل بالقياس إلى ما ظلّ مخطوطاً بعد نجاة معظمه من الضياع، وقد فاق عدده الأربعين مخطوطاً منها :الآثار الحميدية في البلاد العثمانيّة، تاريخ الإنكشارية، تاريخ سوريا و لبنان، تاريخ فرنسا، تاريخ مسقط، الخلافة الإسلاميّة، الدولة العثمانيّة، تاريخ الأديان(32 جزءاً) وغيرها. ونلاحظ ما كنا هبنا إليه في عثمنيات الكاتب وإسلاميته المتشدّدتين، ضمن هذه المخطوطات، ثلاثة كتب على الأقل هي: الخلافة الإسلاميّة، الدولة العثمانيّة، وتاريخ الأديان الذي يعتمد فيه الكلام على الإسلام بإسهاب. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن الناظر في الكََمّ التاريخي مطبوعاً ومخطوطاً، الذي أكب على جمعه يتبين لنا أن حكمة شريف قد فاق معاصريه في حرث هذا الحقل، وإستصفى عن سابق تصور وتصميم خيار الانتماء إلى الإسلام العثمانيّ بلا ميراء. أما كتبه المطبوعة فأهمها: تاريخ زنجبار، تاريخ سيام، سياحة في التيبت ومجاهل آسيا وأخيرا كتاب طرابلس الشام من أقدم أزمانها إلى هذه الأيام.
بعد فاتحة الكتاب و ذكر مصادره و مراجعه يقسم المؤلف كتابه إلى سبعة أقسام يسمّي القسم الواحد منها روضةً: فالروضة الأولى وفيها سبع زبقات، والروضة الثانية وفيها ثلاث ورود وخمسة عشر زراً، والروضة الثالثة و فيها ثماني منثورات، والروضة الرابعة وقوامها ست نرجسات، والروضة الخامسة وتزينها ثلاث بنفسجات، والروضة السادسة بزهورها مختلفة، وأخيراً الروضة السابعة وهي ذات ثلاث رياحين طيبة العرف. والكتاب، بجملته، مجموع نقول متسلسلة في سياقها التاريخي ذكر حكمت مآخذها واحداً واحداً بأمانة متناهية إلى الحدّ الذي تضيع فيه بصمات المؤلف ضياعاً يكاد يكون شبه تام لولا تدخل وجداني محصور في جمل إعتراضية، في تأييد لدولة العثمانية ككقوله مثلاً: .... ورجعت إلى الدولة العليّة العثمانيّة الأبديّة القرار... ومولانا أمير المؤمين الغازي عبد الحميد خان الثاني، نصره الله وأدامه واعلى بالظفر أعلامه ومثل ذلك كثير جاراه فيه من قبل محمّد أمين الصوفي السكري و غلاه.
ولكن الجديد في هذا الكتاب الذي لم يأتِ على ذكره أحدٌ ممن كتبوا عن طرابلس هو مجموعات الملاحق المتعلقة بتوزيع مياه المدينة، وجداول نفوس لواء طرابلس الشام ومساحته، وآخر مخصص بسكان المدينة فقط، وجدول دخلِ وخَرجٍ لواء طرابلس عن سنة 1322 مالية، وجدول أغنام اللواء سنة 1322 مالية، وآخر خاص بالحيوانات الاهليّة، وسابع جدول الطرق و الجسور الموجودة في اللواء... وأسماء القرى الملحقة باللواء الخ.. وهذه كلها بيانات مبنية على إحصاءات تمكن من الحصول عليها من موقعه الرسميّ في البلديّة ومأموريّة المراقبة، الأمر الذي لم يتيسر لغيره من أحتيازها، أو لذهول هذا الغير عنه لعمومية التأليف عن البلاد السورية كجرجي ينّي في كتابه الآنف الذكر، بينما كان كتاب حكمت شريف معقود اللواء على إسم طرابلس وحدها....
وخلاصة ما نستطيع أن نقف عليه من هذا العرض السريع للأربعة المؤرخين في شأن الإنتماء و تحديد الهوية أنهما مختلفتان عند نوفل و ينّي، فالأول مسيحي متحرر في دينه، إنسانيّ أو عربيّ في هويته، وبين أورثوذكسي منفتح في مذهبه، سوريّ في قوميته، أما محمد أمين الصوفي السكري وحكمت شريف فمتفقان في إسلامهما السني و في إنتمائهما القوميّ، الأول لكونه عثمانيّ الجنسيّة، والثاني بإعتباره عثمانياُ في هويته وتركياً في أصوله وقوميته، وهكذا جمع الإسلام العثماني بينهما على إختلاف في الإنتساب وإئتلاف في النتيجة و الغاية.
جمعية العزم والسعادة المركز الثقافي
الاجتـماعـية للحـوار والدراسـات
مؤتمر
طرابلس عيش واحد
ـــــ
لطف الله خلاط، الأهل والمدينة
عاطف عطيّـه
مدير معهد العلوم الاجتماعية
الجامعة اللبنانية
فندق كواليتي إن، 27 و 28 آذار 2009
لطـف الله خـلاط
الأهل والمدينة
عاطف عطيّـه
معهد العلوم الاجتماعية، الجامعة اللبنانية
عندما أصدر لطف الله خلاط جريدة "الحوادث" في 7 كانون الأول 1911 كان يتقاسم قراءَ مدينة طرابلس صحفٌ عديدة لم يصمد منها بحلول 1930 إلا صحيفتان: جريدة "طرابلس" لمؤسسها محمد كامل الجيري، و"الحوادث" التي بقيت مستمرة في الصدور، يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، على مدى أكثر من أربعين عاماً، عدا معوقات الحربين الأولى والثانية.
ظلت "الحوادث" المنبر الوحيد الذي من خلاله أطلّ لطف الله خلاط على مدينة طرابلس، والوسيلة الوحيدة التي نشرت أفكاره الاجتماعية والسياسية والدينية المخصصة، أولاً وأخيراً، لمدينة طرابلس. وتحمل جميعها الهم الذي يشغل تفكيره تجاه هذه المدينة. فجاءت جميع مقالاته وكأنها الأجوبة عن مجمل التساؤلات التي كان يحملها الصحافي في كيفية الخروج من مأزق التخلف إلى رحاب التقدم والحرية. حتى أن المقالات التي تبحث في الشؤون الصحافية العامة، وفي مجال المقارنة بين الشرق والغرب أو بين أحزابنا وأحزابهم، أو بين تقاليدنا وتقاليدهم، ما كانت لتكتب على هذا الشكل إلا لإظهار، وإن بشكل غير مباشر، المشاكل التي تتخبط فيها مدينة طرابلس، ووضعها في إطار وعي سكان هذه المدينة ووعي المسؤولين فيها. لذلك يمكننا القول أن مدينة طرابلس كانت المحور الرئيسي لكتابات لطف الهة خلاط الصحافية. ومهما تنوعت هذه الكتابات وتعددت اتجاهاتها، من شؤون الحياة المباشرة التي تعني طرابلس، إلى البحث في الشؤون السياسية العامة، مروراً بقضايا التعليم، وحقوق المرأة، والممارسة السياسية وعلاقتها بالأقليات؛ كلها قضايا ومواضيع كانت محط اهتمام لطف الله، ومجال عنايته في الكتابة الصحافية التي تحمل في طياتها الاهتمام بطرابلس. وكأنك تقرأ بين سطور هذه المقالات الهم الخاص بكيفية النهوض بالمدينة وأهلها. وهي على اختلاف مناحيها، تعبر عن مسائل عامة لتضيء الجوانب المظلمة في المسائل الخاصة بمدينة طرابلس، علماً أن المقال في ذلك الحين كان يلقى تجاوباً رسمياً وشعبياً كبيراً أكثر من ألف مقال تكتبه صحف اليوم، على حد تعبير لطف الله نفسه .
طبعاً هذا لا يعني أن الاهتمامات السياسية المحلية والإقليمية والدولية لم تكن تعني لطف الله، بل على العكس. فإن هذه الاهتمامات تبلورت ونمت نتيجة الموقع الصحافي الذي احتله خلاط في طرابلس؛ وهو الموقع الذي تخطى في اهتمامه الجانب المطلبي الحياتي الملحّ كفرد ينتمي إلى أقلية تطالب بحقوقها وحريتها، وبالتعبير عن شخصيتها، دون عقد نقص، في بحر متلاطم من الأكثرية. ومن هذا الموقع أبدى رأيه في مسألة الانفصال والاتصال، وفي الانتداب وما يجب أن يكون، وفي الدستور وغيرها من المسائل السياسية.
ومن الموقع ذاته، بحث في عمق المشاكل التي تعاني منها طائفته، ونقد الأساليب التي يستعملها الرؤساء الروحيون لهذه الطائفة، وأظهر تصرفاتهم وأبرز سلوكهم العام والخاص لتكون "الرعية" على بيّنة من أمور مسؤوليها، فتستقيم الطائفة بالوعي وتثبت بالتماسك وتتقوى بالوحدة لتلعب دورها الروحي والسياسي في دولة لا وجود فيها إلا للطوائف، ولا سلطة فوق سلطة الطائفة.
أولاً: لطف الله خلاط الصحافي
تناولت اهتمامات لطف الله الصحافية شتى المواضيع الفكرية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية. وكان يرمي من ورائها تثقيف القارئ وحثّه على التفكير في القضايا الحيوية التي تهمه، وفي المسائل التي تحرك العالم حوله، وتشجيعه على تغيير بنيته الذهنية المحكومة بالانتماء الديني والمذهبي وحدهما. لذلك فقد كثرت مقالاته في معنى الوطنية، و في مهام الأحزاب وسبب الحروب، والمصالح التي تحكم توجهات القائمين بها، وأهمية الاقتصاد في حياة الشعوب، وفي مضار التعصب، ودور المرأة، وأهمية التعليم الوطني (الرسمي) ومضار الامتيازات الأجنبية، ومدى حاجة المدينة للمشاريع الاقتصادية، وأهمية المؤسسات الحكومية، ومراكز الاستقطاب الاقتصادية والثقافية، في ازدهار المدينة.
ما كتبه لطف الله في الشؤون العمومية مستوحى من الوضع الذي كان يسود طرابلس من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وما يريد التوصل إليه هو لفت نظر سكان المدينة ـ عامتهم والخاصة ـ وإثارة انتباههم إلى ما يجب أن يكونوا عليه من حس الوطنية السليمة المتخطية لأي انتماء آخر، طائفياً كان هذا الانتماء أو دينياً. وما كتبه في هذا المجال لم يكن سوى المقدمات الموصلة إلى قلب الاهتمام الذي طغى على أي شيء آخر: إنه الاهتمام والانشغال التام بمدينة طرابلس، المدينة التي يريدها أن تكون فعلاً درّة مدن الشرق وعروس البحر المتوسط.
اختط لطف الله لنفسه سبيلاً واضحاً ومحدداً في نضاله لنصرة المدينة التي ينتمي إليها، وفي الدفاع عن حقوقها ومطالبها التي لا حياة لها بدونها. وقد اعتبر على مدى أربعة عقود أنها تقع على عاتق أبنائها. فعليهم إذن، أن يعملوا ما بوسعهم للنهوض بها، وأن يبذلوا الغالي والرخيص لنصرتها لأنها إذا اعتمدت على المسؤولين المهملين لحاجاتها، في وقت تقاعُس أبنائها، تكون كمن سلك طريق الموت لا محالة، لأن توقف الزمن بالنسبة إليها، واستئنافَه المسير بالنسبة لغيرها يعني الموت لها كما يعني الحياة لغيرها، وشتّان ما بين الحياة والموت.
يعتبر لطف الله خلاط أن موضوع الأمن هو مفتاح نجاح الحياة الاقتصادية وازدهارها. وتنوع المشاريع وتوسعها نتيجةٌ هامة من نتائج استتباب الأمن. كما أن هذا الأخير سبب مباشر وحاسم في منع تفاقم مشكلة الهجرة. وفي هذه المواضيع الهامة كتب المقالات، وحلل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدينة طرابلس، وفي المناطق المتاخمة لها. وركز في البداية على توفير عوامل الاستقرار بتوفير الأمن وسبل العمل. ولا يتم ذلك، برأيه، إلا بتوفير رؤوس الأموال. وهي متوافرة في أيدي السكان وعناصر البنية التحتية التي تقع مسؤولية تأمينها على عاتق الدولة. والبنية التحتية، في حال وجودها، تؤمّن فتح المشاريع الاقتصادية بتحريك رؤوس الأموال وتوظيفها. ولذلك فقد بدأ يعالج المواضيع الحيوية التي لا يمكن لطرابلس أن تنهض من دونها. وأوقف افتتاحيات جريدته لمعالجة هذه المواضيع بجرأة وشجاعة نادرين، مؤمناً أن أي مطلب لا يمكن أن يتحقق إذا لم يقف وراءه المطالبون به، وإذا لم يناضلوا ويضحوا من أجل تنفيذه. لذلك خصص الكثير من المقالات لمهاجمة الطرابلسيين ـ وجهاء وعاديين ـ لتقاعسهم عن النضال في سبيل طرابلس وتقدمها ورقيها، ووصل به الأمر إلى حد التقريع .
لم يبقَ لطف الله في إطار العموميات بل تعدى ذلك إلى تحديد بعض المشاريع التي يمكن أن تضع طرابلس في طريق الازدهار والتقدم. ففي إحدى مقالاته يسرد بعض المشاريع الاقتصادية والعمرانية كاقتراحات يمكن للدولة باهتمامها، وللطرابلسيين بأموالهم، أن ينفذوا بعضها، منها:
- إنشاء الخطوط الحديدية بين أهم المدن السورية.
- إنارة طرابلس بالكهرباء وإنشاء ترامواي كهربائي.
- تمديد الترامواي بين البترون وطرابلس.
- تأليف شركات كبرى تجارية وصناعية وزراعية.
حتى أنه قدم مشروعاً سياحياً ضخماً قوامه إنشاء بحيرة اصطناعية في المنطقة الممتدة من المطل الأخضر ودير الناطور، يستفاد منها بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، وبناء المنتجعات السياحية على جوانبها يمكن أن تمتد لتصل إلى الشاطئ . ولا داعي للتذكير أن هذا المشروع نفذ على مدى نصف قرن، ولكن باستبدال البحيرة الاصطناعية، التي لا فائدة منها إلا لتوليد الطاقة الكهربائية، بمحطة حرارية (الحريشة)، واستبدال المنتجعات السياحية حولها بمنتجعات على طول الشاطئ من البحصاص إلى شكا.
لم يكتف لطف الله بسرد هذه المشاريع، بل حاول أن يبين الأسباب التي تمنع تنفيذها، في الاجابة عن سؤال كان عنوان مقالة هامة تدخل في عمق بنيتنا الذهنية- الثقافية "لماذا تحبط مشاريعنا العمومية؟" ويجيب، هذه هي الأسباب:
- الفردية والخصوصية في الشرق، والجهل بطبائع العمران القائم بالتعاون.
- فقدان الثقة وعدم التروي.
- الحماسة القصيرة النفس وحب الأثرة والأنانية.
- عدم المحافظة على القانون والنظام في الأعمال.
- إنكماش الناس، ولا سيما الأغنياء، عن تنفيذ المشاريع العمومية.
أما أهم المواضيع التي يعالجها لطف الله في افتتاحيات جريدة "الحوادث" منذ بداية ظهورها في ما يتعلق بمدينة طرابلس، فهي:
أ- المياه: ناضل لطف الله من أجل إيصال المياه النظيفة إلى بيوت المدينة منذ بداية اشتغاله في العمل الصحافي وحتى تنفيذ مشروع مياه طرابلس. وكان ينتقد السكوت عن تعكر المياه وعدم صلاحها للشرب عند أول هطول للمطر، واحتوائها على شتى الأقذار. لم يكتف بالانتقاد بل اقترح على البلدية تنفيذ جر مياه رشعين إلى طرابلس في قنوات. وعندما لم يجد آذاناً صاغية بدأ بتقريع الطرابلسيين لإهمالهم شأناً هاماً من شؤون حياتهم "أين أنتم أيها الطرابلسيون لا أستثني منكم أحداً " .
ب- الخط الحديدي والمرفأ: بدأ اهتمام لطف الله بهما منذ سنة 1913. وقد حث الناس على المطالبة بتحسين أوضاع مدينتهم والعمل على القيام بنهضة اقتصادية زراعية وسياسية تسمح بادخار مبالغ كافية من المال تساعد على إنشاء المرفأ دون الحاجة إلى الحكومة، أو ذل السؤال. ويقترح الطريقة الفضلى لتأمين المبالغ اللازمة للقيام بالمشروع الذي لا حياة لطرابلس بدونه. ويعتبر أن الدواء الذي يمكن أن يشفي طرابلس وينعش اقتصادها هو تنفيذ مشروعي المرفأ والخط الحديدي، مؤكداً أن المنفذ الطبيعي لنفط العراق هو في طرابلس . وكان أن امتدت حياة لطف الله إلى الفترة التي رأى فيها إنشاء مصفاة نفط العراق I.P.C بعد مطالبته تلك بربع قرن. وبقي مصراً على توسيع مرفأ طرابلس وتعزيزه بإنشاء المقالات بقالب من المعاتبة المبطنة، فيقول: "هل في طرابلس أوبئة"؟ أليس عاراً أن يكون ميناؤها خالياً من البواخر، وقد كان في عهد الأتراك حافلاً بها؟ أيرضى الانتداب أننا نسير إلى الوراء ؟
ج- المدرسة الوطنية والإرساليات الأجنبية: انصرف لطف الله باكراً إلى معالجة مسألة التعليم من خلال الاهتمام بتأمين العلم للفئات المتوسطة والفقيرة التي لا تستطيع تأمين الأقساط الباهظة في مدارس الإرساليات الأجنبية، ما يعني وجوب الاهتمام بفتح المدارس الوطنية (الرسمية) لتأمين التربية الوطنية لطلاب من مذاهب وأديان مختلفة لا يتم انصهارهم في بوتقة وطنية واحدة، ولا يتبلور انتماؤهم الوطني إلا إذا تلقوا التعليم والتربية في مدارس وطنية تغرس في نفوسهم هذه القيم بعكس مدارس الإرساليات الأجنبية التي تأخذ أكثر مما تقدم من ضروب العلم والمعرفة. كما اعتبر أن فتح المدارس الوطنية لا يكفي إذا لم يرافقه اهتمام باللغة العربية التي هي عنوان كرامة الناطقين بها ورمز قوتهم .
د- الهجرة: كانت مسألة الهجرة من المسائل الهامة التي عالجها لطف الله في مقالاته الصحافية، ففي فترة ظهور الجريدة كانت البواخر ترسو على مقربة من الشاطئ لتبتلع خيرة شباب المدينة والجوار. فبدأ بمعالجة الموضوع منذ 1912، مبيناً مخاطر الهجرة في إفراغ البلاد من خيرة شبابها، وتأثير ذلك على بوار الأرض وتقهقر الزراعة. إلا أن كثيراً ما طالب بفتح باب الهجرة إذا كان لا بد من الاختيار بينها وبين الموت. وكثيراً ما كان يجري المقارنة بين ما نصدّره إلى العالم: الرجال والشباب منهم بخاصة، وما نستورد منه (البضائع). وكان يخلص دائماً إلى نتيجة مفادها أن لا حل لهذه المشكلة إلا بانشاء المشاريع الاقتصادية والزراعية بشكل عام، لأن مقاومة الهجرة لا تنجح إلا بترويج الأعمال .
ه- الغلاء والضرائب: اهتم لطف الله بظاهرة الغلاء وفداحة الضرائب من خلال عقد المقالات التي تدافع عن المزارعين غير القادرين على دفع الضرائب. وتنتقد عدم الاهتمام بالتسعير لوقف موجات الغلاء التي لا سقف لها، وتطالب بمراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين. كما دافع عن الطرابلسيين ـ ملاكين ومزارعين ـ عند استحداث ضرائب جديدة، وخصوصاً ما يتعلق منها ببساتين الليمون .
و- الإدارة والقضاء: تناولت مقالات لطف الله الوضع الإداري والقضائي في المدينة. فبين فيها ما يجب أن يكون عليه المجلس البلدي في نظرته إلى المدينة، والأساليب التي يمكن أن يتبعها للنهوض بها في شتى الميادين من أجل أن تبقى نظيفة، ومن أجل أن يبقى المجلس في خدمتها، وفي سبيل تقدمها وتطورها. وبقي على هذا النهج إلى الوقت الذي وجد طرابلس تسير القهقرى بقرارات مركزية تزيل عنها صفات مركز الاستقطاب تدريجياً وفي كل المجالات. فبالإضافة إلى عدم تميزها بوجود مرفأ، ومحطة قطارات كبرى، وغلاء الرسوم فيها عن بقية المناطق، صدر قرار بجعلها متصرفية مستقلة، على غرار متصرفية بيروت، ولكن دون التمتع بالامتيازات نفسها. كما صدر قرار آخر بنقل مركز متصرفية الشمال إلى زغرتا، بالإضافة إلى إلغاء المحكمة الاستئنافية وغيرها. كل ذلك جعل قلم لطف الله يصول ويجول في نقد هذه الأحوال التي أوصلت المدينة إلى شفير الموت بالعزلة، وإلى حد الإختناق بسد المنافذ كافة التي يمكن أن تتنفس منها اقتصادياً وقضائياً وسياسياً وإدارياً.
بعد ثلاثة عشر شهراً من صدور جريدة الحوادث، كتب لطف الله مقالة هامة بمناسبة انتخابات البلدية، وذلك في 16 شباط 1913، يصوّر فيها ما يجب أن يكون عليه المجلس البلدي العتيد الذي هو في كل الأحوال "صورة مصغرة لأهل البلدة فإذا كانوا راقين رأيته راقيا،ً وإذا خاملاً معوجّاً أُحكمْ على أهل المدينة ـ ولا تخشَ بأساًـ بالخمول و الاعوجاج". ويبين حاجة المدينة الماسة إلى رجل مستقيم يهتم بخدمة المصلحة العامة ونفع الوطن لا خدمة المصالح الخصوصية. ويعدد، بالمناسبة، أهم الإصلاحات التي تنتظرها المدينة من رئيس بلديتها.
أحس لطف الله، بعد الانتداب، أن طرابلس مستهدفة بعد سلخ مناطق من لوائها، ومن ثم نقل مركز المتصرفية من طرابلس إلى زغرتا. فاحتج على إضعاف المدينة وعلى نقل مركز المتصرفية، وصوّر الأمر في مقالة مطولة له وكأن سكان لواء طرابلس جميعهم يبكون، وزغرتا وحدها تضحك .
بقي لطف الله خلاط على موقفه هذا يدبّج المقالات إلى أن عادت مكاتب المتصرفية إلى طرابلس. فهلّل لهذه العودة، وأظهر دور الصحافة الحرة ودور الشعب المتيقظ الحر في إصلاح أحوال الحكومة. إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، إذ إن الحكومة عملت على إلغاء المحكمة الاستئنافية وأبقت على المحكمة البدائية. هذا الأمر، زاد من حدّة المقالات التي كتبها في الدفاع عن حقوق طرابلس، وفي التعبير عن مطالبها، ومنها مقالة "لهم آذان ولا يسمعون"، تناول فيها جملة القضايا التي تهم الطرابلسيين، ومنها قضية إلغاء محكمة الاستئناف .
كان لاهمال طرابلس ومطالبها الحيزُ الكبير في "الحوادث" بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وعودة لطف الله من المنفى. فأنشأ المقالات التي تطالب بالخدمات لها منبهاً الطرابلسيين إلى أن يفضلوا مدينتهم عن أي شيء آخر؛ ما يعني العمل على نهضتها في شتى الميادين، وعلى مختلف المستويات، لأن المسؤولين في الحكومة يعملون على نهضة العاصمة على حساب طرابلس. وكأن إهمال طرابلس مقابل العناية ببيروت مقصود علماً "أن طرابلس هي منبت العلم والعلماء منذ القديم، فحرمتها منها (بيروت) وتمتعت دونها بفوائدها" . ولم يقتصر انتقاد لطف الله على الحكومة، بل وصل إلى أهل المدينة الذين لا يتحركون لرفع شأن مدينتهم في أي مرفق. ويلفت نظرهم إلى الإفلاس الذي يهدد المدينة إذا بقي كل شيء يأتي من بيروت ، وخصوصاً عندما وجد أن نتيجة الاهتمام ببيروت، والجوار، الإنارة بالكهرباء، بينما طرابلس تغرق في الظلام .
ثانياً: لطف الله خلاط السياسي
كان العمل الذي بدأ لطف الله بممارسته من موقعه في جريدة "الحوادث"، نتيجة من نتائج الانقلاب العثماني الذي أطلق حرية القول والتعبير. فاتخذ من تحليله للمواقف السياسية الناجمة عن الوضع العام للسلطنة، الباب الذي دخل منه معترك الحياة السياسية. ودفعه إلى معالجة هذه المسائل على المستوى الداخلي، حسٌ فطري بقرب الانهيار. فكتب المقالات التي تدعو إلى مواجهة المرحلة المقبلة، وإلى معرفة الأسباب التي أدت إلى انحطاط الدولة وتفككها من أجل معالجتها، إذا كان المسؤولون يريدون النهوض ببلادهم فعلاً لا قولاً.
وجد لطف الله أن أولى الخطوات الواجب اتباعها في مسيرة التقدم هي تأمين العدل والاتحاد بين مختلف العناصر المشكلة للسلطنة العثمانية. وهو يقول ذلك انطلاقاً من فهمه الدقيق لمعنى السياسة التي لا قلب لها ولا دين ، ومن الواقعية في العمل السياسي بحيث تتولد المواقف من المستجدات الحاصلة، وإن كان أساس هذه المواقف مغروساً في عمق الانتماء إلى وطن لا يتأثر بالتبدلات الحاصلة ولا بالمتغيرات المستجدة إلا بما يخدم تمتين هذا الانتماء وبلورته. وأول هذه المواقف العمل الجدي في وجه الغزو الأوروبي. فهو يلحظ بأم العين أن الغرب يزحف بثبات وثقة في قلب السلطنة متوسلاً الوسائل كافة لبلوغ أهدافه. ولا يجد من يقف في وجهه إلا الكلام واستنهاض الهمم على أساس الانتماء الديني، دون مجيب. ويطرح الحل على موجة الانتماء الوطني، وتنشيط الحزبية العثمانية و"السير على منهج سوي في خطتنا السياسية وبنهضة فكرية في الشعب لتأسيس وطنية ثابتة يشترك بها كل فرد اشتراكاً حقيقياً مع حفظ مبدأ قوميته وعنصره" .
لم ينظر لطف الله إلى مسألة الانتماء العثماني نظرة المناور من أجل ذر الرماد في العيون والظهور على غير مظهره الحقيقي. بل كان يعتبر نفسه عثمانياً مخلصاً في وقت كان ينظر إلى المسيحيين الأرثوذكس على أنهم الرعايا الأكثر قرباً من مركز السلطة العثمانية بالإضافة إلى أنهم لم يطرحوا مشروعاً سياسياً في الانفصال عن الدولة العثمانية كما فعل المسيحيون الموارنة في تنظيرهم للقومية العربية مقابل الجامعة الإسلامية العثمانية، ومن ثم للقومية اللبنانية مقابل القومية العربية الاسلامية، عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى.
أ- الإصلاح السياسي والإداري: انطلق لطف الله في طرحه لمسألة الإصلاح السياسي والإداري من موقع انتمائه إلى أقلية تعيش في كنف الأكثرية وفي ظل غياب شبه تام عما يمكن أن يشكل وطناً يعيش فيه المواطنون سواسية أمام القانون. هذه المسألة ألقت بثقلها على توجهه في تحليلاته السياسية، معتبراً أن سكوت الأقلية عن حقها يشكل ضرراً للدولة، إذ إن لكل فئة الحق بانتقاء ممثليها. لذلك فهو يضع الأقلية أمام أمرين لا ثالث لهما. إما أن يكون لهم الحق بالاشتراك الفعلي في المجلس التمثيلي كعثمانيين صادقين، أو لا يكون. فإذا كان لهم الحق يجب أن ينالوه لا منّة ولا تفضلاً، بل لأنه حق أسوة بغيرهم. وإذا لم يكن لهم الحق فأين دعوى المساواة ؟ ويبقى هاجس المساواة مسيطراً عليه، فيكتب المقالات الرمزية في ثنائية لا تنتهي: القوي والضعيف، الأقلية والأكثرية، الحاكم والمحكوم، الحكم والمعارضة، مطالباً بحرية العمل السياسي التي تعني القضاء على الاستبداد وتمجيد الحرية والافساح في المجال للمعارضة لتمارس نشاطها ليحصل التوازن في العمل السياسي. ويعتبر أن أية محاولة لابتلاع الأقلية من قبل الأكثرية تعرّض الدولة لخطر التفتت، ومن ثم الزوال . ويحدد ما يمكن أن يصيب الأقلية في التمثيل، إن كان على مستوى الانتخابات البلدية أو النيابية. فعلى المستوى الأول، يشكو من نتائج انتخابات المجلس البلدي في طرابلس التي أدت إلى فوز مسيحي واحد، وهي مجحفة. وطلب إحقاق الحق وليس من أجل مركز فحسب، بل من أجل شيء أهم من ذلك بكثير، وهو الشعور بالمساواة في الوطنية لا قولاً، ولا قانونياً فقط، بل واقعاً وممارسة أيضاً. هذا الرأي أنتجه واقع سياسي محدد تجلى في النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية، وأسرفت عن فوز عضو بلدي واحد من أصل اثني عشر عضواً مع أن النسبة العددية تفرض لهم الثلث أو الربع على أقل تقدير. ومن أجل دفع هذا الغبن أقترح ترك ثلاثة مقاعد للمسيحيين يشغلها من نال الأكثر من الأصوات على أن يعمل بالنسبة العددية لاحقاً .
ومن أجل المساواة الفعلية بين المواطنين شعوراً وممارسة، طلب بإعادة النظر في أسس التربية الوطنية ليصل الإصلاح إلى القاعدة، إلى عامة الناس الذين ينظرون إلى الشؤون العمومية نظرة عنصرية، كي لا يبقى محصوراً بين دعاته فقط. ولا سبيل إلى ذلك إلا بهدم الحواجز الطائفية شيئاً فشيئاً، وذلك بالتربية والتعليم والامتزاج .
كان لطف الله يعي تماماً التوجه السياسي المؤسس على الانتماء الديني والعزف على وتر الدين في سبيل الغايات السياسية. لذلك لم يتوقف كثيراً أمام هذه الممارسات، بل تابع نشاطه بإبراز أهمية التمثيل الشعبي في الحكم، وإن كان الشعب لا يزال غير مهيأ لمثل هذا النوع من الممارسات السياسية. وهذا ليس بسبب علة ذاتية فيه، بل بسبب وجود الأحزاب المعبرة عن آرائه والمتناحرة فيما بينها لأسباب شخصية لا علاقة للشأن السياسي بها، من حيث هو حكم ومعارضة يلتقيان على خدمة المصلحة الوطنية العليا. كما تابع بمطالبته بوجوب تعديل قانون الانتخابات ليصير أكثر إنصافاً للأقليات.
ومن أجل البدء بتنفيذ السياسة الإصلاحية، ومن أجل الدفاع عن حقوق الأقليات من مناصري العرب، وتأمين وصولهم إلى مجلس النواب (المبعوثان) بطريقة تكفل مشاركة المسيحيين بقناعة وحماس في السلطة السياسية، والعدالة في نسبة تمثيلهم، دعا لطف الله خلاط إلى إنشاء حزب سياسي مسيحي يدافع عن حقوق المسيحيين .
جملة هذه المواقف أودت بثلاث سنوات من عمر لطف الله خلاط في المنفى. وبعودته منه وبانتهاء الحرب، استأنف نشاطه السياسي من خلال افتتاحيات جريدة "الحوادث". وبتغير الظروف الدولية وانتصار الحلفاء الذي يعني بشكل من الأشكال انتصار العرب، وما يلي ذلك من إمكانية إنشاء دولتهم المستقلة، تغيرت نظرة لطف الله، ونحَتْ سياسته منحى جديداً أنتجتها الظروف السياسية الجديدة. فالدعوة إلى الإصلاح واللامركزية السياسية والإدارية لم يعد لها أية فائدة بزوال الظروف المنتجة لها، وحلّت محلها دعوات جديدة أفرزتها الظروف الجديدة. إلا أن الثابت الوحيد الذي لم يتغير قي سياسته هو المطالبة بحقوق الأقليات ووجوب تمتعها الفعلي بالمساواة تحت أي ظرف من الظروف المحلية والدولية. وقد اعتبر أن الدفاع عن حقوق الأقليات يمثل نهجاً لا يمكن أن يتغير. وقد عبّر عنه بقوله: "أينما نادت الأقليات فنحن لندائها مؤيدون" .
عندما احتدم الخلاف بين الطرابلسيين حول انفصال طرابلس عن لبنان أو اتصالها بسوريا؛ وهو الخلاف الذي وصل إلى حد تطيير البرقيات المؤيدة لهذا الجانب أو ذاك، وجد لطف الله نفسه مدفوعاً إلى الإلحاح في مقالاته لبتّ هذه المسألة الخطيرة المنذرة بأوخم العواقب، وذلك لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، وإرغامهم على قبول القرار، منعاً لزيادة الانقسام وحسماً للخلاف المهدد لوحدة المدينة.
ب- أسس المواطنية: كانت الحوادث منبراً حراً لآراء لطف الله خلاط السياسية، إن كان على المستوى المحلي للمدينة، أو خارجها. وكانت المنبر الذي يدعو من خلاله إلى الوقوف بكل جرأة وإخلاص في الموقع الوطني الصحيح، إن كان بالنسبة للامركزية السياسية في عهد السلطنة العثمانية، أو المطالبة بالاستقلال عن هذه السلطنة بانتهاء الحرب العالمية الأولى على أساس اللامركزية. وهو لم يهمل، في كل الظروف، المطالبة بحقوق الأقليات الدينية والإتنية بممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والدينية على قدم المساواة مع الأكثرية، إتنية كانت أو دينية. وكان مؤمناً حقاً أن هذا هو السبيل الوحيد للقضاء على عقدة الشعور بالنقص، أو التفوق، المدمرين لوحدة الانتماء الاجتماعي المتجاوزة، في نظره، أي انتماء فرعي، دينياً كان أو إثنياً. وهو بذلك يكون من القائلين، منذ وقت مبكر، بالعمل على فصل الدين عن الدولة، على قاعدة الدين لله والوطن للجميع. ولا يتم ذلك، بنظره، إلا بالشعور الذي يجب أن يمتلك أية أقلية طائفية أو إثنية بأنها متساوية بحقوقها وواجباتها مع الأكثرية ومن موقع انتمائها ذاك. فتكون بذلك، كل طائفة قوية متماسكة على مستوى الداخل ترتبط فيما بينها بروابط روحية متينة، وتشعر من خلالها بوجودها الروحي وبكرامتها كطائفة دينية لها طقوسها وطرق عبادتها وإيمانها. وعلى مستوى الخارج، بروابط اجتماعية وسياسية مشتركة تربطها بغيرها من الطوائف المشكلة بمجموعها الشعب الذي ينتمي إلى وطن يعمل الحكم فيه على شد أواصر العلاقة فيما بينه، وبلورة القواسم المشتركة التي يجمع عليها المواطنون بصرف النظر عن انتمائهم الديني والطائفي .
ج- النظام السياسي: لعل أهم ما عبّر عنه لطف الله في ما يخص النظام السياسي اللبناني المؤسس على الطائفية هو اقتراحه لقانون انتخاب يقوم فعلاً على الأساس الطائفي، ويحفظ فعلاً حق الطوائف طالما لا بد من التمثيل الطائفي. فإذا كان التمثيل يقوم على الأساس الطائفي فهذا يعني، حسب قوله، أن الطائفة هي التي عليها أن ترشح ما ترى فيه الكفاءة في تمثيلها كما تفعل الأحزاب في البلاد الأخرى "لأن طوائفنا أحزابهم".
يقول لطف الله هذا الكلام وهو يدرك تماماً أن الطريقة التي يترشح فيها مرشحو النيابة في طرابلس توصلهم إلى الندوة البرلمانية بأصوات الأكثرية التي هي أصوات من غير طائفة بعض المرشحين. ما يعني أن نجاح المرشح المسيحي مرتبط بأصوات المسلمين بصرف النظر عن تمثيله لطائفته أم لا. هذا ظلم باعتبار لطف الله، ملحق بالطائفة - الأقلية، وهو معروف بدفاعه عن الأقليات إلى أية طائفة انتمى هؤلاء. ويتساءل في هذا الصدد: هل الطائفة عندنا فعلاً هي بمثابة الحزب؟ وهل اجتمعت كل طائفة من الطوائف على تقديم مرشحيها؟ وهل استقلال المرشحين في الترشح مطابق لقانون الترشيح المستفاد من التمثيل الطائفي؟ ويجيب: "قد يفوز من لا ترضى عنه طائفته، أو الأكثرية الساحقة فيها، فكيف يجوز أن يمثلها؟ لذلك قدم اقتراحاً هاماً منذ 1925 يقضي برتشيح الطائفة لعدة أشخاص لأنه من الصعب، إذا لم يكن من المستحيل، اتفاق الكلمة على مرشح أو اثنين. فإذا فاز أحد هؤلاء المرشحين أو أكثر من واحد، حسب العدد المقرر في كل دائرة انتخابية، اعتبر ممثلاً فعلياً لطائفته (أو ممثلين) قبل أن يكون للوطن .
ثالثاً: لطف الله خلاط المصلح الديني
من المهم التأكيد، قبل البحث في الجانب الديني من نشاط لطف الله خلاط، على صعوبة الفصل بين الجوانب المتعددة لآرائه ومواقفه العملية. ولا يمكن أن نفهم ممارسته هذه، إن كان في مهنته كصحافي، أو صاحب رأي واضح وصريح في مسائل سياسية مطروحة بجدة، إذا لم نرد هذه الممارسة إلى منبعها الديني من حيث هو إيمان صادق برسالة سماوية لا يظهر صدقها بالكامل إلا بالتطابق التام بين الإيمان والممارسة. لأن العمل بنظره، ومن أي نوع كان، لا يمكن أن يكون عملاً صالحاً إذا لم يكن مؤسساً على الإيمان الديني. وهو الايمان الذي يتجلى في ممارسة الحياة الدنيوية من خلال التمتع بالأخلاق الفاضلة، والقدرة على المحبة وفعل الخير، واعتماد الصدق في القول والفعل.
لذلك يمكننا أن نعتبر أن الزاد الذي حمله لطف الله في انفتاحه على عالم المدينة الذي يعج بالولاءات والانتماءات والاختلافات على الصعد كافة، والمكّون من ارث انتمائه العائلي وعراقة نسبه، تتوّج بصدق إيمانه الديني واقتناعه بعظمة كنيسته الأرثوذكسية . فكان لذلك، موجِّهاً ومحللاً وناقداً ومصلحاً اجتماعياً ودينياً فرض احترامه على الجميع بانفتاحه على الجميع، وبصدقه وصراحته مع الجميع. وهذا ما يبينه الجانب الديني من حياة لطف الله، وفي نشاطاته داخل الطائفة الأرثوذكسية، وفي أبرشية طرابلس وخارجها. وذلك من خلال عضويته، ومن ثم ترؤسه للأخوية الأرثوذكسية في طرابلس، ومن خلال تزعمه لحركة الإصلاح الأرثوذكسي، وتأسيسه للكنيسة المستقلة داخل أبرشية طرابلس، ونشاطه إبان الأزمة البطريركية ونشوء الكنيسة الأرثوذكسية المستقلة برئاسة المطران ابيفانيوس زايد، مطران عكار، ومساهمته في نقل المطران جحا من أبرشيته في طرابلس إلى أبرشية حمص في سورية.
وما يهمنا من هذه المسائل أن لطف الله لم يكن متطرفاً في مطالبته في حقوق طرابلس، وملحّاً في رفع الحيف والظلم عنها فحسب، بل تعدى ذلك إلى مواقف مماثلة تجاه الطائفة أيضاً. فهو كان يرى بأم العين ما كان يحصل فيها من تجاوزات إن كان على أيدي رجال الدين أو العلمانيين فيها. وأوقف مرات كثيرة الصفحات الأولى من جريدته لمناقشة آراء وتصرفات قادتها الروحيين وتجاوزاتهم. وبرز، نتيجة لذلك، دور الكنيسة المستقلة التي أنشأها وصار لها كهنتها وأتباعها، ومارست طقوس الجناز والاكليل والعمادة. وأقيمت عليه الدعاوى في المحاكم المدنية من قبل مطران طرابلس، وحكم عليه بالغرامة والسجن، واستأنف الحكم في بيروت وربح الدعوى. كما أقام الدعوى على المطران طحان أمام المجمع المقدس الأرثوذكسي، وتنازل عنها بناء على رغبة المجمع المذكور، وتمت عملية المصالحة وزاره المطران في بيته. واستأنف هجومه على المطران طحان بعد الأزمة البطريركية في بداية الثلاثينيات وعندما أصبح بطريكاً. كما قاد معارضة عنيفة ضد المطران جحا، ولعب دوراً أساسياً في مواجهة البطريرك طحان إبان الأزمة التي عصفت بالبطريركية عندما أنشأ المطران أبيفانيوس زائد "الكنيسة الأرثوذكسية المستقلة" التي بقيت منذ سنة 1935 إلى 1941. ونتج عن هذه المواجهة، من جملة ما نتج، انتقال المطران جحا من أبرشية طرابلس إلى أبرشية حمص.
**************
لم يكلّ لطف الله خلاط ولم يضجر من المطالبة بحقوق طرابلس المشروعة. وبقي يطالب بعودة المحكمة الاستئنافية وجر المياه وإنشاء المرفأ وجعل طرابلس مركز محافظة، كما جعْلِها مصباً للنفط، إلى أن تحققت هذه المشاريع جميعاً وكثير غيرها أيضاً. وكان لا ينتهي بمطلب إلا ويبدأ بجديد. ويحثّ الطرابلسيين على مشاركته المطالبة باستعمال الأساليب كافة. لذلك كان لطف الله صوتَ طرابلس والمدافع عن وجودها والمطالب برفع شأنها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لأنها درة مدن المتوسط، كما كان يسميها، ومهيأةٌ لأن تكون عاصمة المنطقة بأسرها. ولا ينقصها لتضطلع بهذه المهمة سوى إلتفاتة اهتمام من قبل السلطات، منتدبة كانت أو وطنية. لذلك لم يسكت قلمه عن القيام بهذه المهمة إلا بعد أن جف بتقادم الأيام وبلوغ العمر مرحلة العجز والشيخوخة. فارتاحت اليد التي أتعبها شقاءُ النضال، وإن لم يرتح العقل الذي أحب طرابلس إلا بحلول ساعة الموت.
لم تنس دولة الاستقلال، وما بعدها، الجهود التي بذلها لطف الله خلاط في خدمة وطنه ومدينة طرابلس في المجال الصحافي. فعبّرت عن تقديرها لمواقفه ونضاله الدؤوب بإطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة في منطقة الزاهرية – المنطقة التي أحب- ومنْحِه أوسمة الاستحقاق والأرز من رتبة فارس وضابط وكوميسر. وقد مُنح الوسام الأخير بعد وفاته باحتفال رسمي كبير.
بقيت جريدة "الحوادث" تصدر في طرابلس حتى بداية الخمسينيات. وقد انتقلت ملكيتها إلى الصحافي الطرابلسي سليم اللوزي سنة 1955. فأصدرها مجلة أسبوعية سياسية.
ترجل الفارس لطف الله خلاط واستراح في الأول من كانون الثاني 1965 بعد عناء دام أربعة عقود في العمل الصحافي والسياسي والاصلاح الديني.
غريغوريوس حدّاد، نموذج فريد في العيش المسيحي – الإسلامي
بقلم الأب إبراهيم سروج
مَن هو هذا الفريد في عصره، والشاهد الحيُّ على «أن الخَلْق كلَّهم هم عيال الله»، وأن «لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى» وأن «ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبدٌ ولا حرٌ، ليس ذكرٌ ولا أنثى لأنكم جميعكم واحداٌ في المسيح يسوع» (غلاطية 3: 28)؟
طفولة غريغوريوس وصباه:
إنه غنطوس بن جرجس بن غنطوس الحداد. ولد في الأول من تموز عام 1859( ) في قرية أبيه، عبيّه، والدته هند، ابنة عسّاف سليم من كفرشيما، وغنطوس هو الثالث بين أخويه عسّاف ونعمة وله أختان: سوسنَّة وأمل( ). وتروي السيّدة ماري مالك دبس، التي كتبت أطروحة ماجستير مطوَّلة، قدَّمتها في جامعة البلمند عام 2003، عن الطفل غنطوس، وهو ابن سنة تقريباً.
«يُروى أنه في خلال الفتنة التي وقعت في بعض قرى لبنان سنة 1860، وكان غنطوس ما يزال طفلاً، لم يهجر والده جرجس بلدته عبيه – ووالده إسكافي القرية – وفي أحد الأيام ذهبت هند سليم زوجة جرجس باتجاه الفرن وهي تحمل ابنها غنطوس على يدها وإذ بمسلّح يعترضها ويخطف الولد. فما كان من أحد النافذين الدروز في القرية إلاّ أن لحق بالمسلَّح وقال له: «هذه امرأة جرجس حدّاد وهذا طفلها غنطوس، لا يليق بنا أن نُنكر حُسن الجوار فأرجِع الولد إلى أمِّه حالاً»( ).
ويصفه الإرشمندريت الراهب توما بيطار في كتابه «القديسون المنسيون»: «بأنه كان معتدل القامة، صبوح الوجه، أبيض البشرة، أشقر الشعر، بهيّ الطلعة، ناعم اليدين، جاحظ العينين، باسم الثغر، وديعاً، طاهر القلب»( ). أمّا عبد المسيح أنطاكي بك، الأديب الأرثوذكسي الحلبي، فيُضيف في جريدته «العمران» التي كان يصدرها في مصر: «وكان أبواه على جانب عظيم من البساطة والتُقى وكانا كغيرهما من صغار الفلاّحين الذين يعيشون بعرق الجبين»( ).
يتابع الراهب الحديث عن غنطوس فيقول : «بدت عليه منذ الطفولية علامات الذكاء إذ كان عريض الجبهة، حادّ الذهن، سريع الفهم، فاهتمّ أبواه بإلحاقه بمدرسة عبيه الأميركية حيث أتمَّ دروسه الابتدائية (1872)( ). ويضيف الأنطاكي أنه «ما زال فيها إلى أن بلغ السابعة عشرة من عمره»( ). ثم انتقل إلى كلية الثلاثة الأقمار الأرثوذكسية في بيروت فأنهى فيها دروسه الثانوية( ).
وفي بيروت، يلاحظه مطران بيروت ولبنان (1870 – 1901) السيّد غفرائيل شاتيلا، «فيُعجب بنباهته وذكائه ويضمه إلى حاشيته ويُدخله في عداد تلامذة المدرسة الإكليركية( )... وكان عددهم عشرة فيُظهر نشاطاً في تلقي العلوم اللاهوتية والأدبية ومبادئ اللغة اليونانية ويفوق أقرانه بلا جدال ذكاءً وعلماً وطاعة فيحبه السيِّد المشار إليه (شاتيلا) ويتخذه سكرتيراً خاصاً له في 24 كانون الأول سنة 1875 وخادماً مُعيناً له»( ).
غريغوريوس راهباً وشماساً:
وإذ كان غنطوس «ميّالاً منذ صباه إلى حياة الزهد والتأمل»، شرطنه المطران شاتيلا، في التاسع عشر من شهر كانون الأول عام 1877، راهباً في دير سيِّدة النورية، وفي التاسع والعشرين من شهر آب سنة 1879، شرطنه شماساً ودعاه باسم غريغوريوس( ). وبالرغم من حداثته وهو ابن العشرين سنة، أصبح مستشاراً لسيادته وموضع ثقته حتى أنابه عنه في رئاسة جمعية القديس بولس( ) وأسند إليه مهمّة إنشاء جريدة «الهديّة»( ) والإشراف على طباعة كتاب «البوق الإنجيلي» و«الصلوات والمزامير»( ).
في هذه الفترة المليئة بالنشاط، عرَّب غريغوريوس خطباً ومقالات عديدة من اليونانية نشرها في جريدة «الهدية». كما أنشأ مكتبة في دار المطرانية حفظ فيها كتباً ومخطوطات( ) وكان «ينهل من كل العلوم الدينية والفلسفية، إذ درس الفقه الإسلامي على يد الشيخ يوسف الأسير( ) الفقيه الإسلامي( )، فأصبح حجّة في علم الفرائض. وانكب أيضاً على درس كتاب نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب، ونسخ كتاب «الفلسفة الطبيعية» لأرسطو ليطالعه بإمعان( ).
أسقفية غريغوريوس:
وبعد وفاة مطران طرابلس السيّد صفرونيوس النجّار، اتفق روم المدينة على ترشيح ثلاثة هم: الارشمندريت جراسيموس مسرّة وكان رئيساً للكنيسة السورية في الإسكندرية، والشماس رفائيل هواويني وكان في روسيا، والشماس غريغوريوس حدّاد سكرتير أبرشية بيروت( )، فوقع اختيار صاحب الغبطة جراسيموس البطريرك الأنطاكي (وهو آخر البطاركة اليونان) مع السادة المطارنة على الشماس غريغوريوس.
شرطنه معلمه مطران بيروت السيّد غفرائيل شاتيلا كاهناً في 6 أيار 1890( ) وفي العاشر من الشهر نفسه والسنة نفسها، نال نعمة رئاسة الكهنوت في دمشق، على يد البطريرك جراسيموس وبمشاركة السيّدين: سيرافيم مطران ايرونوبوليس ونيقوديموس مطران عكار( )، وله من العمر واحدٌ وثلاثون عاماً( ).
رجع المطران غريغوريوس فوراً إلى أبرشيته ودخلها باحتفال مهيب، وأخذ يعمل على التوفيق بين أبنائها( ) بعدما طالت المنازعات فيها( ). افتتح عمله بإعادة مدرسة بكفتين إلى الوجود. أسّس الأخوية الأرثوذكسية الطرابلسية للعناية بالمحتاجين. أنشأ مكتبة في دار المطرانية، تعهّد مدرسة البلمند الاكليركية وزوّدها بمكتبة، كما زوّد مكتبات أديار النورية وحمطورة وكفتون بالكتب والمخطوطات( ). تحدث عنه المؤرخ عيسى اسكندر المعلوف فقال: «مهَّد سبيل المسالمة بحكمته ناشراً راية الوفاق وموثّقاً عرى المصافاة فآلف القلوب ووفّق الآراء، فأصلح ذات البين واشتهر بحبّه للسلام»( ).
«كان هذا الحبرُ البار منكباً على خدمة كنيسته محترماً بقية الطوائف، جامعاً للآثار العلمية والأدبية، مجاهداً في سبيل إعادة البطريركية للعرب»( )، فأسهم في الجبهة الأنطاكية العربية التي تزعمها المطران غفرئيل شاتيلا (مطران بيروت) ونجح المطران غريغوريوس في استمالة بعض المطارنة إليها وقد فازت الجبهة في انتخاب وسيامة ملاثيوس الدوماني بطريركاً عربياً على الكرسي الأنطاكي( ).
ونختم الحديث عن أسقفية غريغوريوس حدّاد بذكر الاستشهاد المفتاح لموضوعنا عن العيش المسيحي – الإسلامي، ألا وهو أن «غريغوريوس كانت له مجالسات أدبية [ومناقشات] وعلمية مع علماء طرابلس وغيرها ولا سيما المرحوم العلامة الشيخ حسين الجسر والد المرحوم الشيخ محمد الجسر [رئيس المجلس النيابي في بيروت حينها] ( ).
يبقى لنا أن نتحدث قليلاً عن حسّه الوطني واندفاعه الكبير نحو تغيير البطريرك الأنطاكي والذي كان في أيامه يونانياً ومنذ أن انفصل الروم الكاثوليك، بسعاية القناصل الغربيين والإرساليات الغربية، عن حضن كنيستهم الأرثوذكسية الأمّ عام 1724.
كان آخر البطاركة اليونان في أيامه، اسبيريدون الأول (1892 – 1898)، وعلى ما يبدو كان ذا عصبية قومية فائقة وصاحب شرور كثيرة. لم يعترف المطران غريغوريوس حداد بالبطريرك هذا حتى قبل السيامة( )، ولكن الباب العالي اضطرّه بالنهاية على الاعتراف به( ).
بالرغم من ذلك، بقي غريغوريوس يناضل مع إخوته مطارنة اللاذقية (ملاتيوس) وحمص (أثناسيوس) وبيروت (غفرائيل)، إلى أن تمّ لهم الأمر باستعفاء البطريرك اسبيريدون، وبانتخاب مطران اللاذقية، ملاتيوس الدوماني بطريركاً عربياً على أنطاكية في 15 نيسان من عام 1899.
وبعد وفاة البطريرك ملاتيوس في 26 كانون الثاني سنة 1906، التأم المجمع الأنطاكي المقدس في العشرين من نيسان من العام نفسه لجلسة الترشيح القانوني. كان الأنطاكيون قد اتفقوا منذ أيام الدوماني، أن يكون انتخاب البطريرك الأنطاكي على غرار انتخاب البطريرك المسكوني، أي باشتراك الشعب – [هذا الأمر قد حذفه المطارنة في قوانين 1972 فصار الأساقفة، يرشحون وينتخبون البطريرك والأساقفة] –
كيف عاش غريغوريوس علمانياً وشماساً ومطراناً وبطريركاً إيمانه المسيحي مع المسلمين؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، لنأخذ فكرة عن الإطار التاريخي الذي نشأ فيه غريغوريوس وترعرع.
نشأ غريغوريوس في ظلّ السلطنة العثمانية وفي ذمّة المسلمين وخلافتهم (أهل الذمّة) وقد اصطبغت مرحلته بدماء الحروب الطائفية بين المسلمين والمسيحيين. ولنستعرض بعض المحطات التاريخية المهمة.
1821: اندلاع الثورة في اليونان، فهجم مسلمو سوريا عدّة مرات على المسيحيين وخصوصاً على الأرثوذكس( )
1833: احتل المصريون سوريا مؤقتاً، وكان هذا سبباً لهجمات عدّة على المسيحيين بتحريض من السلطنة العثمانية( )، التي قال واليها في الشام أحمد باشا ومشير فيلق الأقطار العربية: «في سوريا ولبنان آفتان: هما المسيحيون والدروز، فكلّما ذبح أحدهما الآخر استفاد الباب العالي»( ).
1840: 15 تموز، اتفاقية لندن. وقّعها كلّ من النمسا، روسيا، بروسيا وبريطانيا، وقفوا فيها ضدّ محمد علي وحرّضوا السوريين على الوقوف إلى جانبهم، فتبنّت فرنسة حماية الموارنة والروم الكاثوليك (مع النمسا)، والروس الروم الأرثوذكس، والإنكليز تبنّوا الدروز( )، ولكنهم لم يكتفوا بهذا، بل هيأووا وشجعوا على قيام دولة إسرائيل لتحفظ مصالحهم.
1841: 18 ت1 قام الدروز على المسيحيين وحصلت حرب شوارع عنيفة، سقط ضحيتها عددٌ كبيرٌ من القتلى أغلبهم من المسيحيين. هذا ما أكّده يوسف السودا بقوله: «حوادث 1841 هي أول مرّة عرف فيها اللبنانيون المنازعات الدينية والحروب الطائفية بعد أن عاش الدروز والنصارى في لبنان إخوان صفاء أجيالاً طوالاً»( ).
1845: 9 نيسان، قامت جماعة من الموارنة بإحراق أربعة عشر قرية درزية في الشوف، ثم هاجمت مقرّ الجنبلاطيّين في المختارة، وهناك صدّهم الأتراك بعنف.. ولما امتدّت الفتنة إلى عاليه، وقف الأتراك أيضاً إلى جانب الدروز. ( )
1856: 18 شباط، وبضغط من القوى الغربية على السلطان عبد المجيد، صدر خَطِ هُمايون، يعلن صراحة المساواة بين جميع الرعايا المسلمين وغيرهم في السلطنة، يُطلق الحرية الدينية للجميع( ).
1857: حضر إلى بيروت والٍ جديد هو خورشيد باشا. وفي هذه السنة اشتدت النـزاعات بين الأهالي وأسيادهم: ففي زحلة حصل الخلاف مع الأمراء اللمعيين وامتنعوا عن طاعة القائمقام وعن دفع الضرائب. انتخبوا من بينهم «شيخ شباب» وشكلوا مجلساً بلدياً من ستة أشخاص. وكذلك بدأ سكان غزير عصيانهم برفض الطاعة لأسيادهم بني حبيش... وبعدهما بدأ العصيان الفعلي في كسروان، الذي أدَّى إلى اختيار «شيخ شباب» جديد هو طانيوس شاهين قائد ثورة الفلاحين عام 1858( ).
1860: وتتفاعل حوادث التمرد والعصيان، ويزداد تحريض القناصل وبني عثمان، فتندلع المذابح الطائفية في عام 1860 «قام الدروز والمسلمون ضدّ المسيحيين بتحريض من تركيا، وجرت مذابح المسيحيين في مدن كثيرة من سورية مبتدئة من لبنان. ذُبح الآلاف منهم خصوصاً في دمشق، فهُدِّمت وأحرقت أحياء المسيحيين ونُهبت. وكانت كارثة البطركية بدمشق كارثة عظيمة حيث أُحرقت الكنيسة المريمية والمكتبة والأواني الكنسية. وقد ذُبح ما بين 20 أيار عام 1860 إلى آخر حزيران من العام نفسه سبعة عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة وعشرة آلاف ولد»( ).
في هذه الأجواء المشحونة بالأحقاد الطائفية، والملوّثة بدماء الهمجية، نشأ غريغوريوس. وبين تصارع المذاهب الدينية من بروتستانتية وكاثوليكية، وتصادم مصالح الدول الغربية وتكالبها على اقتسام تركة الرجل المريض، ترعرع غريغوريوس وشبَّ، فكيف سيتصرّف منسجماً مع إيمانه المسيحي تجاه المسلمين سنّة ودروز؟
لقد انطلق غريغوريوس في كل تصرّفاته ومعاملاته مع الناس من قناعاته ومبادئه ومن محبته لله وللوطن. اسمع إليه يخاطب أبناء زحلة الذين جاؤوا يستقبلونه وهم من مختلف الملل والنحل في 22 ت2 من عام 1911:
«إنني أحبّ أبناء وطني من جميع المذاهب على السواء. ولا فرق بينهم عندي. ألستُ وإياهم أبناء أب واحد وأم واحدة. أوَ لسنا جميعاً صنعة خالق واحد. أوَ لسنا نسكنُ أرضاً واحدة ونستنير بضوء شمس واحدة ونستظلُّ بسماء واحدة وترفرف فوقنا رايةٌ واحدة هي راية الوطن العزيز؟ أوَ لسنا نحن والمسلمون توحّدنا جامعة الانتساب إلى أرض واحدة ووطن واحد؟ أوَ لسنان نعبد إلهاً واحداً غير متجزئ؟»( ).
بهذا الحبّ الإلهي، تجاوز غريغوريوس الخبرة الأليمة التي تعرّض لها في عامه الأول أثناء حوادث 1860، في قريته عبيه، وكادت تودي بحياته، وانطلق ليتعلّم لغة قومه على يد الشيخ يوسف الأسير، الذي علّمه أيضاً الفقه الإسلامي. كما قرأ نهج البلاغة ولا بدّ أيضاً أنه قرأ القرآن الكريم. لقد أحبّ اخوته المسلمين، وعندما صار مطراناً على طرابلس، كانت له – كما أشرنا سابقاً – مجالسات أدبية وعلمية مع علماء طرابلس ولا سيما المرحوم العلامة الشيخ حسين الجسر. ويضيف المثلث الرحمات، قدس الارشمندريت رومانوس جوهر( ) «وكان صديقاً حميماً للشيخ محمد الحسيني( ) وكان في دمشق صديقاً حميماً لمفتيها أبي الخير عابدين. ولهما عندي صورة. غريغوريوس سيّد الذين أرسوا في هذا الشرق مفاهيم الوحدة الوطنية والتعالي على العنعنات والأحقاد والتشنّجات».
هرعنا إلى ما كتبه الأستاذ الصديق الدكتور خالد زيادة عن الشيخ حسين الجسر في كتيّبه المعنون: «الشيخ حسين الجسر 1845 – 1909»( ) في مقالته الطويلة في مجلّة «المواسم»( )، وفي مقدمته الأطول للكتاب الذي حقّقه لفضيلته ألا وهو «الرسالة الحميدية»( )، ولم نظفر بإشارة عن تلك المجالسات.
استعنّا أيضاً بالأديب الفهّامة، الأستاذ مارون عيسى الخوري، فنفى أيضاً وجود أية مجالسات( ). وكذلك أكّد الحبر العلاّمة، سيادة المطران جورج خضر «أن المطران غريغوريوس لم يكن لاهوتياً ولا فقيهاً ولا مجالسات له مع المسلمين»( ) .
يجدر بنا أن نشير أيضاً إلى ما ذكره المؤلف محمد نور الدين عارف ميقاتي، في كتابه عن «طرابلس في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي»، عن المطران غريغوريوس حداد «أن روابط المحبّة كانت على أشدها بين المطران وبين رجالات طرابلس، كما كانت صداقته متينة مع جدّ المؤلف الشيخ علي، على التخصيص»( ).
وإليكم الآن أهم التصرفات التي قام بها غريغوريوس، مطراناً وبطريركاً وهي تشهد لعيش إيمانه، الفريد بين الناس جميعاً:
مطراناً:
عندما دمعت عينا المطران حدّاد:
«يُروى أن المرحوم الشيخ محمد شميسم أحد حفظة القرآن الكريم، وكان ضريراً رخيم الصوت، جاء يشكو للمطران أحد أبناء رعيته بديْن له عنده، فطيّب المطران خاطره ووعده بتحصيل دينه شريطة أن يتلو على مسامعه سورة «مريم» عليها السلام. فلبّى الشيخ شميسم الطلب وتربّع متأدّباً وأخذ يتلو بصوته الجهوري الجميل السورة الكريمة حتى أنهاها... ويقول مرافق الشيخ الضرير أن دموع الخشوع أخذت تنهمر من عينيّ المطران حداد على لحيته وتتساقط منها على صدره... وبعد أن انتهى الشيخ من التلاوة قام المطران إلى غرفته الخاصة وأحضر المال المطلوب للشيخ شميسم ودفعه له»( ).
ويروي الأستاذ المرحوم ديمتري كوتيا، نقلاً عن الصحافي الكبير لطف الله خلاط، إلى السيّدة ماري مالك: «إن المطران غريغوريوس حداد كان يحبّ الكذّابين (كبشر) بمقدار ما يُبغض الكذب – مع أن الكذب بعيد عنه بُعد السماء عن ألأرض – ولكنه يحتفظ بالخطأة ويُطيل باله عليهم لأنه رحب الصدر وهو يعتبر أن الله قَبِل الأخيار كما قبل الأشرار، وربنا يُشرق شمسه على الاثنين معاً. ويسترسل الأستاذ لطف الله قائلاً: لم اسمعه مرّة تكلّم على أحد بسوء، أو غضب عليه، حتى لو كان هذا الشخص من الجماعات التي تنتقده وتقاومه، إنما كان يقول دائماً كلمته: «سامحه الله» (مالك، ص 40).
وفاؤه لقاضي المدينة:
اعتُقل قاضي مدينة (طرابلس) بوشاية جاسوس من رجال السلطان عبد الحميد الثاني العثماني وأعرض الكلّ عنه. ولكن المطران زاره في سجنه وشجّعه وأمدّه بالمال ودافع عنه في طرابلس والآستانة حتى ظهرت براءَته وأعيدت إليه كرامته. ولما صار بطريركاً جاء ابن ذلك القاضي مع رهط من وجهاء مدينته وقال له: أنا آتٍ من الآستانة لتنفيذ وصيّة والدي المتوفي فقد قال لي: سر إلى دمشق وقَبْل زيارتك للجامع الأموي اذهب وقبِّل يد بطرك الروم. فلما سأله عن والده عرف أنه هو الذي كان يساعده في اعتقاله»( ).
لم يهرب من الطاعون:
لمّا تفشى وباء الهيضة (الهواء الأصفر) في طرابلس، لم يهرب غريغوريوس من المدينة، شأن كثيرين، ولكنه طفق يزور المرضى ويعزّي المنكوبين ويعطف على الفقراء من جميع الطوائف. ولما ألحّ عليه أصدقاؤه بالفرار، قال المطران: «ليست نفسي بأفضل من نفوس الذين لا يستطيعون الفرار من الوباء»( ).
بطريركاً:
يقول المطران ألكسندروس جحا عن معلمه البطريرك غريغوريوس حداد: «إن كلمته كانت مسموعة عند الحكومة العثمانية لدرجة أنه لم يكن يحتاج للذهاب إلى المسؤولين وإنما كان يكتفي بإرسال قواصه ليُستجاب طلبه.. ويتابع الشهادة... لم يكن يطلب ما لنفسه ولا لأحد أفراد عائلته وهو لم يستغلّ رتبته الكنسية ولو لمرّة واحدة لأغراض أو لمنفعة شخصية. وحتى عند زيارة أقاربه له في البطريركية لم يكن يضيفهم عنده وإنما يجعل مقامهم في الفنادق المجاورة( ).
وأثناء الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م) تجلّت محبة البطريرك وأحشاء رأفاته على الفقراء والمرضى والمظلومين، ففتح أبواب قلبه والبطريركية لكل محتاج إلى أية ملّة انتمى، لا فرق، حتى دُعي بـ«أب الفقراء»( ).
«خاطت له شقيقته غنبازاً للنوم وأرسلته إليه فلما وصل إليه كان في حضرته رجل فقير رث الثياب فخلعه عليه من فوره. وبقيت شقيقته تُلحّ عليه بقياس ذلك الثوب لتعلم ما إذا كان يناسبه وهو يقول لها: «إنني مشغول الآن»، حتى عرفت بعد أيام أنه وهبه فسكتت»( ).
«مدّ مرّة متسول يده إليه للاستعطاء فسأله راهب بقربه عن طائفته، فانتهره البطريرك قائلاً: «هل تمنع عنه الصدقة إذا كان من طائفة غير طائفتك؟ ألم يكفه ذلّ التسول ومدّ يده للاستعطاء حتى تستذلّه بسؤالك عن عقيدته؟ ثم منح المتسول بعض الدراهم التي في جيبه وصرفه مسروراً مجبور الخاطر»( ).
كما ذُكر عنه أيضاً اثناء الحرب العالمية الأولى، في مساء أحد مرفع الجبن، التقى نساء مسلمات يشكين الجوع قائلات: نريد خبزاً يا أبا المساكين. نريد خبزاً لأطفالنا الجائعين!» فعاد أدراجه إلى الدار البطريركية وأمر بأن توزّع عليهنّ المؤن من البطريركية، ثم قفل على نفسه راكعاً يصلي بين الساعة الرابعة من بعد الظهر والحادية عشرة ليلاً. ولما جاءه طبّاخ البطريركية عارضاً إعداد بيضتين مقليتين بالسمن مع رغيف وقطعة حلوة، أجاب: «لا يليق بي أن آكل وغيري يتضوّر جوعاً! ثم أمر بأن يُعطى طعامه لأول فقير يمرّ بالبطريركية في الغد»( ).
تأخّر البطريرك يوماً عن وجبة الطعام( )، فحفظ له الطبّاخ حصّة مميزة. فلما حضر ولاحظ أن ما أُفرز له كان أشهى مما قُدِّم لسواه، بادر بالقول: «أعطوني ممّا قدّمتم لإخوتي!» ...
ولما حان وقت الطعام مرّة، وكان الزمن صياماً، أحضر له الطاهي إفطاره. في هذه الأثناء كان أولاد يضجون في ساحة البطريركية، فسأل عما بهم فقيل له إنهم فقراء جائعون فاستدعاهم وأعطاهم طعامه( ).
«لما نشبت الحرب الكبرى كان غبطته مرجعاً للفقراء والمعوزين [وتسلية للجياع المنكوبين]، فكان يطوف أحياناً مع شماسه وقواصه [قواسه] يجمع المطروحين في الأزقة إلى دار البطريركية والمدرسة التي تقابلها ويعتني بإعالتهم وكثيراً ما كان يُطعمهم بيده غير ناظر إلى مِلَلهم مستديناً المال لذلك»( ) وتضيف السيّدة مالك في الهامش: «بسبب هذا زاد السلطان كمية القمح للبطريرك ثلاثة أضعاف، مع أنه كان في البداية لا يُعطي المسيحيين».
إبان هذه الحرب فتح البطريرك أبواب المساعدة على مصراعيها، للجميع بلا تمييز بين مسلم ودرزي ومسيحي، حتى تراكمت وبلغت ما يوازي عشرين ألف ليرة عثمانية ذهباً فرهن صليبه الماسي المهدى إليه من قيصر روسيا، ولما وجد صديقٌ مسلم الصليب معروضاً للبيع في واجهة تاجر يهودي دفع الصديق المبلغ فوراً وأعاد الصليب إلى غريغوريوس قائلاً: «لا يليق بأحد سواك أن يتزيّن بهذا الصليب يا سيّدنا» ولكن غريغوريوس عاد وباعه سرّاً ووزع الأموال على الفقراء، ولكي يظل الأمر سرّاً استبدله بصليب زجاجي وضعه على لاطيته ولم يكشف الأمر إلاّ بعد وفاته حين اختلس أحدهم الصليب وعرضه على أحد الصاغة في بيروت»( ).
زار يوماً مدينة زحلة ليقيم فيها قداساً لأحد سكان المعلّقة فجاءه رجلٌ درزي وطلب إحسانه، فلم يجد في جيبه ما يعطيه إياه فصرفه بالحسنى معتذراً إليه كعادته وواعداً إياه بالتعويض عليه مرّة أخرى. فما كاد الرجل يخرج من الباب حتى جاء صاحب المنـزل ودفع للبطريرك خمس ليرات ذهبية عن القداس، فنادى البطريرك الرجل واستعاده إليه وأعطاه ما قبضه قائلاً: «الله بعث لنا ولك»( )
ومما يؤثر عنه أن الراهبة، بربارة جحا، التي تُطعم المنكوبين، جاءت إليه ذات يوم متشكّية من عدم إمكانها أن تعول الجمع لقلّة الطعام وكثرة الآكلين، وتوسلت إليه أن يقتصر على أبناء ملّته الأرثوذكسية فقط، فأجابها: غداً نرسل إليك الخبز وقد كُتب على كل رغيف اسم آكله ومذهبه فاطعمي كلاّ ما يخصه»، وفي اليوم الثاني، جاء الخبز كالعادة فتعجّبت من ذلك وذهبت إليه تذكّره بوعده، فقال لها: «يا ابنتي إن الله أعطانا الخبز لنأكله دون نظر إلى مللنا وأجناسنا فلنبذله للجميع» فخجلت وعادت أدراجها تُطعم الجميع مما يصل إلى يدها من المأكل»( ).
روت السيدة لمياء حدّاد أنها وزوجها الدكتور سامي حدّاد، استضافا غبطة البطريرك في بيروت بعد أن أجريت له عملية الماء الزرقاء في مستشفى الجامعة الأميركية. وذات يوم أتى أحد كبار المسلمين زائراً غبطته وقد علم بفقر حاله فأعدّ له بدلة رسمية هدية. استقبله غبطة البطريرك وقد كان أحد الكهنة الفقراء في زيارته. شكر الزائر على هديته وبعد انصراف الزائر نادى غبطته الكاهن وطلب إليه أن يرتدي البذلة وإذ ناسبته قال له: «خذها يا بني وابقِ بدلتك الرثة هنا»( ).
كما روى أحد أعيان صوفر أنه زار البطريرك في دار مطرانية بيروت وخلال الزيارة سمع غبطته يسأل أحد الجلوس عن الوقت، وإذ لم يكن يملك ساعة. فما كان من الثري إلا أن انتزع ساعته الذهبية وأهداها إلى البطريرك هي وكستاكها الثمين. وبعد ذلك بأسابيع، صادف أن مرّ الرجلُ نفسه في دمشق فلم يلاحظ الساعة في حوزة البطريرك. ولما استفسر عن الأمر لدى أحد الكهنة، أجابه هذا الأخير: «بعد زيارتك لغبطته بيومين، قصدته امرأة طالبةً المساعدة فقال لها البطريرك: لا مال لديّ ولكن خذي هذه الساعة واذهبي إلى أحد الصاغة فهي ثمينة ولا بد أن تكفيكِ مورداً مدّة طويلة»( ).
مبايعة الملك فيصل:
في ربيع سنة 1920، إثر مؤتمر دمشق الذي نادى باستقلال سورية الطبيعية، بايع الوجهاء والأعيان فيه فيصلاً ملكاً عليها وكان البطريرك غريغوريوس في طليعة المبايعين( )، وقد بايعه باسم جميع المسيحيين من روم كاثوليك، سريان وارمن (أرثوذكس وكاثوليك) موارنة وإنجيليين وحتى اليهود( ).
ولما رجحت كفة الفرنسيين واضطر فيصل على أن يبرح دمشق في تموز من العام نفسه، كان غريغوريوس الوحيد الذي خرج لوداعه حفظاً للعهد وثباتاً على العقد. قال له: «إن هذه اليد التي بايعتك ستبقى على العهد إلى الأبد» فما كان من الملك فيصل سوى أن قبّلها باكياً( ).
وهذا الوفاء سيقابله الملك فيصل بوفاء مماثل. اتفق أن شاباً لبنانياً تعاطى التطبيب دَجلاً في العراق ولم يوفق، فأودعته السلطة السجن. علم ذووه أن للبطريرك اعتباراً كبيراً لدى الملك، فارتموا على أقدامه. دبّج لهم رسالة فحملوها إلى فيصل، فقبّلها ووضعها على رأسه، وذهب لتوّه إلى السجن بدون إعلام المسؤولين فيه. فتهيّبوا لمرآه وأخذوا له التحية. طلب من مدير السجن احضار السجين، فاحضروه [ثم] قال للمدير: أخرج فيشته، فأخرجها. قال له: أتلفها والتفَتَ إلى السجين فقال له: اذهب إلى بلدك ولا تعد إلى هنا أبداً وقبِّل عني يمين صاحب الغبطة»( ).
وكتلميذ أمين لمعلمه يسوع المسيح، الذي قال له في العظة على الجبل: «أحبّوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم... لأنه إن أحببتم الذين يحبّونكم، فأي أجر لكم؟ (متى 5: 44 و46)، إليكم كيف حفظ الوصية وجسَّد التعليم:
1- سعى البطريرك غريغوريوس حداد لدى جمال باشا لكي لا ينفي البطريرك الماروني الياس بطرس الحويك المعروف بتعلّقه بفرنسا. فلما صدر قرار جمال باشا بإخلاء سبيل البطريرك الحويك بكى غريغوريوس فرحاً. (مؤتمر عبيه، ص 50، وردت في مالك، ص 126). سوف يكافئ البطريرك الحويك الروم في وادي النصارى، أن رفض انضمامهم إلى لبنان الكبير يوم هندسه مع فرنسة المنتدبة.
2- كان البطريرك حدّاد من أول المجاهدين لتسليم البطركية الأنطاكية إلى أهلها، وقد نجح مع اخوته مطارنة الكرسي الأنطاكي الأوفياء من عرب ويونان، في إيصال أول بطريرك عربي وهو ملاتيوس الدوماني. لذلك لم يعترف البطاركة اليونان في استنبول وأورشليم والاسكندرية ببطركيته. «وفي تشرين الثاني عام 1917 جاءه نبأ مفاده أن بطريرك أورشليم اليوناني (دميانوس) سيصل إلى دمشق ويبيت ليلة واحدة في البطركية ومن ثم يكمل طريقه إلى الإقامة الجبرية في الأناضول. أما «بطريرك العرب»، وقد لُقّب بـ«غريغوريوس أفندي» والذي أصبح في مرتبة وزير البلاط العثماني بعدما منحه السلطان رشاد الوسام المرصّع الأعلى عام 1913 (عندما زاره البطريرك وهو في طريقه إلى روسيا ليترأس الاحتفالات بمناسبة ذكرى مرور ثلاثماية سنة على استلام آل رومانوف الحكم)، فاستخدم كلّ ما لديه من نفوذ لدى الباب العالي ونال أن يُسمح له بضيافة البطريرك دميانوس وحاشيته المؤلّفة من ثلاثة وعشرين شخصاً إلى أجل غير مسمّى. دامتْ إقامة بطريرك أورشليم في دمشق في حمى البطريرك غريغوريوس من تشرين الثاني 1917 لغاية كانون الأول 1918 (أي سنة ونيّف) إلى أن نال غريغوريوس الإذن بإعادة دميانوس إلى كرسيه عزيزاً مكرّماً. وعندما سأله أحدهم: «كيف تدافع عن البطريرك اليوناني ومجمعه في القدس لا يعترف بك بطريركاً؟ أجاب: «إن دميانوس أخي في المسيحية وكذلك في الإيمان الأرثوذكسي، وهو أتاني طالباً ضيافتي، وأنا عربي والضيف عندي مكرّم والدولة العليّة لا يتناقض موقفها مع حسن الضيافة»( ).
وأجمل صورة للعيش المسيحي – الإسلامي الواحد، نلتقطها إبّان الثورة السورية عام 1925 التي تزعّمها سلطان باشا الأطرش وكان على اتصال دائم بغبطته. عندما حاصر الثوار مدينة دمشق، ما كان من المجتهد الأكبر الشيخ بدر الدين الحسين إلاّ أن قدِمَ إلى دار البطريركية في ساعة متقدمة من الليل وطلب الاجتماع فوراً بغبطته. وإذ بالحنطور يُجهز وغبطته يرتدي الزيّ الرسمي وركب هو والشيخ بدر الدين العربة وخرجا في الليل. وحوالي منتصف الليل جاءت الهمسات من أهالي حي القصّاع وحي باب توما والأحياء المسيحية في دمشق تروي حالة الخوف من هجوم الثوار من الغوطة على دمشق، كما تروي أخبار شخصين يتمشيان في الشوارع والحارات والأحياء السكنية المسيحية. وَقْع الأقدام واضح وضربة عصا غليظة تُسمع إلى مسافة، البعض خافوا والبعض اطمأنّوا وبقي الجميع في حيرة حتى طلوع الفجر حين انجلت الحقيقة: الشيخ بدر الدين والبطريرك غريغوريوس جابا المنطقة كلها سيراً على الأقدام وبكامل زيّهما الرسمي طوال الليل يطمئنان السكان»( ).
فرادة غريغوريوس حداد في عيشه المسيحي – الإسلامي
بعد أن سمعتم بعض المواقف التي تلوتها عليكم، هل ترون فرادةً له في مواقفه؟ دعونا معاً نفتش عن هذه الفرادة، وحتى ندركها تعالوا معاً نستعرض ملامح العلاقات المسيحية – الإسلامية في عصر الحداد وقبله.
1- كانت هناك علاقة صداقة وشراكة بين أعيان الأرثوذكس أمثال آل خلاط ونوفل وغريِّب مع حاكم إيالة طرابلس مصطفى آغا بربر (1767 – 1835)
2- معظم أعوان ومريدي بربر من النصارى، كعائلة الصراف وغريّب وصدقة، وكان وهبة صدقة من أعزّ أصدقاء بربر وأخصائه.
3- نعمة الله غرّيب كان صديقاً حميماً للأمير بشير الكبير، كما كان على علاقة صداقة وتحاب مع أكابر المسلمين، وفي مقدمتهم عبد الحميد كرامي والشيخ محمد الجسر.
وكان لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس مراكزهم المرموقة في المجتمع الطرابلسي، كما كان لمطارنتهم المكانة المتقدمة على باقي الرؤساء الروحيين للطوائف المسيحية( ).
عُرفت عائلة غرّيب بعلاقاتها الاجتماعية المميزة مع بعض العائلات السنية كاتفاق الأفندية من بني كرامة ومقدّم ومغربي وسندروسيّ وبركة وزيني وعكاري على أن يرتبوا أدواراً في أيام الشتاء يعني يجتمعون بالسهرة كل ليلة في بيت أحدهم»( ).
نعمة غريّب يقدّم المساعدة المالية للشيخ محمد الجسر كذلك كان الوجهاء الأرثوذكس يستعينون بالمسلمين لحل مشاكلهم مع الدولة العثمانية.
الياس غرّيب التجأ إلى الشيخ رشيد الميقاتي.
إذاً كانت العلاقات بين الأرثوذكس والمسلمين، علاقات وجهاء وأعيان أو وجهاء وحكّام، علاقات تبادل خدمات ومنافع( ). وهنا يسائلنا معلمنا يسوع المسيح «إذا كنتم تحبون الذين يحبونكم، فأيّ أجر لكم». حتى اللصوص يتعاملون بشرف، أما تلميذ يسوع، الخادم الأمين، غريغوريوس فقد كان فريداً في عيشه المسيحي مع المسلمين وغيرهم. وقد تجلت فرادته في الأمور التالية:
- لقد أحب الوجهاء والأعيان والحكام، ولم يقف هنا بل أحب أيضاً أخوة يسوع الفقراء والمساكين دون قيد أو شرط.
- ما أحب الذين أحبوه وحسب، بل أحبّ أيضاً الذين يعادونه، وهكذا حقق وصية يسوع «أن أحبّوا أعداءَكم وباركوا لاعنيكم».
- دافع وحيداً عن المظلومين من الفقراء ومن علية القوم وحتى من القضاة (قاضي طرابلس _ الملك فيصل).
- كان رجل الوفاء والوطنية، وفياً للناس جميعاً وللملك فيصل وحتى للدولة العثمانية، التي أغدقت عليه القمح، لما عرفت أنه يوزعه لجميع الناس وحتى أن السلطان منحه الوسام المجيدي.
وإن كان غريغوريوس فريداً في مسلكه وتصرفه، فإن المسلمين أيضاً كانوا أيضاً أهل وفاء ومروءة معه. ذاك الثري الذي اشترى له الصليب من الصائغ اليهودي وأعاده إليه. وحتى الملك فيصل أخرج الطبيب اللبناني من السجن وأرسله إلى بلاده وطالباً إليه أن يقبل عنه يد البطريرك غريغوريوس. وكذلك ذاك القاضي الذي ظهرت براءته بعد حين، أوصى أولاده أن يذهبوا من استنبول إلى دمشق، وقبل أن يدخلوا الجامع الأموي أن يأتوا إلى بطرك الروم ويقبلوا يديه.
ولذا عند وفاته في 12 ك1 1928 في سوق الغرب «نقل جسده عبر بيروت إلى دمشق فاستقبله خمسون ألف مسلم دمشقي غير المسيحيين وأطلقت المدفعية مئة طلقة وطلقة فيما كانت الجماهير تصرخ: «مات أبو الفقير بطريرك النصارى وإمام المسلمين. نزلت بالعرب الكارثة العظمى»
وقد شارك الملك فيصل من العراق بمئة فارس استقبلوا نعشه، كما شارك في الجنازة عدد كبير من شيوخ المسلمين. مفتي البقاع محمد أمين قزعون قال على تابوته: «لو أجاز لنا ديننا الاعتراف بنبي بعد محمد لقلتُ أنت هو!» وقد قيل إن المسلمين أرادوا الصلاة عليه في الجامع الأموي الكبير»( ).
أحد التجار المسلمين الدمشقيين كان يرش الملبّس ويصيح بأعلى صوته: «هذا القديس أعالني أنا وأسرتي طيلة الحرب»( ).
هذه الصيحة المسلمة التي أعلنت عفواً قداسة البطريرك غريغوريوس عام 1928، لقيت صداها بعد سبعةٍ وستين عاماً، عند الراهب الأرثوذكسي توما بيطار فسمّاه في كتابه( ) قدّيساً منسياً. فلنطالب جميعاً مسلمين ومسيحيين بإعلان قداسة «غريغوريوس حدّاد»، متذكّرين أن القداسة هي دعوتنا من ربّ العالمين، على لسان أنبيائه في العهد القديم «كونوا قديسين كما أنا قدوس».
وفي الختام تعالوا معاً يا أبناء آدم، لندرك «أن الناس سواسية كأسنان المشط» وأن الخلق كلهم عيال الله وأن أكرمهم عند الله أتقاهم. فلنتسابق في الخيرات مدركين أن ما محمد إلاّ رسولُ قد أرسل رحمة للعالمين وليتمم مكارم الأخلاق، وأن عيسى ما هو إلا كلمة الله وروح منه. وإنّا جميعاً لله وإنا إليه راجعون.
فلنرجع إليه كتفاً إلى كتف ويداً بيد مردِّدين : « .... للرب الأرض بكمالها المسكونة والساكنون فيها».
مراجع
1- القديسون المنسيون في التراث الأنطاكي، توما بيطار، منشورات النور، 1995.
2- كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى، ج3، أسد رستم، المكتبة البولسية، 1988.
3- اللآلئ السنية لعروس الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، عبد المسيح أنطاكي، بلا تاريخ.
4- البطريرك غريغوريوس الرابع (حداد)، أطروحة ماجستير في جامعة البلمند، ماري مالك، 2003.
5- أبرشية طرابلس في القرن العشرين، أطروحة ماجستير في جامعة البلمند، الأب جبرايل ياكومي، 2002- 2003.
6- الأرثوذكس في طرابلس، نموذج عن أوضاع الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية، أطروحة ماجستير في جامعة البلمند، إبراهيم دربلي، 2006.
7- تاريخ كنيسة أنطاكية، خريستوستمُس بابادوبولس، منشورات النور، 1984.
8- لبنان من الإمارة إلى المتصرفية، 1840- 1861، عهد القائمقاميتين، مارون رعد، دار نظير عبود، بيروت، 1993.
9- تراجم علماء طرابلس وأدبائها، عبدالله حبيب نوفل، مكتبة السائح، 1984.
10- دير البلمند ومدرسته الاكليركية 1833- 1940، اعداد سناء حنا عبود، البلمند، 1983.
11- تاريخ كنيسة أنطاكية للروم الأرثوذكس: أية خصوصية؟ جامعة البلمند، 1999.
12- مجلة الكلمة، التي أصدرتها مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس، الأعداد من 1-12، التي صدرت في الأعوام 1981- 1985.
13- تاريخ طرابلس قديماً وحديثاً، سميح وجيه الزين، دار الأندلس، 1969.
14- الشيخ حسين الجسر 1845 – 1919م حياته وفكره، خالد زيادة، دار الإنشاء، طرابلس 1982.
15- المواسم، العدد الأول، السنة الأولى، ت1 1981.
16- الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية، حسين الجسر، تحقيق د. خالد زيادة، جروس برس، طرابلس، بلا تاريخ.
17- طرابلس في النصف الأول من القرن العشرين ميلادي، محمد نور الدين عارف ميقاتي، دار الإنشاء، طرابلس، 1978.
18- النظرات المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين في الماضي والحاضر، جامعة البلمند، 1997.
19- في العلاقات المسيحية الإسلامية، ج2، محمود أيوب، جامعة البلمند، 2001.
20- العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الشام، جامعة البلمند، 2004.
21- ذكرى مرور السنة الأولى على وفاة العلاَّمة الطيِّب العين والأثر، غريغوريوس حدّاد. بقلم عيسى اسكندر المعلوف، المطبعة الأدبية، بيروت، 1929.
رشيد رضا والمسألة العربية
بقلم د. أنيس الأبيض
نشأة رشيد رضا
قبل أن نستعرض موقف السيد رشيد رضا من المسألة العربية، لا بد أن نعرّج، ولو بشكلٍ موجز، على مسيرته. فهو مؤسس وصاحب مجلة المنار وتفسيره وغيرها من الآثار. فقد عاش نحو من سبعين سنة، كانت حافلة بالأحداث والأعمال، وما قيل عن هذه السيرة، أو ظهر بشأنها، لا يتجاوز نطاق الإجمال. فهي تكمن في أمرين :
أحدهما فطري، وهو الاستعداد الذي يتوافر له من كمال الخلقة، واعتدال المزاج، وحسن الوراثة للوالدين والأجداد. وثانيهما مكتسب ، وهو التربية والتعليم النافع . وقد اجتمع هذان الأمران في شخص محمد رشيد رضا، إذ هو سليل بيت عربي إسلامي عريق، يتحدّر من نسل الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، ويستمد بالتالي الشرف والسيادة من انتمائه الى العترّة النبوية الشريفة (1) .
ولنسمعه يحدّثنا عن بيئته وبيته : " ولدت ونشأت في قرية تسمى القلمون على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبنان . تبعد عن مدينة طرابلس الشام زهاء ثلاثة أميال، وكان جميع أهل هذه القرية من السادة الأشراف المتواترين النسب. وأهل بيئتنا ممتازون، ويعرفون بأنهم أهل العلم والإرشاد والرياسة ويلقبون بالمشايخ للتمييز"(2)
في هذه البلدة – القلمون، ولد محمد رشيد رضا في العام 1282 هـ / 1865 م، وتوفي العام 1354 هـ / 1935م. فلا غرابة في أن يكون السيد الإمام قد اصطبغ بصبغة ذلك الوسط الديني الصافي، وأن تكون تلك الطبيعة التي ترعرع في أحضانها، قد فرغت فيه الشيء الكثير مما أغدقته على بلدته، فجاء شامخ الرأس كجبال القلمون، صلباً في دينه وعقيدته كصخورها، فيّاضاً في علمه، كذلك البحر الزاخر. الذي كان يجلس على شاطئه في ريعان شبابه. فكان أن طلب العلم بإخلاص، وتوجيه الإرادة ليكمل به نفسه ويؤهلها للإصلاح الديني والاجتماعي، حتى أصبح من أشجع دعاته وأشدهم جرأةً في مواطن الحق على الحكّام والعلماء (3) .
ويعرّج رشيد رضا في سيرته للحديث عن أساتذته الذين تخرّج عليهم، فيشير الى أنه قد تخرّج في العلوم العربية والشرعية العقلية على الشيخ حسين الجسر، الذي يصفه بأنه كان له إلمام واسع بالعلوم العصرية. وكان كاتباً وشاعراً عصرياً يكتب وينظم في كل موضوع بعبارة سهلة . كما كان من أساتذته الشيخ محمود نشابه، والشيخ عبد الغني الرافعي، والشيخ محمد القاوقجي كما يذكر بعض من طلبة العلم الذين عاش معهم، كالعالم الأديب الشيخ عبد القادر المغربي، وسعيد كرامه، وعبد الغني الأدهمي، والشيخ عبد المجيد المغربي والشيخ محمد الحسيني (4)
هجرته الى مصر
لخّص رشيد رضا ترجمة سيرته وما انتهى إليه في وطنه من تربية وتعليم استقلالي، وآثار قلمية وشهرة علمية وأدبية وقناعة بضرورة السفر للاستزادة من العلم والاختيار، حتى يتمكن من مواصلة خدمة دينه وأمته: " عزمت على الهجرة الى مصر، لما فيها من حرية العمل واللسان والقلم، ومن مناهل العلم العذبة الموارد، ومن طرق النشر الكثيرة المصادر ... "(5).
أتيح للسيد الإمام، وبعد صدور العدد الأول من المنار، في الثاني والعشرين من شوال 1315/ 1898، نشر آرائه الإصلاحية الدينية والاجتماعية والسياسية، فكان أن جال قلمه في كل القضايا التي تخص العالمين العربي والإسلامي، بدءًا بموقفه من الانقلاب العثماني، مروراً بالوثائق الرسمية للمسألة العربية، وملاحظاته على الرسائل المتبادلة بين مكماهون والشريف حسين وانخراطه الفاعل في المؤتمرات التي عقدت آنذاك، كالمؤتمر السوري العام الذي عقد في أوائل سنة 1919، وسائر المؤتمرات الأخرى. وتطرّقه الى وضع الخلافة أو الإمامة العظمى، ورأيه في الثورة السورية والحركة الوهابية، وموقفه المبكر والمتميّز من الحركة الصهيونية وعملها لاحتلال فلسطين وسائر البلاد .
المسألة العربية عند رشيد رضا
تولّدت عند رشيد رضا قناعة مفادها أن العرب بأغلبيتهم الساحقة كانوا غير ميالين الى الانفصال عن جسم الدولة العثمانية، رغم شعورهم بالنقمة وعدم الرضى عن المساوئ الناتجة عن تصرفات الحكام في الولايات والأقاليم، بل كانوا يطالبون بإلحاح بالإصلاح الإداري والسياسي والعسكري والاقتصادي ويصرّون على التماسك العربي – التركي في وجه أطماع الدول الغربية في ممتلكات الدولة العثمانية.
على أن صفاء النوايا العربية، وولاءهم لدولة الخلافة في فترة حكم الاتحاديين، لم ينسِ رشيد رضا موقف الاتحاديين من المسألة العربية. فبعد أن اتهمهم بإضاعة ثلثي المملكة العثمانية، وجميع الولايات العربية ومعظم الجزر البحرية، شنَّ عليهم هجوماً عنيفاً، واتهمهم بإفساد الجيش العثماني والتفريق بين العناصر المكوّنة له، وإضاعة الأموال. وأنهم عمدوا لتأسيس بعض الجرائد العربية في عاصمة الدولة الأستانة، غرضها التفريق بين العرب وغشّهم ومخادعتهم، وتحقير مصلحتهم، وإيقاع الشقاق بين مسلمي سوريا والنصارى منهم، بالرغم من معرفتهم أن أواصر التآخي والوفاق قد شدت المسلمين والنصارى في بيروت.
وأجمع الطرفان على أن يكونوا يداً واحدة في طلب الإصلاح لبلادهم، وهذا ما لا يطيقه الاتحاديون. ويعتقد رشيد رضا أن تعريض البلاد العربية لاستيلاء أوروبا عليها أخف على قلوب الاتحاديين وأدنى في سياستهم من اتفاق أهلها وصلاح حالهم(6).
ويناشد رشيد رضا عقلاء البلاد السورية من المسلمين والنصارى ليعتبروا بهذا الآخاء، فيزدادوا استمساكاً بحبل الوفاق والتآلف الذي وفقهم الله له. وأن يُعني كتّاب المسلمين منهم خاصة بردّ كل كلام يكتب لإفساد ذات بينهم باسم الإسلام، وبتحريك نعرة العصبية الدينية، فإن هذا الإفساد مخالف لهدي الإسلام.
هذا الحرص الذي أبداه رشيد رضا على ضرورة تعاون أبناء البلاد السورية، جعله يوجّه نداءً الى مسلمي سوريا بضرورة التعاون مع أبناء جنسهم من النصارى، رافضاً أساليب منتحلي الدعوة الى قيام الجامعة الإسلامية الذين يستدلون بالآيات القرآنية، ولا يعقلون مدلولاتها. إذ أن بينهم ممن يلفظ بالدعوة الى الجامعة الإسلامية، دون أن يعرف حقيقة دعوة الإسلام، فلا يصلي ولا يصوم .
وأمثال هؤلاء أبرع في فن التجارة والدين " فلا تغتروا بما يقولون، ولا بما يكتبون . "ورب كلمة حق أريد بها باطل " . لذلك كان إصراره على ضرورة اتفاق أبناء الجنس والوطن على كل ما فيه المصلحة المشتركة التي تجمع المسلمين والنصارى على قاعدة المنار الذهبية "نتعاون فيما نشترك فيه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما يختلف فيه"، ونحن متفقون في اللغة، وفي مصالح البلاد الزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية، فنتعاون على ذلك بغاية الإخلاص ويعذر بعضنا بعضاً في أمر الدين " (7)
أما موقفه من المسألة العربية، فلقد ظهر من خلال نقاط عدة أبرزها :
موقفه الإصلاحي غير الطائفي، وتثمينه لأهمية العنصر العربي في جسم الدولة العثمانية .
ميله الى الوحدة العربية في إطار الوحدة الإسلامية .
موقفه من القضية اللبنانية، واهتمامه بالقضية الفلسطينية .
يرى رشيد رضا أن العصبية الجنسية في ذلك العصر، قد دخلت في طور سياسي جديد، وذلك بسبب السياسة التي اتبعها الاتحاديون . فالأستانة بسياسة حكومتها وإدارتها بعد الدستور، وسياسة جرائدها، قد كوّنت هذا الشعور، وجعلته حياً نامياً، وينفي عند العرب صفة التعصّب الجنسي والعِرقي، إذ أنهم آخر الأجناس شعوراً بها، لأن سوادهم الأعظم مسلمون، لا يكادون يشعرون بغير الجنسية الدينية .
ويتهم الاتحاديون بأنهم وراء هذه السياسة الجديدة التي ظهرت في العاصمة، وهي أن العصبية الجنسية نافعة أو ضرورية ليرتقي كل جنس، وأنه يمكن الجمع بينها وبين الوحدة العثمانية، ولا سيما الوحدة بين العرب والترك من العثمانيين، وأنه يجب على كل جنس أن يُرقّي نفسه من غير أن يضر غيره، أو يحول دون الوحدة العثمانية .
ولا يرى السيد الإمام إحراجاً في الجهر بانتسابه العربي، فنراه يكتب في مقال عن المسألة العربية قائلاً: " إني عربي مسلم، أو مسلم عربي. فأنا قرشي علوي من ذرية محمد النبي العربي الذي ينتهي نسبه الشريف الى إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام . فإسلامي مقارن في التاريخ لعربيتي ... فأنا أخٌ في الدين لألوف الألوف من المسلمين من العرب وغير العرب، وأخٌ في الجنس لألوف الألوف من العرب المسلمين وغير المسلمين (8).
هذا التوافق بين مصالح العرب والمسلمين، دفع رشيد رضا للتطلّع إلى نهضة العرب ومستقبلهم، دون أن يكون ذلك متعارضاً مع مصلحة الدين، وبعيداً أن يكون في هذا الموقف تعصباً للجنس العربي الذي ينتسب إليه .
من هنا يرى أن في خدمة جنسه العربي خدمة لدينه، وهذا ما يفسّر دعوته وإعلانه أن مصلحة العرب والمسلمين في أن يكون للعرب دولة. ويرى أن السبب في ضعف الأمة الإسلامية، يعود إلى ضعف مزايا أمة العرب ولغتها وإهمال معظم شريعتها. وكل ذلك لعدم وجود دولة مستقلة (9) .
إن هذا المنحى الذي سلكه رشيد رضا في المزج بين مصلحة العرب والمسلمين، دفعه للعمل على نهضة العرب، مبيّناً أهمية العلاقة بين مسلمي ومسيحيي العرب في آنٍ معاً. كما شدّد على ضرورة اتفاق الشعوب العربية فيما بينهم على اختلاف مذاهبهم ودينهم. كما أصرَّ على أهمية اتفاق المسلمين والنصارى في داخل الوطن السوري، خاصةً أن السوريين كانوا سبّاقين في وعيهم بأن يكون لهم وطن خاص بهم، معلوم الحدود والمصالح. وأهله مكوّنون من أصحاب ملل ومذاهب يرجعون في أكثريتهم الى فريقين:مسلمين ومسيحيين حيث يتوقف عمران البلاد وتطورها على تعاون الفريقين .
ويصرّ رشيد رضا على ضرورة التعاون بين أبناء الأمة العربية الواحدة. وكانت تشده روابط قوية بعدد كبير من النهضويين المسيحيين، بل إنه ذهب إلى حد القبول برئاسة أحدهم الذي انخرط فيه، وهو الاتحاد السوري الذي ترأسه ميشال لطف الله .
من هنا، وجدنا حرصه على ضرورة التعامل مع المسيحيين العرب بدليل إصراره على مشاركتهم في كل جمعية أو حزب سياسي، كجمعية الشورى العثمانية، وغيرها من الجمعيات والأحزاب. بل نجده يرد على جرجي زيدان في كتابه "التمدن الإسلامي " ص 39 ، نافياً الخلط بين العروبة والإسلام مميزاً بينهما، دون أن يجد التعارض في ذلك .
عمله في سبيل الوحدة العربية في نطاق الوحدة الإسلامية
من خلال متابعة النهج الإصلاحي الذي سار عليه رشيد رضا، نراه يدعو العرب الى التمسك باللغة العربية، ويستنهض الهمم العربية ضمن الهمم العثمانية ولم يتعد اتجاهه حدود المطالبة بتحسين أوضاع الولايات العربية، دون أن يصل الى حد المطالبة بالاستقلال والتخلي عن وحدة الدولة العلية .
من هنا ظهرت رغبة رشيد رضا واضحة في الإصلاح، ومحاولة رأب الصدع ، وتلافي الانشقاق بين العنصرين العربي والتركي، وحرصه على تفنيد ادعاء كل من الفريقين بالأفضلية على الآخر، لقناعته بوجوب تجاوز هذه الاختلافات، لما تشكله من خطورة على وحدة الدولة العلية، ولاعتقاده بحسن التجاوب عند المسؤولين في عاصمة الدولة الأستانة. وكان حريصاً في كل ما كتبه حول هذا الموضوع على ضرورة نبذ فكرة التباعد والتنابذ بين الفريقين .
وبالرغم من دعوته هذه، نراه لا يخفي قلقه تجاه سياسة الاتحاديين في العاصمة، ضد العناصر العربية، حيث عزل العرب عن وظائفهم، وشكا من ضعف اللغة العربية، وإحلال التركية مكانها في الدوائر الرسمية وفي الكشوفات التجارية في الولايات العربية. ومع ذلك، فلقد بقي يدعو إلى تقوية الأمة الإسلامية، عن طريق تقوية العناصر المكوّنة لها، وخاصةً العنصر العربي فيها لما له من فضل في تطور الدولة العثمانية عسكرياً وثقافياً وسياسياً .
ونراه يقول : " ... يجب على كل بلد أو ولاية عثمانية، أن تعنى بترقية نفسها بالعلم والثروة، لتكون عضواً قوياً عاملاً في بنية الأمة، لا لأجل انفراد أهلها بنفسهم، أو اعتصامهم بأبناء جنسهم، فإن الأمم المستقلة في أحكامها المختلفة في لغاتها ومذاهبها ومواقفها، يتحد بعضها ببعض ليقوى الجميع بالمحالفة... فكيف تضعف الشعوب العثمانية نفسها وهي أمة واحدة (10).
من هنا نلاحظ أن السيد رشيد رضا كان متفهماً للواقع السياسي الذي كان يعيشه، فالأمة العربية في خطر، والأمة العثمانية في خطر. وبما أن الخطر مشترك، فهو يدعو الى الوقوف والتنسيق معاً، شرط الاحترام المتبادل،وشرط أن تتم الوحدة العربية في نطاق الوحدة الإسلامية. وهكذا نرى أن موقف رشيد رضا في حالة قيام الدولة العربية، وتحقيق الإصلاح في داخل الولايات العربية بقي مرتبطاً، على أهميته آنذاك بالحفاظ على وحدة الدولة العثمانية والخوف عليها من التشتت والضياع، والوقوع فريسة الأطماع الأوروبية التي كانت تتحيّن الفرص للانقضاض على ممتلكات الدولة العثمانية واقتسامها . لذلك ظل يرفع شعار إصلاح العرب لأنفسهم، لأن في هذا الإصلاح والرقي، ضمانة لاستمرار وحدة الدولة العثمانية والحفاظ على تماسكها في وجه الرياح العاتية التي كانت تهب على مناطقها المتعددة، وتنذرها بأوخم العواقب(11).
موقف رشيد رضا من القضية اللبنانية
جال رشيد رضا في مختلف القضايا التي تخص العالم العربي آنذاك. من هنا وجدناه يعرّج في مناره على القضية اللبنانية، متناولاً موقف المسلمين والمسيحيين. فالمسلمون اللبنانيون يتعلّقون بالدولة العثمانية على أنها دولة إسلامية استمرارية، ولكنهم بدأوا يتأففون من سياسة التتريك على أيدي الإتحاديين. أما المسيحيون، فكانوا يريدون التخلّص من الحكم التركي، ويريدون الاستقلال أو التبعية لدولة أوروبية، وخاصةً فرنسا.
لكن رشيد رضا يدعو الجميع الى التماسك والتحابب والوقوف جنباً الى جنب ضد سياسة التتريك، وضد سياسة الهيمنة الأوروبية. كما يتناول مبادئ " جمعية النهضة اللبنانية "بعنوان " من مبادئ النهضة اللبنانية ومنازعها "المنشورة في جريدة الهدى التي كانت تصدر في نيويورك، وقد تضمّنت هذه المبادئ ستة وأربعين بنداً، تناولت وضع اللبنانيين في الداخل وفي الخارج، ودعت الى الاستقلال الموروث، وغير ذلك من الأمور السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تخص اللبنانيين .
ويشير رشيد رضا إلى الغلو في هذه الدعوة، بحيث أنها باعدت بين أفراد المجتمع اللبناني من ناحية الانتماء العربي والعادات والتقاليد المشتركة، ولغة الأم أي اللغة العربية (12).
وينصح اللبنانيين بعدم الانسلاخ عن الأمة العربية وعن البلاد السورية في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، نظراً لتكالب الأعداء على ابتلاع المناطق العربية من قبل الغربيين، ويطلب منهم الاعتدال، والمقصود هنا جماعة النهضة اللبنانية.
وفي هذا الصدد يقول :" يظهر مما نشرنا، ومما لم ينشر مما يكتبه غلاة الدعوة اللبنانية، أنهم يُمنّون أنفسهم مما ليس في طاقتهم، يُمنَون أنفسهم بأن يكونوا دولة قوية مستقلة تمام الاستقلال، منفصلة عن جدتهم الأمة العربية، وأمهم سوريا نفسها، لا عن الدولة العثمانية فقط، ولا يكون مثل هذا إلا لشعب حربي قوي. وكذلك تكثر أصحاب دعوة الاستقلال من ذكر قوة الجبل وامتناعه عن الفاتحين، وانتصاره على المصريين، وإخراجهم جيش محمد علي الكبير من سوريا وردها إلى الدولة، والاسترسال في المبالغات (13).
رشيد رضا والحركة الصهيونية
قبل أن نتعرف على موقف السيد الإمام رشيد رضا من الحركة الصهيونية، لا بد من التذكير بأن متابعة مواقف الإمام عبر نصوصه التي كتبها في المنار تكتسب في هذه المرحلة التي يمر بها العالم العربي أهمية قصوى، حيث تطرح مهمة إعادة قراءة تاريخنا على أكثر من صعيد ولأكثر من سبب.
كان رشيد رضا من أوائل رجال الدين المصلحين، الذين أدركوا أبعاد الأهداف التي تطرحها الحركة الصهيونية لاحتلال فلسطين والأقطار العربية المجاورة. واستطاع أن يربط بين الأحداث السياسية التي كانت تجري في الدولة العثمانية، من صراع سياسي قوي، خاصة بعد الانقلاب العثماني الذي قادته حركة الاتحاد والترقي وارتباطها بالحركة الماسونية ففي هذه الفترة كانت الدوائر الصهيونية لا تزال تسعى مع الساعين لتغيير نظام الحكم في تركيا ونتيجة للتعاون الصهيوني – الماسوني قرر "الشرق الأعظم" الفرنسي في عام 1900 إزاحة السلطان عبد الحميد، وبدأ يجذب لهذا الفرض حركة "تركيا الفتاة" منذ بدايتها(14).
والواقع أن المبادئ اليهودية والماسونية أثرتا كثيرا على منتسبي جمعية الاتحاد والترقي الذين حافظوا على تلك المبادئ والتقاليد حتى بعد الثورة، وهناك مسألة جديرة بالتدقيق والتأمل وهي أن اليهود المنتسبين لفرقة الاتحاد والترقي أصبحوا أصحاب الكلمة العليا والنفوذ في هذه الجمعية (15).
حرص رشيد رضا في مجمل كتاباته على التفريق بين اليهود الصهاينة، ففي مسألة دريغوس التي أثيرت في فرنسا، وقف موقف المتعاطف مع اليهود ويرجح أن سبب حقد الأوروبيين على اليهود واضطهادهم لهم يعود سببه إلى التعصب الجنسي والحسد الذميم، اللذين أثارهما في صدر الأمة فئة من أرباب الجرائد المعادين لليهود الطامعين بما لديهم من خزائن الأموال، كما يبدي استغرابه لانتقال داء الجرائد الإفرنسية إلى بعض الجرائد المصرية، فيقول:" ومن الغريب أن أداء الجرائد الإفرنسية قد سرى إلى بعض الجرائد المصرية. فقامت تصلي اليهود نارا حاميا وتأخذ عليهم في مهارتهم في الكسب وتفننهم في أساليب الربح. أما نحن فرأينا أن الحرية العمومية ليست مختصة بفريق دون فريق. فإن التمدن الصحيح والعدالة الحقيقية تفرضان المساواة المطلقة بين جميع بني الإنسان في المنافع العمومية والعمل والكسب بالطرق المشروعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ومن يعترضه في ذلك فقد اعترض مبدأ الحرية العمومية. ولذلك لا نرى عاقلا من عقلاء الأمة الفرنسية راضيا عما نال اليهود في فرنسا من الاضطهاد قديما وحديثا. وقد سمى ذلك بعض كبار فلاسفتهم مرضا من الأمراض العارضة وأمل ذهابه بتقدم المدنية والآداب العمومية (16).
غير أن تساؤولا من مواطن عربي يقيم في أوروبا. بعث به إلى مجلة المقتطف حول أهداف الصهيونية ومؤتمر بال. نقله رشيد رضا إلى المنار تحت عنوان خبر واعتبار. وعلّق عليه قائلا:" فيا أيها القانعون بالخمول أقنعوا رؤوسكم [ ارفعوها ] وحدقوا أبصاركم وانظروا ماذا تفعل الشعوب والأمم. أصيخوا لما تتحدث به العوالم عنكم. أترضون أن يسجل في جرائد جميع الدول أن فقراء أضعف الشعوب الذين تلفظهم جميع الحكومات من بلادها هم من العلم والمعرفة بأساليب العمران وطرقه بحيث يقدرون على امتلاك بلادكم واستعمارها وجعل أربابها أجراء وأغنيائها فقراء... تفكروا في هذه المسألة واجعلوها موضوع محاورتكم لتتبيّنوا هل هي حقة أم باطلة صادقة أو كاذبة ثم إذا تبيّن لكم أنكم مقصرون في حقوق أوطانكم وخدمة أمتكم وملتكم فانظروا وتأملوا وتفكروا وتذكروا وتحاوروا وتناظروا في مثل هذا الأمر فهو أخل بالنظر من اختلاف المعايب وانتحال المثالب، وألصاقها بالبرآء وأحرى بالمحاورة من التذقح والتجني على إخوانكم فإن في الخير شغلا عن الشر وفي الجد مندوحة عن الباطل {وما يتذكر إلا من ينيب}(17)
تابع رشيد رضا محاولات الحركة الصهيونية ومساعيها للسيطرة على أرض فلسطين كما أنه أدرك تطور الأحداث التي كانت تجري داخل الأستانة وجرأة اليهود في السعي لاحتلال فلسطين وإحلال المهاجرين اليهود فيها.
" وذكرنا الجمعية الصهيونية ومساعيها في إعادة السلطة والملك إلى الشعب إسرائيل . لليهود جمعيات ملية كثيرة، ولم نسمع بذكر الجمعية الصهيونية إلا من نحو خمس سنين وهي جمعية سياسية غرضها الاستيلاء على البلاد المقدسة لتكون مقر ملكهم وعرش سلطانهم. وأن حركة هذه الجمعية ظهرت فجأة في النمسا وألمانيا وانكلترة وأميركا ولم تكن تظهر في أول الأمر طلب الملك وإنما كانت تتظاهر بحب نقل فقراء اليهود المهاجرين والمخرجين ( المنفيين) إلى بلاد فلسطين، ليعمروها ويعيشوا في ظل السلطان آمنين، وكأنها وثقت بقوتها الآن، فخرجت من مضيق الكتمان، وقد بعثت منذ أشهر المستر إسرائيل زنفويل من لندرة إلى الأستانة للمساومة في شراء القدس الشريف (18).
كان لرحلة رشيد رضا إلى عاصمة الدولة العثمانية بعد إعلان الدستور العثماني أهمية بالغة في فهمه أبعاد ما ترمي إليه الحركة الصهيونية ومخططاتها في السيطرة على أرض فلسطين ويكشف رشيد رضا بعد زيارته لاستانبول، خطط الصهيونية لامتلاك فلسطين ونفوذ اليهود في دوائر الحكم الجديد فيقول: "إن آمالهم في القدس وفلسطين معروفة ومطامعهم الحالية في المكان يعظم نفوذهم فيه غير مجهولة. وقد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحكومة خطبا بيّنوا فيها خطر جمعية اليهود الصهيونية على المملكة العثمانية وخطبوا خطبا أنكروا فيها على ناظر المالية بيعه أحسن موقع عسكري في الأستانة لشركة أجنبية بثمن دون ثمن المثل لسمسرة بعض اليهود، وهم يرون أنه يمكن بيع ذلك المكان بأضعاف ذلك الثمن وقد دافع الصدر الأعظم في المسألة الأولى عن الحكومة وعن اليهود. ودافع جاويد بك عن نفسه في الثانية، ونحن لا نتعرض للمحاكمة والترجيح بين المجلس والحكومة وحزبها وإنما ننبه الناس للتأمل والاعتبار (19).
إن تحسس رشيد رضا بالمخاطر الصهيونية التي تهدد الدولة العثمانية وفلسطين، دفعه للتصريح وتنبيه قادة الدولة إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع داخل الدولة إذا لم تنتبه الأمة العثمانية لكيدهم " فهم الآن يظهرون المساعدة للحكومة العثمانية الجديدة لتساعدهم على ما يبتغون، فإذا لم تتنبه الأمة العثمانية لكيدهم وتوقف حكومتها عند حدود المصلحة العامة في مساعدتهم. فإن الخطر من نفوذهم عظيم وقريب فإنهم قوم اعتادوا الربا الفاحش فلا يبذلون درهما من المساعدة إلا لينالوا مثقالا أو قنطارا من الجزاء. وطمعهم فيها أشد وخطره أعظم، فإن بيت المقدس له شأن عظيم عند المسلمين والنصارى كافة. فإذا تغلّب اليهود فيه ليقيموا فيه ملك إسرائيل ويجعلوا المسجد الأقصى ( هيكل سليمان) وهو قبلتهم معبدا خالصا لهم يوشك أن تشتعل نيران الفتن. ويقع ما نتوقع من الخطر فيجب أن تجتهد الأمة العثمانية في درء ذلك ومدافعة سبيله بقدر الاستطاعة لئلا يقع في أبان ضعفها فيكون قاضيا على سلطتها ونسأل الله السلامة (20)
ثم إن رشيد رضا عاد إلى تجديد الانتباه إلى أخطار الحركة الصهيونية. خاصة في مسألة خطيرة طرحت نفسها على الدولة العثمانية، وهي قضية الاستفادة من أموال الدول الأوروبية في عملية التقدم العمراني والتطور الاجتماعي داخل أرجاء السلطنة. فبدأ بالتمهيد لمناقشة مسألة الأحوال الأوروبية، فكتب يقول:" أشرنا في المقالة الأولى التي كتبناها عند إعلان الدستور إلى ما أمامنا من العقبات والمشكلات السياسية والأدبية والاقتصادية في طريق هذا التطور الجديد من الحكم، وقد وقع جميع ما كنا نتوقع... وقولنا:" إن الحرية ما حلت في بلاد كبلادنا خصبة التربة جيدة الإنبات، غنية بالمعادن والغابات قابلة لرواج التجارة والصناعات، إلا وتدفقت عليها أموال أوروبا لأجل استثمارها فيها... فمن المطالب بتنبيه الأمة إلى طرق الثروة الطبيعية مع حفظ رقبة بلادها . والحذر من قضاء الديون الأجنبية عليها.
ثم كان المنار هو السابق لجميع الصحف – على ما نعتقد – إلى تنبيه على نفوذ اليهود الصهيونيين في جمعية الاتحاد والترقي وما في ذلك من الخطر على الدولة، حتى أنكر علينا ذلك بعض أصدقائنا المخلصين من المسلمين وغير المسلمين بمصر ورد علينا بعض اليهود في جريدة المقطم ولم تلبث الحقيقة أن ظهرت بعد ذلك في مجلس الأمة العثمانية أولا ثم على لسان الصدر الأعظم حقي باشا الذي صرح في خطاب له بأن اليهود هم أصحاب المستقبل في هذه الدولة حتى في أمورها الإدارية والعسكرية فهذه مقدمة أولى للكلمة التي نريد أن نقولها الآن (21).
غير أن الخطر الذي يتهدد البلاد العثمانية والقوى داخل الدولة العثمانية المناصرة لليهود والعاملة على تسهيل سبل إحكام سيطرتهم على أمور الدولة الإدارية والعسكرية بل والاقتصادية، كل ذلك لم يمنع رشيد رضا من وضع أطر التعاون الاقتصادي مع أوروبا، مع ما يحمل ذلك من معالم الخطر الصهيوني على الدولة فيقول:" إن عمران بلادنا يتوقف على استعمال الأموال الأوروبية فيها وزمام هذه الأموال في أيدي اليهود. وأضرب لذلك مثلا وقع بمصر وهو أن بعض الناس قال لتاجر يهودي وقد ساومه في ساعته إنني لا أريد أن أشتري شيئا يربح منه اليهود. فقال اليهودي إذا لا تشتري شيئاً قط. ولأجل هذا يصانع الاتحاديون اليهود الصهيونيين وغير الصهيونيين، فإذا كان إخواننا السوريون لا يقبلون مشروعا فيه أموال لليهود فليعلموا أن معنى هذا أنهم لا يقبلون مشروعا عمرانيا كبيرا في بلادهم مطلقا، وبعبارة أخرى لا يقبلون أن تعمر بلادهم (22) .
ومع عدم اعتراضه على المشاعر الوطنية السورية وحساسيتها من أموال اليهود، ورفض التعامل معهم، فإنه يرى أن أهل البلاد السورية بل والعثمانية كلها عاجزون عن القيام بالمشروعات الكبيرة من زراعية وتجارية لا لقلة مالهم فقط، بل لذلك ولجهلهم، بما تتوقف عليه تلك المشروعات من العلوم والفنون والأعمال الهندسية والآلية، فهم في أشد الحاجة إلى الاستعانة على تلك المشرعات بأموال الأوروبيين ورجالهم، وإلى الاحتكاك به والاشتغال معهم لأجل التعلم منهم (23) .
وينحصر الخطر الصهيوني عند رشيد رضا في شيء واحد هو " امتلاكهم للأرض المقدسة، لذلك فإنه يدعو كل من يقدر على حمل الحكومة العثمانية على منعهم من ذلك أن لا يألو فيه جهدا ولا يدّخر سعيا (24).
كما أن الخطر من استعمال أموال الأجانب اليهود وغيرهم، ينحصر عنده في أمرين" أحدهما غرق الأهالي أو الحكومة في الديون. وثانيهما تمليكهم لرقبة البلاد، بأن يكون أكثر الأرض أو الكثير منها لهم. وإذا عدّوْنا هذه الخطرين فلا يضرنا أن نستخدم أموال اليهود العثمانيين وأموال الأجانب حتى اليهود وغيرهم في المشروعات التي تعمر بها بلادنا بالزراعة واستخراج المعادن وغير ذلك، بل ذلك نافع لنا لا بد لنا منه إذا اخترنا الخراب على العمران، والفقر على الغنى، وماذا نخاف بعد هذا (25).
أدرك رشيد رضا أبعاد الخطر الصهيوني على البلاد العربية، فعمل على إثارة الحمية الوطنية عند العرب لحماية أرضهم وحفظها ودفعهم للتمسك بها والزود عنها من المخططات الصهيونية الهادفة لامتلاكها وتخليصها من أصحابها الشرعيين، فهو بعد أن يستعرض المسألة الشرقية والصراع الأوروبي ضد الدولة العثمانية والإسلام، ودور الصهيونية في هذا الصراع كتب يقول تحت عنوان المسألتان الشرقية والصهيونية:" فأعجب من ذلك كله تصدي جمعية من يهود أوروبة لتكوين دولة جديدة في البلاد المقدسة من هذه المملكة تتألف من مهاجرة فقراء اليهود المزقين في جميع أطراف الأرض بمساعدة هذه الجمعية؟ ثم يوجه كلامه إلى الناس الجهلة فيقول:" فكيف تسمو همة جمعية أسسها رجل من اليهود إلى تكوين دولة من أوزاع المهاجرين الفقراء في بلاد تتنازع على شبر الأرض فيها أقوى الأمم والدول، وتسفل همة أصحاب هذه عن حفظها لأنفسهم، دع سمو الهمة إلى تأسيس ملك جديد، في قطر قريب أو بعيد. وهكذا تموت الناس وتحيا. وهكذا تردى وترقى، وأسباب ذلك ظاهرة لا محل هنا لشرحها. وكلها تدور حول العلم أو الجهل، وعلو الهمة أو وطوءها وكبر المقاصد وصغرها (26).
ثم إنه يطرح موضوع التفاهم بين العرب واليهود، على أساس التعايش، مؤكدا أن العرب هم المالكون لهذه الأرض وهم أصحابها، ولن يتركوها لليهود غنيمة باردة، وأن التعايش والوفاق هما الأفضل للجميع فيقول في معرض تفسير آيات القرآن الكريم:" واليهود يريدون أن يعيدوا ملكهم لهذه البلاد بتكوين وتأسيس جديد ويستعينون عليه بالمال وطرق العمران الحديثة. فإن الشعوب النصرانية ودولها القوية تعارضهم في التغلب على بيت المقدس، والعرب أصحاب الأرض كلها لا يتركوها لهم غنيمة باردة ولا تغني عنهم الوسائل الرسمية والمكايدة، وإنما الذي يغني ويقني، هو الاتفاق مع العرب على العمران فإن البلاد تسع من السكان أضعاف من فيها الآن (27).
لكن رشيد رضا يعود للتنبيه إلى مخاطر الصهيونية، ويورد بأن المعركة مع اليهود الصهاينة معركة أساسية وأن الصهيونيين إذا تم لهم ما يريدون، فإنهم لا يبقون " في أرض الميعاد " التي يؤسسون ملكهم الجديد فيها مسلما ولا نصرانيا" وليست أرض الميعاد أو فلسطين عندهم ما نسميه نحن فلسطين فقط، بل هي في عرفهم وتحديد كتبهم الدينية تمتد إلى سورية حتى "النهر الكبير" أي نهر الفرات فهذه بلاد لا يجوز عندهم أن يقيم فيها أحد غير الإسرائيليين. وفي سفر (تثنية الاشتراع) أن الرب أمرهم عند دخولهم فيها بعد خروجهم من مصر على يد موسى عليه السلام أن لا يستبقوا من أهلها نسمة ما. فماذا عسى أن يفعل العرب أصحاب فلسطين من أسباب المحافظة على وطنهم وأملاكهم فيه... ولكن أقول لا بد من الروية والحزم وقوة الاجتماع، ولا بد من المسارعة إلى تنظيم وسائل الدفاع وليعلموا أنه لا يكاد يوجد شعب من شعوب الأرض غافل عن قوته واستعداده كالشعب العربي فقوته واستعداده كامنان في كمون النار في حجر الصوان تحت الثلج، فمن ذا الذي يزيل أو يذيب الثلج عن هذا الحجر الصلد، وأين مقدحة الحديد التي تقدح النار في هذا الزند؟ ستجيب عن هذين السؤالين الأيام، فإن الجواب عنهما أحداث وأفعال لا أحاديث ولا كلام (28).
كان رشيد رضا يعلم أبعاد النفوذ اليهودي في أوروبا وسيطرة اليهود على المرافق الاقتصادية والسياسية والإعلامية فيها، ولكنه منذ إعلان وعد بلفور بإقامة وطن يهودي في فلسطين، وبعدما كشف النقاب لأول مرة عن وجود معاهدات سرية في شهر تشرين الثاني1917. عندما عِثر عليها في ملفات وزارة الخارجية الروسية، وقد أصدر تروتسكي وزير الخارجية الروسية آنذاك أمرا بنشرها (29).
راح موقف رشيد رضا يتخذ منحى آخر، وبدأ يعلم طبيعة العلاقة بين الاستعمار الإنكليزي والحركة الصهيونية والمشروع الصهيوني للسيطرة على فلسطين. وقد أفرد رشيد رضا صفحات في المنار عن وعد بلفور (30).
وكذلك الوصف لاحتفالات اليهود المصريين في الإسكندرية بمناسبة هذا الوعد. وللمظاهرة التي ساروا فيها تأييدا لهذا الوعد المشؤوم، وعندما تكشفت له أهداف الإنكليز والصهاينة وعلاقات المصالح المتبادلة بين قوى الشر، وكيف أن الحكومة الإنكليزية قد استخدمت اليهود في الحرب العالمية الأولى لمصلحتها، اشتد عداء رشيد رضا للإنكليز، وفند أبعاد هذه العلاقات بين الإثنين وما يمكن أن تتركه من أخطار على المنطقة العربية واعدة إياهم بجعل فلسطين وطنا قوميا لهم تمهيدا لامتلاكها وكان، وتجديدا لملك اليهود فيها تحت سيادتها. كاشفا المصالح التي جمعت بينهم والبعد الاستراتيجي الذي دفع الحكومة البريطانية لإقامة الوطن اليهودي في فلسطين فكتب يقول:" ونتيجة ما تقدم كله أن اليهود الصهيونيين والمؤيدين لهم من المغرورين يحاولون نقض عقائد المسلمين والنصارى وتكذيب عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم زهاء نصف البشر في الأرض وأصحاب الملك والملك في الشرق والغرب من أعظم أسباب غرورهم تمكنهم من استخدام عظم الدولة المسيحية في الأرض على التمهيد لهذا التكذيب وهي الدولة البريطانية، إننا نعلم أن الإنكليز استخدموا اليهود لإضعاف العرب بإيجاد عدو لهم في بلادهم يقطعون صلة بعضها ببعض ويشغلون كلا منهما بالآخر متكلا على الإنكليز، وأقل فائدة لهم في ذلك أن يحاولوا مقاومة العرب لاحتلالهم بلادهم إلى اليهود، كدأبهم الذي ضربنا له مثل السيل يقذف جلمودا بجلمود وإنما عجبنا من سكوت الدول والأمم المسيحية لهم على إيواء أعداء المسيح إلى بلده، وهو يستلزم تكذيب نذره (31)
كما يبدي رشيد رضا عجبه من تمكن دسائس اليهود من إغواء كثير من نصارى أوروبة وأميركا " وأعجب من ذلك أن دسائس اليهود تمكنت من إغواء كثير من نصارى أوروبة وأميركة وإقناعهم بأن الإيمان بالكتاب المقدس يقتضي مساعدتهم على العودة إلى فلسطين وامتلاك أورشليم تصديقا للأنبياء وتحقيقا لظهور المسيح الذي يختلف الفريقان في شخصه وعمله، فاليهود يعنون مسيحهم الملك الدنيوي الذي يُعيد ملك سليمان لهم، والنصارى يعنون المسيح عيسى بن مريم الذي يجيء في ملكوته ليدين العالم (32).
ثم يعود فيشير إلى الغرض الذي يرمي إليه من هذا التنبيه لدسائس اليهود وأوهامهم الدينية " وإنما غرضنا هنا التنبيه لهذه الدسائس اليهودية والأوهام الدينية وإعلام الإنكليز بأن حكومتهم قد فتحت باب فتنة دينية دنيوية تكون عاقبتها شرا عليهم وعلى البشر عامة مما يظنون ويقدرون، فاتفاق العرب مع الذين يريدون سلب وطنهم وتقطيع روابط أمتهم، والجناية على دينهم ودنياهم ضرب من المحال وأنه لا علاج لهذه الفتنة إلا بالقضاء على هذه المطامع، وقد أعذر من أنذر (33).
سلك رشيد رضا طرقا عدة في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، فلم يكتف من فضح مخططات الاستعمار الإنكليزي الصهيوني، بل رأى أنه من الضروري الاتصال بزعماء الصهاينة ليعلمهم بأن العرب مدركون لأبعاد الدور الذي رسم لليهود في هذا العالم وأنهم لن يقبلوا به لما فيه من إجرام وانتهاك للقيم الإنسانية والدينية، ويحدثنا رشيد رضا عن هذا الاتصال فيقول:" ما زال هذا الأمل يقوى ويضعف، ويطفوا ويرسب حتى طمعوا في عهد السلطان عبد الحميد بإباحة الهجرة والامتلاك بلا شرط ولا قيد، ثم طمعوا في عهد دولة جمعية الاتحاد والترقي ( التي أسقطت هذا السلطان وملكت على من بعده الأمر بمساعدتهم ) في شراء فلسطين من الجمعية ببضعة ملايين من الجنيهات، ولما علمنا بهذه المساعي توخيت أن ألقى معتمد الجمعية الصهيونية بمصر فأستعرف له وأعرفه الحقيقة وأعرفه برأي الجمعيات العربية في الأمر. واهتديت إلى ذلك بسعي بعض معارفي من اليهود. وكان مما كاشفت به المعتمد الصهيوني أن عزم جمعيتهم على شراء فلسطين من إخوانهم في الماسونية زعماء جمعية الاتحاد والترقي قد بلغ زعماء العرب المشتغلين بالسياسة وترقية الأمة العربية وقرروا فيما بينهم أنه إذا تحقق هذا النبأ ووقع بأي شكل من الأشكال فلا وسيلة عندهم لمقاومته إلا تأليف العصابات المسلحة من البدو وغيرهم لمقاومة هذا الاعتداء على بلادهم بكل ما يمكن من وسائل المقاومة المعهودة عند الشعوب الأخرى في أوروبة بإغراء دولها الكبرى وإرشادها. وأنه خير لليهود إذا كانوا يريدون أن يكثروا في البلاد العربية ( فلسطين وغيرها ) ويكونوا فيها أحرارا آمنين متمتعين بما يتمتع به سائر أهلها من الحقوق المدنية والشخصية أن يتفقوا مع زعماء العرب أنفسهم على ذلك من وسائل ومقاصد وأرى أن ذلك ممكن.. ولما فصّلت له هذا الرأي أعجبه وبلّغه لجمعيتهم وظهر له أثر في مؤتمر (بال) الصهيوني إذ صرّح بعض أعضائه بالخطر الوحيد الذي يستقبلهم من قبائل العرب البدوية...
ثم ذاكرت في هذا الموضوع زعيم الصهيونية الكبير الدكتور ( وايزمن) بعد الحرب العالمية والشروع في تنفيذ عهد بلفور في أثر مذكرات أخرى مع بعض رجال الجمعية في مصر والقدس وقف هو على تفاصيلها كلها. وكان يريد المجيء إلى مصر قبل الحرب للبحث معي فيه. ومما قاله لي أن رأي في اتفاق العرب مع أبناء عمهم العبرانيين ممكن غير خيالي بشرط أن يرضى أمراء العرب وحكامهم المستقلون. ثم انقطعت المذاكرة في هذه المسألة لاعتماد الصهيونيين على قوة الإنكليز في إعادة ملك إسرائيل لهم وكل منهما يمكر بالآخر(34).
لقد كان الخطر الصهيوني على البلاد العربية واضحا في فكر رشيد رضا خاصة فيما إذا جر الصهاينة على النهج الذي حذر منه السيد الإمام، من دس السم في الدسم والصبر الطويل مع إخفاء القصد البعيد، فلقد كان مدركا لأبعاد الحبائل الاقتصادية التي يخطط لها اليهود الصهاينة" لأجل ابتياع الأرض بالتدريج وجعل الهجرة إليها بالسير البطيء، ولكنهم استعجلوا، وقد يكون من المستعجل الزلل، واغتروا باستخدام القوة الإنكليزية وضمها إلى قوتهم وقد يحبط الغرور العمل ناهيك بغرور الماديين منهم بالمال، وغرور المتدينين منهم ببشارات الأنبياء وغرور السياسيين منهم بما أوتوا من المكر والدهاء (35).
ثم يعود ويشير إلى تأييد الدولة البريطانية المتآمرة على فلسطين والعاملة على سلخ هذا الكيان من جسم الأمة العربية ويوضح ذلك بقوله:" ثم ناهيك بتأييد الدولة البريطانية لهذه القوى كلها بقوتها العظمى قوة التصرف في الأمم والنفوذ في الدول إذا أعطتهم بها وطنا من أوطان الأمة العربية التي تعدها من ميراثها، وعند هذه الأمة من بشارة نبيها في الظهور على اليهود ما هو أصرح من بشارات أنبياء اليهود المبهمة (36).
كان رشيد رضا يدرك عمق وأبعاد المشروع الصهيوني وأهدافه الاستعمارية والاستيطانية في أرض فلسطين ومنها إلى سائر البلاد العربية، ولعل ذلك يتجلى من خلال المواقف القوية والحازمة التي وقفها من القضية الفلسطينية دفاعا عن الأرض والشعب والدين، وكذلك من خلال الفتوى التي نشرها في المنار حول بيع الأراضي الفلسطينية إلى اليهود، وحكم مساعدة اليهود على امتلاك فلسطين، فهو يقول في هذه الفتوى:" أما بعد فإن حكم الإسلام في عمل الإنكليز واليهود الصهيونيين في فلسطين حكم قوم من أهل الحرب أغاروا على وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه بالقوة واستبدوا بأمر الملك فيه، وشرعوا في انتزاع رقبة أرضه من أهله بتدابير منظمة ليسلبوهم المِلك (بكسر الميم )كما سلبوهم المُلك (بضم الميم) وحكم من يساعدهم على عملهم هذا (امتلاك الأرض) بأي نوع من أنواع المساعدة وأية صورة من صورها الرسمية (كالبيع) وغير الرسمية (كالترغيب) حكم الخائن لأمته وملته، العدو لله ولرسوله وللمؤمنين...
هذا وأن فقد فلسطين خطر على بلاد أمتنا المجاورة لهذا الوطن منها، فقد صار من المعلوم بالضرورة لأهل فلسطين والمجاورين لهم، ولكل العارفين بما يجري فيها. من عزم اليهود على تأسيس الوطن القومي الإسرائيلي، واستعادة ملك سليمان بقوة المال الذي هم أقطاب دولته الاقتصادية، وبقوة الدولة البريطانية الحربية، إن هذا الخطر سيسري إلى شرق الأردن وسورية والحجاز والعراق، بل هو خطر سينتقل من سيناء إلى مصر.
وجملة القول إن الصهيونية البريطانية خطر على الأمة العربية في جميع أوطانها الأسيوية وفي دينها ودنياها. فلا يعقل أن يساعدهم عليه عربي غير خائن لقومه ووطنه، ولا مسلم يؤمن بالله تعالى وبكتابه العزيز وبرسوله محمد خاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه، بل يجب على كل مسلم أن يبذل كل ما يستطيع من جهد في مقاومة هذا الفتح، ووجوبه آكد على الأقرب فالأقرب، وأهون أسباب المقاومة وطرقها المقاومة السلبية، وأسهلها الامتناع عن بيع أرض الوطن لليهود، فإنه دون كل ما يجب من الجهاد بالمال والنفس الذي يبذلونه هم في سلب بلادنا وملكنا منا.
ومن المقرر في الشرع أنهم إن أخذوها وجب على المسلمين في جملتهم بذل أموالهم وأنفسهم في سبيل استعادتها، فهل يعقل أن يبيح لنا هذا الشرع تمهيد السبيل لامتلاكهم إياها بأخذ شيء من المال منهم وهو معلوم باليقين، لأجل أن يوجب علينا بذل أضعاف هذا المال مع الأنفس لأجل إعادتها لنا وهو مشكوك فيه، لأنه يتوقف على وحدة الأمة العربية وتجديد قوتها بالطرق العصرية، وأنى يكون ذلك لها وقلب بلادها وشرايين دم الحياة في قبضة غيرها؟ فالذي يبيع أرضه لليهود في فلسطين أو في شرق الأردن يعد جانيا على الأمة العربية كلها لا على فلسطين وحدها. ولا عذر لأحد بالفقر والحاجة إلى المال للنفقة على العيال، فإذا كان الشرع يبيح السؤال المحرم عند الحاجة الشديدة، ويبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للاضطرار وقد يبيح الغصب والسرقة للرغيف الذي يسد الرمق ويقي الجائع من الموت بنية التعويض، فإن هذا الشرع لا يبيح لمسلم بيع بلاده وخيانة وطنه وملته لأجل النفقة على العيال، ولو وصل إلى درجة الاضطرار، إن فرضنا أن الاضطرار إلى القوت الذي يسد الرمق يصل إلى حيث لا يمكن إزالته إلا بالبيع لليهود وسائر أنواع الخيانة، فالاضطرار الذي يبيح أمثال ما ذكرنا من المحظورات أمر يعرض الشخص الذي أشرف على الموت من الجوع وهو يزول برغيف واحد مثلا وله طرق ووسائل كثيرة.
وإنني أعتقد أن الذين باعوا أرضهم لهم لم يكونوا يعلمون أن بيعها خيانة لله ولرسوله ولدينه وللأمة كلها. كخيانة الحرب مع الأعداء لتمليكهم دار الإسلام وإذلال أهلها. وهذا أشد أنواعها (37).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}
وتحت عنوان إنذار واستتابة، " ويل للعرب من شر قد اقترب" أطلق رشيد رضا صيحة مدوية لإيقاظ النائمين من العرب، الغافلين عن الخطر، اللاهون عن الخطب المنتظر، الذين لا يدرون ما يجنون على أنفسهم ووطنهم وعلى قومهم، وأمتهم، ببيعهم أرضهم في فلسطين لليهود فيقول:" كل ما كتبه المقدرون لخطر اليهود فيما يسمونه المسألة الصهيونية قليل، وكل ما كتبه المصغرون لخطبها ضعيف، فالخطر أكبر والخطب أعظم، وسوط انتقام الله تعالى من البشر مصبوب على أهل فلسطين أولا وعلى الأقرب فالأقرب إليهم من العرب ثانيا، ثم الذين يلونهم من العرب، ثم الذين يلونهم منهم من غيرهم، ثم يكون البلاء الأكبر على اليهود أخيرا { والسماء ذات الرجع* والأرض ذات الصدع* إنه لقول فصل * وما هو بالهزل} ذلك بأن الأقدار الإلهية تقذف الظالمين جلمودا بجلمود، ولا جلمود في الشعوب أشد وأقوى من اليهود فهم سوط الله ينتقم بهم، ثم ينتقم منهم، كذلك كان الأمر من أول تاريخهم وهكذا يكون، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين (38).
وإذا كان اليهود يفوقون العرب في القوة المعنوية وهي العلم والوحدة والنجدة والتعاون والتناصر. فإنه لا مناص للعرب إلا بقوة الدين لمقاومة اليهود وأطماعهم في أرض فلسطين، وإنما أرض فلسطين والأردن والشام والعراق وجزيرة العرب كلها للعرب والأيدي العاملة فيها أيدي العرب... إن جل قوة الدين في الأخلاق والأخوة والتكافل والتعاون والتناصر والجهاد بالأموال والأنفس، وإذا أردنا أن نغلبهم بقوتنا المادية وهي كثرتنا وملكنا لرقبة الأرض فيجب علينا أن نجمع كلمة الأمة العربية ونوحد قواها لتكون يدا واحدة وقلبا واحدا في الزود عن حقها وحفظ أرضها لها. إنهم يأخذون أرضنا الآن ببيع الخائنين منا وسمسرتهم وإن ما يأخذه خونتنا منهم من مال قليل سيعود إليهم بفسق هؤلاء الخونة وجهلهم وسينتهي هذا التنازع إلى القتال وهم يستعدون له ونحن لا نستعد. وقد تنبأ نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا ووعدنا بالظهور والنصر عليهم فقال:" تقاتلكم اليهود فتظهرون عليهم حتى يقول الشجر والحجر: ها هنا ورائي يهودي تعال يا مسلم فاقتله" رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من عدة طرق. ولكن هذا الوعد لا يظهر إلا فيمن يكون وطنهم بأهله وشجره وحجره متفقا على هذا الدفاع فما ذكر الرسول الشجر والحجر فيه إلا من باب التمثيل فمتى تكون كذلك (39)؟.
أما في موضوع لصهيوني على البلاد العربية، وإدراكاً منه بفداحة الخطر اليهودي الصهيوني على مستقبل فلسطين، فإنه يناشد زعماء العرب فيقول: " يجب على زعماء العرب، أهل البلاد أحد أمرين. إما عقد اتفاق مع زعماء الصهيونيين على الجمع بين مصلحة الفريقين في البلاد إن أمكن، وهو ممكن قريب إذا دخلوا عليه من بابه، وطلبوه بأسبابه، وإما جمع قواهم كلها لمقاومة الصهيونيين بكل طرق المقاومة، وأولها تأليف الجمعيات والشركات وآخرها تأليف العصابات المسلحة التي تقاومهم بالقوة، وهو ما تحدث به بعضهم على أن يكون أول ما يعمل، وإنما الكي، والكي آخر العلاج (40).
وهكذا بقي رشيد رضا حريصاً على وحدة العرب، مسلمين ومسيحيين. من هنا كان تشديده على وجوب اتفاق السوريين من مسلمين ونصارى، خاصةً بعد إعلان الأمير فيصل حكومته العربية في دمشق. ولهذا الغرض، كتب عدة مقالات، دعا فيها إلى الاتفاق، مشدداً على ضرورة التربية والتعليم، عن طريق إنشاء مدارس وطنية، جاعلاً في جانب منها مسجداً، وفي جانب آخر كنيسة، وذلك لتربية الجيل الناشئ تربية دينية وطنية، لأنه على الديانتين الإسلامية والمسيحية فضائل كافية، وهي متفقة أو متقاربة على قاعدة المنار الذهبية" نتعاون ونشترك فيه ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه (41)
الحاشية
(1) أنيس الأبيض: رشيد رضا، تاريخ وسيرة . جروس برس ، الطبعة الأولى 1993 ، ص 12
(2) رشيد رضا : المنار والأزهر ، ص 133 .
(3) أنيس الأبيض : المرجع السابق ، ص 12 .
(4) رشيد رضا : المصدر السابق ، ص 141 .
(5) رشيد رضا : المصدر نفسه ، ص 191 .
(6) رشيد رضا : المنار . ج4 ، م 16 ، ص 315 – 316 .
(7) رشيد رضا : المنار . ج2 ، م 17 ، ص 957 – 959 ، 1913م
(8) رشيد رضا : المنار . ج7 ، م17 ، ص 536 .
(9) رشيد رضا : المنار ، ج1 ، م.20 ، 1917 ، ص 34 .
(10) رشيد رضا : المنار ، ج12 ، م12 ، ص 921 .
(11) أنيس الأبيض : المرجع السابق ، ص 56 .
(12) رشيد رضا : المنار ، ج8 ، م17 ، ص 617 .
(13) رشيد رضا : المصدر نفسه ، ص 627 .
(14) حسان حلاق: دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش 1908 – 1909 الدار الجامعية للطباعة والنشر ص 49 السنة 1982 .
(15) حسان حلاق: المرجع نفسه ص 50
(16) رشيد رضا: المنار ج 2 م 1 ص 54 – 1315 – 1316 / 1898 .
(17) رشيد رضا: المنار ج 6 م 1 ص 108
(18) رشيد رضا: المنار ج 21 م 4 ص 801 -803 سنة 1902 .
(19) رشيد رضا: المنار ج 2 م 14 ص 159 سنة 1911 .
(20) رشيد رضا: المنار ج 10 م 13 ص 725 – 726 سنة 1926 .
(21) رشيد رضا: المنار ج 9 م 14 ص 713 – 714 سنة 1911 .
(22) رشيد رضا: المصدر نفسه ص 716 .
(23) رشيد رضا: المصدر نفسه ص 716 .
(24) رشيد رضا: المصدر نفسه ص 716 .
(25) رشيد رضا: المصدر نفسه ص 716 .
(26) رشيد رضا: المنار ج 4 م 17 ص 319 – 320 سنة 1914
(27) رشيد رضا: المنار ج 1 م 17 ص 9 سنة 1913 .
(28) رشيد رضا: المنار ج 9 م 17 ص 707 – 708 سنة 1914 .
(29) زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان دار النهار للنشر- الطبعة الثالثة - بيروت 1977 . ص 74 .
(30) رشيد رضا: المنار ج 5 م 30 ص 385 – 393 سنة 1929 .
(31) رشيد رضا: المنار ج 7 م 30 ص 555 سنة 1929 .
(32) رشيد رضا: المنار ج 7 م 30 ص 555 سنة 1929 .
(33) رشيد رضا: المصدر نفسه ص 555
(34) رشيد رضا: المنار ج 5 م 30 ص 391 – 392
(35) رشيد رضا: المصدر نفسه ص 393 .
(36) رشيد رضا: المصدر نفسه ص 393 .
(37) رشيد رضا: المنار ج 4 م 33 ص 273 – 274 سنة 1933 .
(38) رشيد رضا: المنار ج 8 م 34 ص 601 سنة 1935 .
(39) رشيد رضا: المصدر نفسه ص 605 – 606 .
(40) رشيد رضا : المنار ، ج4 ، م 17 ، 1914 ، ص 320
(41) رشيد رضا : المنار ، ج8 ، م22 ، ص 617 – 619 .
مراجع البحث
رشيد رضا: المنار والأزهر مطبعة المنار 1353 هجرية .
أعداد مجلة المنار
المجلد 1 السنة 1898
المجلد 4 السنة 1902
المجلد 12 السنة 1909
المجلد 13 السنة 1910
المجلد 14 السنة 1911
المجلد 16 السنة 1913
المجلد 17 السنة 1913 – 1914
المجلد 20 السنة 1917
المجلد 22 السنة 1920
المجلد 30 السنة 1929
المجلد33 السنة 1933
المجلد 34 السنة 1934
أنيس الأبيض: رشيد رضا، تاريخ وسيرة . جروس برس ، الطبعة الأولى 1993
حسان حلاق: دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش 1908 – 1909 الدار الجامعية للطباعة والنشر ص 49 السنة 1982 .
زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان دار النهار للنشر- الطبعة الثالثة - بيروت 1977 .
مناقشات الجلسة الرابعة
- مداخلة الدكتور فاروق حبلص : توضيح بالنسبة للأستاذ مارون عيسى الخوري المحاضر في البحث الأول من هذه الجلسة ، فيما يتعلق بتناقص عدد المسلمين في بداية القرن السادس عشر مرحلة الحكم العثماني ، الأمر يعود الى أخذهم الى الجندية للمشاركة في حصار فيينا في ذلك التاريخ .
أما بالنسبة لليهود فالدفاتر العثمانية المهمة توضح تماما الامر وتقول أنه حتى سنة 1546 يوجد حوالي الف عائلة يهودية نزحت من بلاد الشام الى صفد تهربا من دفع الجزية لانها لم تسجل أسماءها هناك .
بالنسبة الى رئيس الجلسة الدكتور فريدريك معتوق ، أود ان أوضح قضية ولا شك انك على علم بها انما يبدو انك نسيت هذا الامر أو تتناساه ، أنتم لم تكونوا أول من اشتغل في السجلات للمحكمة الشرعية في طرابلس ، مشروعكم صدر في عام 1982 ، هناك رسائل ماجستير ، واعرف على الأقل ثلاث رسائل منهم كانوا معتمدين على المحكمة الشرعية مئة في المئة ، ورسالتي للدكتوراه واحدة من هذه الرسائل ، ورسالة الدكتور أنيس الأبيض أحد هذه الرسائل ورسالة الدكتور قاسم الصمد واحد منهم أيضا ، وأنت تعلم عندما نشر السجل الاول كم أخذ من ردود على مقدمته مني ومن الدكتور انيس الأبيض ، ويبدو ان الذاكرة قد خانتك ايضا فنسيت فضل جهود رابطة إحياء التراث والحاج فضل مقدم رحمه الله وشكرا ( وهنا لابد من ذكر جهود العديد من أعضاء الرابطة الذين اهتموا وساهموا في حفظ تراث المدينة ومن بينهم الأستاذ مارون عيسى الخوري و الدكتورة راوية مجذوب والدكتور بسام بركة و الدكتورة منى حداد يكن ...) .
- مداخلة الأستاذ عبد اللطيف كريّم : كان هناك حديث عن الديمغرافيا وسكان المنطقة ونتج خلاف على أعدادهم ، ولكن خلال هذه الحلقات ككل لم نسمع أي أحد من المحاضرين تطرق الى الكوارث التي كانت تحل في المدن وبالتالي كانت تضرب السكان في معظم الأحيان ضربات مخيفة ، ففي عام 1811 ضرب زلزال الطاعون طرابلس بحيث ان الـ 14200 نسمة تدنى العدد الى 2500 فقط وكان عدد الأموات يناهز ويزيد في اليوم الواحد على 300 قتيل بحيث ان المسؤولين عن الدفن عاجزين تنظيم مراسيم الدفن للأموات فكانوا يجمعونهم ويضعونهم في مقابر جماعية ، وكان الطاعون يضرب بمعدل كل عشر سنوات مرة وكان أمرا خطيرا ، يضاف إليها الجراد الذي كان من النكبات الهائلة والزلازل ، ومنها الزلزال الذي ضرب طرابلس سنة 1857 ضربا رهيبا دمر بعض عواميد قلعة بعلبك ودمر المنارة "مئذنة الجامع الأموي " ودمر الجرس في دير صدنايا ، كل ذلك أثر على تركيبة السكان في أوقات مختلفة ، بالإضافة التي قالها أحدهم عن الجندية العثماني التي كان إليها مفقود والعائد منها مولود وشكرا .